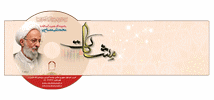المرحلة الثانية عشر
394 ـ قوله «وهي في الحقيقة مسائل...»
إلى هنا انتهى البحث عن الاُمور العامّة التي تشكّل موضوعاتٍ لمسائل الفلسفة الاُولى بمعناها الخاصّ، ولقسم منها بمعناها العامّ الشامل للإلهيّات. وقد مرّت الإشارة إلى اختلاف الحكماء في اندراج العلم الإلهيّ ومعرفة الربوبيّة في الفلسفة الاُولى، فراجع الرقم (4).
وقد حاول سيّدنا الاُستاذ(قدسسره) توجيه اندراج مسائل هذا العلم في الفلسفة الاُولى بأنّها في الحقيقة تتعلّق بمبحث الوجوب والإمكان الذي مرّ ذكره في المرحلة الرابعة من هذا الكتاب. وإنّما أفردوا هذه المسائل المتعلّقة بالواجب تبارك وتعالى لشرافة موضوعها. ويمكن مثل هذا التوجيه لاندراج هذه المسائل في مبحث العلّة والمعلول، بالنظر إلى كون الواجب تعالى هو العلّة الاُولى، وله أتمّ معاني العلّية وأكمل مراتبها.
وظاهر صدر المتألّهين في الأسفار أنّه اعتبر العلم الإلهيّ علماً مستقلّاً عن الفلسفة الاُولى وعلم ما بعد الطبيعة، حيث قال في مقدّمة السفر الثالث: «فهذا شروع في طور آخَر من الحكمة والمعرفة، وهو تجريد النظر إلى ذوات الموجودات وتحقيق وجود المفارقات والإلهيّات، والمسمَّى بمعرفة الربوبيّة والحكمة الإلهيّة ـ إلى أن قال ـ وهو مشتمل على علمين شريفين: أحدهما العلم بالمبدء، وثانيهما العلم بالمعاد».(1)
1. راجع: الأسفار: ج6، ص3 و 8.
وهناك مناهج اُخرى لتقسيم المباحث العقليّة وترتيبها. من أشهرها تقديم المباحث المنطقيّة، وإتباعها بالطبيعيّات، وختمها بالاُمور العامّة والإلهيّات. ومنها ما صنعه بهمنيار في التحصيل مقتدياً في الترتيب بالحكمة العلائيّة لاُستاذه، حيث قسّمه إلى ثلاثة كتب: الكتاب الأوّل في المنطق، والكتاب الثاني في الاُمور العامّة أو علم ما بعد الطبيعة، والكتاب الثالث في العلم بأعيان الموجودات، وجعَله مشتملاً على مقالتين: إحداهما في البحث عن الواجب تعالى، واُخراهما في البحث عن أبواب الطبيعيّات، وجعَل الباب الأخير منها في البحث عن أحوال النفس ومعادها.
وسلك الشيخ في الإشارات مسلكاً بديعاً، فجعَل هذا الكتاب على قسمين: قسم في المنطق، وقسم في الحكمة، وجعَل قسم الحكمة على عشرة أنماط: النمط الأوّل في تجوهر الجسم، الثاني في الجهات، الثالث في النفس الأرضيّة والسماويّة، الرابع في الوجود وعلله بما يشتمل على البحث عن الواجب تعالى ووحدته، الخامس في الصنع والإبداع، السادس في الغايات ومباديها، السابع في التجريد، الثامن في البهجة والسعادة، التاسع في مقامات العارفين، والعاشر في أسرار الآيات وخوارق العادات.
والحاصل أن كيفيّة تقسيم المباحث العقليّة وترتيبها ليست أمراً متّفَقاً عليه بين الفلاسفة، ولا ملتزَماً به في كتب فيلسوف واحد، وقد مرّ ما يتعلّق بذلك تحت الرقم (8 و 25).
الفصل الأوّل
395 ـ قوله «البراهين الدالّة على وجوده...»
قال الشيخ: «الحقّ ما وجوده له من ذاته. فلذلك، البارئ هو الحقّ، وما سواه باطل.
كما أنّ واجب الوجود لا برهان عليه، ولا يعرف إلاّ من ذاته. فهو كما قال: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ».(1)
ويمكن تفسير هذا الكلام بأنّ مراده هو نفي برهان اللمّ، ويستشهد بكلامه في الشفاء حيث قال: «ولا برهان عليه لأنّه لا علّة له»(2) ويجمع بين قوله هذا وما أقام من البراهين في كتبه المختلفة على وجود الواجب تبارك وتعالى كغيره من الفلاسفة بأنّها ترجع إلى براهين إنّية.(3)
لكن لهذا الكلام تأويل آخر أشدُّ مناسبةً لذيل كلامه، أعني قوله: «ولا يعرف إلاّ من ذاته» وإن كان بعيداً عن مساق كلمات المشّائين وأتباعهم. وهو أنّ غاية ما تفيده البراهين أنّ في دار الوجود موجوداً مّا يمتنع عدمه فيقال إنّه واجب الوجود، وهكذا يوصف بالحياة والعلم والقدرة من الصفات الذاتيّة، كما أنّه يتّصف بالعلّية والخالقيّة والربوبيّة وغيرها من الصفات الفعليّة والإضافيّة. وموضوع جميع هذه الأوصاف هو ما يطلق عليه «شيء» أو «موجود» ونحوها من المفاهيم العامّة، وأمّا حقيقته فغائبة عن إدراكنا ومعرفتنا، كما أنّ صفاته التي ننسبها إليه إنّما نعرفها بمصاديقها المحدودة في أنفسنا ثمّ نجرّد المفاهيم عن الحدود العدميّة تجريداً ذهنيّاً فننسبها إليه سبحانه. فلا حقيقةُ ذاته معروفةٌ لنا، ولا كُنْهُ صفاته معلوم لعقولنا. وهذا هو معنى ما يقال من عدم قدرة العقل على معرفة كنه ذاته وصفاته، وقد يستدلّ عليه بأنّ العقل إنّما يمكنه اكتناه المهيّات، وحيث إنّه تعالى لا مهيّة له ـ كما مرّ البحث عنه تحت الرقم (62) وسيأتي الكلام فيه أيضاً ـ فلا يستطيع العقل اكتناه ذاته سبحانه.(4)
1. راجع: التعليقات: ص70؛ و سورة آل عمران، الآية 18.
2. راجع: الفصل الرابع من المقالة الثامنة من إلهيّات الشفاء.
3. راجع: تعليقة الأستاذ1 على الأسفار: ج6، ص29.
4. راجع: المبدء والمعاد: ص3340.
لكنّ العبارة القائلة «لا يُعرف إلاّ من ذاته» توحي بإمكان معرفته من طريق آخر، كما وردت عن أئمّة أهل البيت(علیهمالسلام) روايات مستفيضة تدلّ على أنّه تعالى لا يُعرف إلاّ به، وإنّما خَلْقُه يُعرف به لا بالعكس.(1) وعن الإمام الصادق(علیهالسلام) أنّه قال: «ومن زعم أنّه يعبد بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب ـ إلى أن قال ـ إنّ معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه».(2) وعن الإمام الباقر(علیهالسلام): «كلُّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم».(3) وقد تكرّر هذا المضمون في أدعيتهم ومناجاتهم كقول سيّد الشهداء(علیهالسلام) في دعاء عرفة «ألِغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟!» وقول الإمام السجّاد(علیهالسلام) في مناجاته التي رواها أبو حمزة الثماليّ: «بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولو لا أنت لم أدرِ ما أنت».
والتفسير الفلسفيّ لهذه المعرفة هو أنّه علم حضوريّ للمعلول بالنسبة إلى علّته المفيضة، وله مراتب أدناها ما هو حاصل لكلّ إنسان حصولاً غير مشعور به في هذه النشأة للجميع، ولعلّه هو ما أشار إليه عزّ اسمه بقوله: «ألست بربّكم قالوا بلى»(4) خاصّةً بالنظر إلى ما ورد في تفسيره عن أئمّة أهل البيت(علیهمالسلام) أنّ هذا الجواب كان عن رؤية ومُعايَنة.(5) وهو أحد معاني فطريّة معرفته سبحانه.
ولهذا العلم مراتب كاملة تحصل بتكامل النفس وتعاليها عن المادّيات واقترابها من الحضرة الإلهيّة إلى أن تصل إلى «مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ»(6) وتخاطَب
1. راجع: الكافي: ج1، «باب أنّه تعالى لا يعرف إلاّ به».
2. راجع: تحف العقول: كلامه (علیهالسلام) في وصف المحبّة لأهل البيت(علیهمالسلام).
3. راجع: المحجّة البيضاء: ج1، ص219.
4. سورة الأعراف، الآيه 172.
5. راجع: الكافي: ج2، ص13؛ وراجع: الميزان في التفسير القرآن: ج8، ص340 و 345.
6. سورة القمر، الآية 55.
بقوله عزّ من قائل: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّکِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي».(1) وأكمل مراتبه ما يفوز به الأنبياء الكاملون، والأولياء المقرّبون، والشهداء والصدّيقون. فطوبىٰ لهم، ثمّ طوبىٰ لهم.
ولْيُعلمْ أنّ تلك المعرفة السامية مع شموخ مقامها وعلوّ درجتها لا تعني اكتناهَ ذاته المقدّسة، فإنّه خاصّ به سبحانه قد استأثره لنفسه «ولا يحيطون به علماً»(2) وإنّما لكلٍّ منهم ما تَسَعه مرتبة وجوده الخاصّ، وتتجلّى له الذات الإلهيّة بقدر ما تستعدّ له مرآته الصافية.(3)
وهذه المعرفة الحضوريّة إنّما يستطيع إثباتَها مَن لا يحصر العلمَ الحضوريَّ في عِلم الشيء بنفسه، وأمّا المشّاؤون وأتباعهم فلا سبيل لهم إلى إثباتها، ولهذا أشرنا إلى أنّ هذا التفسير بعيد عن مساق كلماتهم، وغير موافق لمبانيهم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه.
396 ـ قوله «وأمتنها هو البرهان...»
المعرفة الحصوليّة العقليّة بالواجب تبارك وتعالى إمّا أن تحصل بانعكاس العلم الحضوريّ في الذهن كقضيّة بديهيّة متشكلّة من مفاهيم عامّة، وهي رهن لاشتداد العلم الحضوريّ بحيث تستطيع النفس الالتفاتَ إليه، وهي المعرفة الفطريّة بمعنى آخر؛ وإمّا أن تحصل من طريق البرهنة والاستدلال، وهي التي تتيسّر لكلّ عاقل، وتُطلب بالأبحاث الفلسفيّة.
والبراهين التي تفيد هذا العلم الاكتسابيَّ كثيرة، وأمتنها ما يتشكّل من مقدّمات
1. سورة الفجر، الآية 27ـ30.
2. سورة طه، الآية 110.
3. راجع: الأسفار: ج1، ص113ـ119.
عقليّة محضة ولا تحتاج إلى مقدّمات حسّية وتجريبيّة ونحوها، كالبرهان الذي أقامه الشيخ في الإشارات، وحاصله أنّ الموجود إمّا أن يكون واجباً فهو المطلوب، وإمّا أن يكون ممكناً فيحتاج إلي علّة ترجّح وجوده، والعلّة إما هو الواجب فيثبت المطلوب إمّا أن يكون ممكناً آخر، فلابدّ من انتهاء سلسلة العلل إلى الواجب دفعاً للدور والتسلسل. ثمّ قال: «تأمَّلْ كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأوّل ووحدانيّته وبراءته عن الصمات إلى تأمُّلٍ لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه، وإن كان ذلك دليلاً عليه، لكن هذا الباب أوثق وأشرف، أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود. وإلى مثل هذا اُشير في الكتاب الإلهيّ: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»(1) أقول: هذا حكم لقوم. ثمّ يقول: «أَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»(2) أقول: هذا حكم للصدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه».
و قال المحقّق الطوسىّ في شرحه: «المتكلّمون يستدلّون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الخالق، وبالنظر إلى أحوال الخليقة على صفاته واحدةً فواحدة. والحكماء الطبيعيّون أيضاً يستدلّون بوجود الحركة على محرّك، وبامتناع اتّصال المحرّكات لا إلى نهاية على وجود محرّك أوّل غير متحرّك، ثم يستدلّون من ذلك على وجود مبدء أوّل. وأمّا الإلهيّون فيستدلّون بالنظر في الوجود وأنّه واجب أو ممكن على إثبات واجب، ثمّ بالنظر في ما يلزم الوجوب والإمكان على صفاته، ثمّ يستدلّون بصفاته على كيفيّة صدور أفعاله عنه واحداً بعد واحد.
فذكر الشيخ في ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الاُولى أنـّه أوثق وأشرف، وذلك لأنّ أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلّة على المعلول، وأمّا
1. سورة فصّلت، الآية 53.
2. سورة فصّلت، الآية 53.
عكسه الذي هو الاستدلال بالمعلول على العلّة فربما لا يعطي اليقين، وهو إذا كانت للمطلوب علّة لا يعرف إلاّ بها كما تبيّن في علم البرهان.
ثمّ جعل المرتبتين المذكورتين في قوله تعالى « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» أعني مرتبة الاستدلال بآيات الآفاق والأنفس على وجود الحقّ، ومرتبة الاستشهاد بالحقّ على كلّ شيء بإزاء الطريقتين. ولمّا كانت طريقة قومه أصدق الوجهين وَسَمهم بالصدّيقين، فإنّ الصدّيق هو ملازم الصدق».(1)
ثمّ إنّ صدر المتألّهين بعد ذكر هذا البرهان قال: «وهذا المسلك أقرب المسالك إلى منهج الصدّيقين، وليس بذلك كما زُعم، لأنّ هناك (يعني في منهج الصدّيقين على ما بيّنه وسيأتي ذكره في المتن) يكون النظر إلى حقيقة الوجود، وههنا يكون النظر في مفهوم الوجود ـ إلى أن قال ـ فهذا ما وصفه الشيخ في الإشارات بأنـّه طريقة الصدّيقين وتبعه المتأخّرون فيه» ثمّ تعرّض لبعض ما اُورد فيه من الشبهات وما قيل في دفعها، وقال في آخر كلامه «والحقّ كما سبق أنّ الواجب لا برهان عليه بالذات بل بالعرض، وهناك برهان شبيه باللّمّيّ».(2)
وتثور حول هذه الكلمات تساؤلات كما يلي:
ألف) هل هذا البرهان إنّيّ أو لمّيّ؟
ب) ما هي الميزه الأساسيّة الفارقة بين البرهان المنسوب إلى الإلهيّين وسائر البراهين؟ وهل ترجع تلك الميزة إلى الفرق بين اللّمّيّ والإنّيّ؟
ج) ما هو المراد بقولهم «لا برهان على الواجب بالذات بل بالعرض»؟
د) هل في الآية الكريمة إشارة إلى الطريقتين أو إلى طريقة ثالثة؟
1. راجع: آخر النمط الرابع من شرح الإشارات.
2. راجع: الأسفار: ج6، ص26ـ29.
ه) هل للصدّيقين منهج خاصّ لمعرفة الله سبحانه؟ وهل ينطبق ذلك على شيء من تلك البراهين؟
أمّا السؤال الأوّل فالجواب عنه أنّه يصحّ اعتبار هذا البرهان لميّاً بناءاً على تعميم العلّية المعتبرة في البرهان اللميّ للعلاقة الملحوظة بين المفاهيم الفلسفيّة واعتبار الإمكان مثلاً علّةً لحاجة الممكن إلى العلّة،(1) كما مرّ بيانه تحت الرقم (8) وإلاّ فهو برهان إنّي يسلك فيه من أحد اللوازم العقليّة إلى آخر، كما هو رأي سيّدنا الاُستاذ(قدسسره) في جميع البراهين المذكورة في الأبحاث الفلسفيّة.
وأمّا السؤال الثاني فالجواب عنه أنّ الميزة التي نؤكّد عليها هي ما أشرنا إليه من تركّب هذا البرهان من مقدّمات عقليّة محضة بخلاف البراهين المنسوبة إلى المتكلّمين والطبيعيّين. مضافاً إلى قلّة مقدّماته بالنسبة إليها، فإنّ تلك البراهين تثبت أوّلاً وجود محرِّك غير متحرّك ومحدِث غير حادث، ثمّ تحتاج في إثبات وجوب ذلك المحرّك والمحدث إلى مثل ما اُخذ في هذا البرهان من المقدّمات.
ويمكن اعتبار ميزة ثالثة للبرهان الإلهيّ هي أنّه لا يتوقّف على قبول وجود الممكن في الخارج فضلاً عن معرفة صفاته وأحواله، بل يكفي فيه الترديد بين كون الموجود الذي لا شكَّ في وجوده واجباً أو ممكناً، بخلاف سائر البراهين التي تحتاج إلى معرفة صفات المخلوقات من الحدوث والإمكان وغيرهما بعد قبول وجودها في الخارج. ولعلّه إلى هذا أشار الشيخ حيث قال: «ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه».
لكن يمكن من جهة اُخرى إثبات ميزة لتلك البراهين بإزاء هذه الميزة، هي كفايتها لإثبات كون الواجب غير العالَم، بخلاف هذا البرهان الذي إنّما يثبت موجوداً واجباً بالذات، ثمّ يحتاج في إثبات كونه غير العالَم إلى بيان صفات الواجب بالذات وعدم انطباقها على صفات العالَم.
1. راجع: النهج التاسع من منطق شرح الإشارات؛ والأسفار: ج6، ص28.
وربما يظهر من شرح المحقّق الطوسيّ أنّ وجه أشرفيّة البرهان الإلهيّ هو كونه استدلالاً من العلّة على المعلول. ويلاحظ عليه بعد تأويل العلّة إلى ما أشرنا إليه آنفاً أنّ برهان الحركة والحدوث ليسا من قبيل الاستدلال بالمعلول علي العلّة، بل هما من قبيل البرهان الإنّي المفيد لليقين، وليس للبرهان اللميّ فضل عليه، بل يمكن أن يقال بأنّ جميع البراهين اللمّية تنطوي على برهان إنّي يتضمّن قاعدة عدم انفكاك المعلول عن علّته التامّة ككبرى له، فتأمّل.
وأمّا السؤال الثالث فقد اُجيب عنه بوجوه(1) أحسنها أنّ جميع البراهين إنّما تُثبت أنّ هناك موجوداً يمتنع عدمه، فالذي يثبت بها أصالةً وبالذات هو هذا العنوان، وأمّا مصداقه العينيّ فإنّما يعلم بها بالعرض. وأمّا قول صدر المتألّهين أنّ هناك برهاناً شبيهاً باللميّ فقد فسّره الاستاذ(قدسسره) بأنّ البرهان الإنّي المطلق الذي يسلك فيه من أحد اللوازم إلى آخَر شبيهٌ بالبرهان اللميّ في كونه مفيداً لليقين، وقد فسّره غيره بغيره.(2) ويحتمل أن يكون مراده أنّ برهان الصدّيقين حسب ما ذكر له من التقرير يفضل على سائر البراهين بأنـّه شبيه بالبرهان اللميّ،(3) فليتأمّل.
وأمّا السؤال الرابع فالجواب عنه أنّ الآية الكريمة بصرف النظر عن ما قيل أو يمكن أن يقال في تفسيرها من الوجوه لا تدلّ على طريقتين للاستدلال، وإذا كانت لذيلها إشارة إلى نوع آخَرَ من معرفته سبحانه فلتكن هي المعرفة الشهوديّة، خاصّةً بالنظر إلى تفسير لفظة «شهيد» في الآية ب «مشهود».
وأمّا السؤال الخامس فالجواب عنه أنّا لم نظفر بدليل على أنّ للصدّيقين منهجاً خاصّاً لمعرفة الله تعالى، وإنّما نَسب الشيخ برهانَ الإلهيّين إليهم لما كان يرى أنّه
1. راجع: نفس المصدر: ج6، ذيل الصفحة 29.
2. نفس المصدر.
3. راجع: تعليقة الاُستاذ(قدسسره) على الأسفار: ج6، ص13؛ وراجع: المبدء والمعاد: ص46.
أوثق وأشرف البراهين، ثمّ أقام صدر المتألّهين برهاناً آخر ورأى أنّه أشرف، فنسب برهانه إلى الصدّيقين. وإذا كانت ميزة معرفتهم أنّهم يعرفون الله به لا بغيره انطبقت تلك المعرفة على المعرفة الشهوديّة التي أشرنا إليها في التعليقة السابقة، وهي ليست ممّا يؤدّي إليه أيُّ برهان، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وأمّا الاستعداد للفوز بها فيحصل من الإخلاص في العبادة وتركيز توجّه القلب إلى ساحة قدسه سبحانه، والإعراض عمّا سواه «إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْكَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ».
397 ـ قوله «وأوجز ما قيل...»
لكن يجب تتميمه ببيان الاستلزام، فإن كان المتمّم هو ما تمسّك به الشيخ من استحالة الدور والتسلسل رجع إلى البرهان الذي نسبه إلى الإلهيّين والصدّيقين، وقد مرّ تقريره آنفاً، وسيأتي بيانه في المتن في الفصل التالي، وقد قرّره في شرح المنظومة(1) بوجهين آخرين: أحدهما على سبيل الخلف (بأخذ لفظة «إمّا» بمعنى الترديد في الفرض) بأن يقال: حقيقة الوجود الصِرفة واحدة لا تتثنّى، فإن كانت واجبة فهو المطلوب، وإن فُرضتْ ممكنةً لزم كونها متعلّقة بالغير، فيلزم أن يكون وراء هذه الحقيقة الصرفة حقيقة اُخرى تتعلّق هذه الحقيقة بها، مع أنّ الصِرف لا يتثنىّ. وثانيهما على سبيل الاستقامة (بأخذ لفظة «إمّا» بمعنى التقسيم) بأن يقال: الوجود حقيقة ذات مراتب، فإن انتهت المراتب إلى الواجب فهو المطلوب، وإلاّ لزم الدور أو التسلسل. ثمّ وصف الوجه الأوّل بأنـّه أوثق وأشرف وأخصر.
ويلاحظ على الوجه الأوّل أنّ ما ثبت بالأبحاث الفلسفيّة هو أصالة الوجود وكونه ذا مراتب، وأمّا أنّ هناك حقيقةً صرفةً لا تخالطها مهيّةٌ وليس لها حد
1. راجع: شرح المنظومة: الفريدة الأولى من الإلهيّات.
عدميٌّ وأنّها غير قابلة للتكرّر والتكثّر فليست ببيّنة ولا مبيَّنة في البرهان. وربما يقال في تبيين ذلك: إنّ الوجود إمّا أن يكون صِرفاً خالصاً من شوب عدم ومهيّة فهو المطلوب، وإمّا أن يُفرض مختلطاً بالعدم، محدوداً بحدود تنتزع عنها المهيّة فيلزم اختلاط الوجود بغير الوجود في حاقّ الأعيان، وهو باطل على القول بأصالة الوجود.
ويلاحظ عليه أن صرافة حقيقة الوجود بمعنى عدم شوبها في متن الواقع بالعدم لا ينفي كثرة المراتب، فإنّ كلّ مرتبة منه وإن كانت في غاية الضعف ليس في متن الواقع إلاّ وجوداً، وإنّما ينتزع الذهن منها مفاهيم عدميّة، ولا يعني ذلك تحقّق العدم في حاقّ الأعيان واختلاطه بحقيقة الوجود. وقد عرفت تصريح الاستاذ(قدسسره) في الفصل الثاني من المرحلة الاُولى بأنّ تكثّر الوجود أمر بديهيّ، وقد أخذه مقدّمة اُولى لإثبات التشكيك في حقيقة الوجود. وأمّا الصرافة بمعنى اللاتناهي المطلق وعدم المحدوديّة بحدود ماهويّة وكونه بحيث لا ينتزع الذهن مفاهيم عدميّة وما هويّة عنه فهو يختصّ بوجود الواجب تبارك وتعالى، وهو الذي يُطلب بهذا البرهان. والحاصل أنّ التقرير الخلفيّ لا يتمّ إلاّ على قول الصوفيّة،(1) ويؤول إلى المصادرة بالمطلوب.
وأمّا السبيل المستقيم فيمكن تقريره بوجه لا يتوقّف على سبق إبطال التسلسل، وهو أن يقال: الوجود حقيقة ذات مراتب، والمراتب النازلة هي مفتقرة الذات وعين التعلّق والفقر الوجوديّ بما وراءها، فتستلزم مرتبة مستقلّة على الإطلاق، وإلاّ عاد المفتقر غنيّاً، والرابط مستقلّاً. وهذا هو نفس البرهان الذي اُقيم على استحالة التسلسل في العلل الفاعليّة ـ على ما مرّ بيانه في الفصل الخامس من المرحلة الثامنة ـ لا أنّه مبتنٍ عليها، فتبصّر.
1. راجع: تمهيد القواعد: ص59.
398 ـ قوله «وفي معناه ما قرّر...»
هذا التقرير للمحقّق السبزواريّ في تعليقته على الأسفار،(1) وهو نظير السبيل الخلفيّ الذي نقلنا عنه آنفاً في تفسير التقرير السابق، بتبديل الصرافة بالإرسال، وقد فسّر الإرسال بالصرافة والبساطة في جواب الإشكال. وقد عرفت ما فيه من المناقشة. والحاصل أنّه إن اُريد بالحقيقة المرسلة التي هي أصيلة ولا أصيل غيرها انحصار الوجود الحقيقيّ في الواجب تعالى فهو قول الصوفيّة، ويرد عليه مضافاً إلى منافاته للكثرة الثابتة بالضرورة أنّه مصادرة بالمطلوب، فإنّ المطلوب بالبرهان إثبات وجود صرف غير قابل للعدم بوجه، وقد اُخذ ثابتاً مفروغاً عنه. وإن اُريد بها ما يعمّ الوجودات الإمكانيّة فالمناقض لكلّ واحد منها هو العدم الخاصّ لا مطلق العدم، ولا يثبت بمناقضة العدم للوجود وجود حقيقة واجبة غير متّصفة بأيّ مفهوم عدميّ يحكي عن محدوديّتها.
399 ـ قوله «وقرّر صدر المتألّهين...»
هذا التقرير يبتني على اُصول: أحدها أصالة الوجود، وثانيها كونه ذا مراتب، وثالثها كون المعلول مفتقر الذات إلى العلّة وعينَ الربط بها، وقد مرّ إثبات كلّ واحد منها في محلّه. فبالنظر إلى هذه الاُصول يقرّر البرهان على هذا النمط: الوجود الأصيل إن كان مستغنياً عن غيره فهو المطلوب، وإن كان غيرَ مستغنٍ بالذات كان معلولاً مفتقراً إلى ما هو مستغنٍ بالذات، لاستحالة تحقّق المفتقر المتعلّق الذي هو عين التعلّق والربط بلا مستقلّ غنيّ تامّ. وقد أشار في ضمن كلامه إلى قواعد حكميّة اُخرى لمزيد التوضيح والتأكيد.(2)
1. راجع: الأسفار: ج3، ذيل الصفحة 16 و 17.
2. راجع: نفس المصدر: ج6، ص14ـ16.
وهذا التقرير هو الذي أشرنا إليه آنفاً في توضيح التقرير الأوّل على السبيل المستقيم. وله مزيّة على برهان الشيخ هي عدم احتياجه إلى سبق إبطال التسلسل، بل هو بنفسه برهان عليه. كما أنّه ناظر إلى حقيقة الوجود العينيّة. بخلاف برهان الشيخ، حيث إنّ المأخوذ فيه هو عنوان الموجود القابل للانطباق على المهيّة، كما أنّ عنوان الممكن المأخوذ فيه هو وصف للمهيّة، فلا يناسب القول بأصالة الوجود. وإلى هذا الوجه أشار حيث قال «وههنا ـ يعني في برهان الشيخ ـ يكون النظر في مفهوم الوجود».(1)
ثمّ قال بعد تقرير البرهان: «واعلم أنّ هذه الحجّة في غاية المتانة والقوّة، يقرب مأخذها من مأخذ طريقة الإشراقيّين التي تبتني على قاعدة النور».(2) وهذه الطريقة هي التي بيّنها شيخ الإشراق بقوله «النور المجرّد إذا كان فاقراً في مهيّته فاحتياجه لا يكون إلى الجوهر الغاسق الميّت، إذ لا يصلح هو لأن يوجِد أشرفَ وأتمَّ منه لا في جهة، وأنّى يفيد الغاسق النور؟ فإن كان النور المجرّد فاقراً في تحقّقه فإلى نور قائم. ثمّ لا تذهب الأنوار القائمة المترتّبة سلسلتها إلى غير النهاية، لما عرفت من البرهان الموجب للنهاية في المترتّبات المجتمعة، فيجب أن تنتهي الأنوار القائمة والعارضة والبرازخ وهيآتها إلى نور ليس وراءه نور، وهو نور الأنوار».(3)
وقال صدر المتألّهين: «والحاصل أنّ صاحب الإشراقيّين لو كان قصَد بمهيّة النور الذي هو عنده بسيط متفاوت بالكمال والنقص حقيقةَ الوجود بعينها صحّ ما ذهب إليه، وإن أراد به مفهوماً من المفهومات التي من شأنها الكلّية والاشتراك بين الكثيرين فلا يمكن تصحيحه».(4)
1. نفس المصدر: ص26ـ27.
2. نفس المصدر: ص16ـ17.
3. راجع: حكمة الإشراق: ص121.
4. راجع: الأسفار: ج6، ص23.
ثمّ إنّه بناءاً على تطبيق النور على حقيقة الوجود يبقي فرق بارز بين البرهانين، وهو احتياج البرهان الإشراقيّ إلى إبطال التسلسل، دون برهان صدر المتألّهين. ولعلّه لأجل ذلك جعل برهانه قريب المأخذ من ذلك. وهناك وجه آخر للفرق أشار إليه المحقّق السبزواريّ في تعليقته على الأسفار، وهو أنّ قاعدة النور لا تشمل الأجسام والأعراض التي هي عندهم غواسق، بخلاف نور الوجود.(1)
ولْيُعلمْ أنّ برهان صدر المتألّهين يشترك مع برهان الشيخ في أنّهما إنّما يُثبتان وجود حقيقة واجبة الوجود، ويحتاجان في إثبات أنّه غير العالَم إلى بيان آخر، كإثبات بساطة وجود الواجب وصرافته ولا تناهيه على الإطلاق، ممّا لا يوجد في العالم المادّيّ ولا في ماوراءه من المجرّدات الفاقرة الذوات. وقد أشار صدر المتألّهين في ضمن بيانه إلى أنّ الوجود المستغني بسيط صرف، لكنّ الاُصول السالفة لا تفي بإثباته، فيبقي إثبات ذلك رهنَ ما يأتي من البرهان في الفصل الرابع. وقد مرّ ما يفيد لهذا الباب في خامس الاُمور التي ذكرناها تحت الرقم (231).
الفصل الثاني
400 ـ قوله «من البراهين عليه...»
هذا هو نفس البرهان الذي نسبه الشيخ إلى الصدّيقين. وهناك برهان آخر يثبت فيه إمكان العالَم بما يشتمل عليه من المادّيات والمجرّدات من طريق ثبوت المهيّة لها وملازمتها الإمكان أو من طريق آخر،(2) ثمّ ينضمّ إليه احتياج الممكن إلى العلّة ولزوم انتهاء سلسلة العلل إلى الواجب بالذات المستغني عن العلّة. وللأوّل فضل
1. راجع: نفس المصدر: ذيل الصفحة 17.
2. راجع: المطارحات: ص388؛ والمباحث المشرقية: ج2، ص450.
عليه من جهة عدم احتياجه إلى معرفة صفات الخلق، وله فضل على الأوّل من جهة عدم احتياجه إلى إثبات كون الواجب وراء العالَم.
وقد أقام شيخ الإشراق حجّة اُخرى مبنيّة على إثبات إمكان العالم من طريق احتياجه إلى اجزائه(1) وناقش فيها صدر المتألّهين.(2)
ثمّ إنّ هناك برهاناً ربما يسمّى «برهان الإمكان» أقامه الفارابيّ وقرّره صدر المتألّهين،(3) ولا يحتاج إلى سبق إبطال التسلسل. وحاصله أنّ الممكن سواء كان واحداً أو متعدّداً، مترتباً أو متكافئاً، لا يقتضي وجوب الوجود، فلابدّ في وجود الممكن المترتّب على وجوبه من موجود واجب بالذات.
ولعلّ صدر المتألّهين استلهمَ برهانه من هذا البرهان بتبديل الإمكان الماهويّ بالفقر الوجوديّ.
401 ـ قوله «أقامه الطبيعيّون من طريق الحركة»
برهان الحركة يبتني على أربع مقدّمات، هي احتياج المتحرّك إلى المحرّك، ولزوم انتهاء المحرّك إلي ما ليس بمتحرّك، وتجرّد ما ليس بقابل للحركة، ولزوم انتهاء سلسلة المجرّدات إلى الواجب بالذات.(4) والمقدّمة الأخيرة هي التي تتبيّن بالمقدّمات المأخوذة في سائر البراهين، كما أشرنا إليه سابقاً.
وقال صدر المتألّهين بعد تقريره: «وكمال هذه الطريقة بما حقّقناه وأحكمناه من إثبات الحركة الجوهريّة في جميع الطبائع الجسمانيّة».(5)
1. راجع: المطارحات: ص386ـ387.
2. راجع: الأسفار: ج6، ص30ـ36.
3. راجع: نفس المصدر: ص36ـ37.
4. راجع: المطارحات: ص388ـ389؛ والأسفار: ج6، ص4244؛ والمبدء والمعاد: ص17ـ18.
5. راجع: الأسفار: ج6، ص44.
إن قلت: المقدّمة الثانية تنافي ما ذكروا من لزوم كون علّة الحركة متحرّكة، وهو الذي تبنّاه صدر المتألّهين في أحد البراهين التي أقامها على الحركة الجوهريّة.
قلت: المحرّك الذي يجب أن يكون متحرّكاً هو المحرّك الطبيعيّ أي السبب المباشر لتغيّر الأجسام في أعراضها، وأمّا الذي يجب انتهاء سلسلة المحرّكات إليه فهو المحرّك الإلهيّ أي موجد الحركة والمتحرّك، فلا تهافت بين القاعدتين. وربما يفسّر المحرّك الإلهيّ بالعلّة الغائيّة لحركات الأجسام، بناءاً على كون حركات الأفلاك معلولة لشوق نفوسها إلى التشبّه بالمفارقات، وكون الواجب تعالى غاية قصوى لجميع الموجودات، فتأمّل.
402 ـ قوله «من طريق النفس الإنسانيّة»
هذا البرهان يبتني على خمس مقدّمات هي: تجرّد النفس، وحدوثها، وإمكانها، واحتياجها إلى سبب غير جسمانيّ، ولزوم انتهاء سلسلة الأسباب المجرّدة إلى الواجب بالذات. والمقدّمة الثانيّة تتبيّن ببرهان يبتني على امتناع تمايز النفوس قبل الأبدان وامتناع تناسخها بعدها، والمقدّمة الثالثة متفرّعة عليه. وأمّا المقدّمة الأخيرة فيحتاج إثباتها إلى المقدّمات المأخوذة في سائر البراهين كما في البرهان السابق. ومع ذلك فقد وصفه صدر المتألّهين بأنـّه شريف جدّاً.(1)
403 ـ قوله «برهان آخر للمتكلّمين...»
هذا البرهان يبتني على أربع مقدّمات مترتّبة هي قابليّة الأجسام للتغيّر، وحدوثها، واحتياجها إلى علّة غير جسمانيّة، وبطلان الدور والتسلسل. والمتكلّمون يرون أنّ تغيّر الأعراض كافٍ في اثبات حدوث الجواهر الجسمانيّة، وأنّ الحدوث يكفي في
1. راجع: نفس المصدر: ص4447؛ وراجع: المبدء والمعاد: ص18ـ21؛ والمطارحات: ص402403.
إثبات احتياجها إلى العلّة، وأنّ القدم الزمانيّ والتجرّد ينحصران في الواجب تعالى فيتوسّلون لإثبات انتهاء الأسباب إلى سبب قديم ومجرّد بإبطال الدور والتسلسل. لكن استلزام تغيّر الأعراض لحدوث الأجسام غير بيّن ولا مبيّن كما نبّه عليه الاُستاذ(قدسسره) إلاّ على القول بالحركة الجوهريّة، والحدوث إنّما هو أمارة على الإمكان الذي هو ملاك الحاجة. فينبغي أخذ ذلك مقدّمة اُخرى. والتجرّد كالقدم الزمانيّ لا يلازم وجوب الوجود، فلتؤخذ المقدّمة الأخيرة لإثبات لزوم انتهاء العلل إلي الواجب بالذات، كما مرّ نظيره في البرهانين الأخيرين.
الفصل الثالث
404 ـ قوله «في أنّ الواجب لذاته لا مهيّة له»
قد مرّ البحث عنه في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة، وقد أشرنا هناك إلى بعض ما يترتّب عليه من النتائج تحت الرقم (62) وسوف تلاحظ الاستفادة منه في الفصل التالي لإثبات بساطة وجود الواجب تعالى.
ومجموع ما استدلّ به في هذا الكتاب لإثبات المسألة أربعة براهين: الأوّل ما أشار إليه في كلا الموضعين من تساوق المهيّة مع الإمكان ممّا قد ثبت في الفصل الأوّل من تلك المرحلة فينتج أن لا مهيّة لغير الممكن. والبرهان الثاني أيضاً قد مرّ ذكره تفصيلاً، وإنّما أعاده ههنا تمهيداً لذكر إشكال لم يذكر هناك ودفعه. والبرهان الثالث مذكور هناك فقط، وخصّ البرهان الرابع بالذكر ههنا.
405 ـ قوله «ونقضها بالمهيّة ـ إلى قوله ـ غير مستقيم»
هذا هو الإشكال الذي أشرنا إليه آنفاً، وحاصله أنّه قد ذُكر في هذا البرهان أنّه لا
يجـوز كون المهيّة المفروضـة للواجب علّةً لوجودها لاستلزامه تقدّمها ـ وهي علّة فاعلة ـ على الوجود المعلول. فيرد عليه النقض بتقدّم القابل في المهيّة الممكنة، حيث إنّها تقبل الوجود من الفاعل فيلزم تقدّمها حتّى تصحّ نسبة القبول إليها. فكما أنّ تقدُّم القابل هناك غيرُ ضارٍّ فليكن تقدُّم الفاعل ههنا كذلك.
وحاصل الجواب أنّ القابل على قسمين: قابل حقيقيّ هو علّة مادّية للمجموع منه ومن الصورة التي يقبلها، وهو متقدّم بالطبع لكونه جزء العلّة؛ وقابل اعتباريّ يختصّ قبوله بوعاء التحليل الذهنيّ حيث ينحلّ الموجود إلى مهيّة ووجود. وهذا القبول الاعتباريّ لا يعني إلاّ وقوع المهيّة موضوعاً للقضيّة المترتّبة على ذلك التحليل، فلا يستلزم تقدّماً حقيقيّاً لها على الوجود. وأمّا فرض فاعليّة المهيّة للوجود العينيّ فمعناه تأثيرها الحقيقيّ فيه ويستلزم تقدّمَها بالوجود. فالوجود الذي هو ما فيه التقدّم لو كان نفس الوجود الذي فُرض معلولاً لزم تقدّم الوجود على نفسه، ولو كان وجوداً آخر نُقل الكلام إليه، وهلّم جرّاً.
واعلم أنّ هذا الإشكال هو للإمام الرازيّ،(1) وزعم صدر المتألّهين وروده فقال «هذه الحجّة غير تامّة عندنا لأنّها منقوضة بالمهيّة الموجودة...»(2) لكن دفعه سيّدنا الاُستاذ(قدسسره) وأعلن أنّها حجّة تامّة لاغبار عليها.
406 ـ قوله «حجّة اُخرى»
هذه الحجّة هي التي أقامها شيخ الإشراق،(3) وحاصلها أنّه لو كان للواجب مهيّة لكانت داخلة إمّا في مقولة الجوهر وإمّا في إحدى المقولات العَرَضيّة، لانحصار
1. راجع: المباحث المشرقية: ج1، ص37؛ وراجع: التلويحات: ص34؛ وراجع: الأسفار: ج1، ص98.
2. راجع: نفس المصدر: ج6، ص48.
3. راجع: المطارحات: ص391ـ392؛ وراجع: الأسفار: ج1، ص106ـ108؛ وج6: ص5657.
المهيّات فيها. فلو كانت من مقولة الجوهر كان الجوهر جنساً لها، فاحتاج إلى فصل يقوّمه، والاحتياج أمارة الإمكان. ومن طريق آخر: لا شكَّ في احتياج بعض أنواع الجوهر إلى الفصل، والنوع يشترك مع الجنس في ما يجوز وما لا يجوز، فما جاز لنوع جاز لجنسه، وكذا ما يمتنع عليه أو يجب له. فجنس الجوهر يتّصف بالصفة الإمكانيّة لاتّصاف بعض أنواعه بها. فلا يجوز أن تكون المهيّة المفروضة للواجب داخلة تحت مقولة الجوهر، وبطريق أولى لا يجوز دخولها تحت المقولات العَرضيّة، لكون الحاجة فيها أبينَ، فينتج أن لا مهيّة له سبحانه.
ويمكن المناقشة في هذه الحجّة بأنّ حصْر جميع المهيّات في المقولات ممنوع، وقد صرّح صدر المتألّهين(1) بأنّ الاندراج في المقولات يختصّ بالمهيّات المركّبة من الأجناس والفصول، فلا مانع عقلاً من فرض مهيّة بسيطة غير مركّبة من الجنس والفصل ولا داخلة في شيء من المقولات. مضافاً إلى ما مرّ من أنّ الجوهر والعرض ليسا مفهومين جنسيّين، بل هما من المعقولات الثانية، كما اختار شيخ الإشراق نفسُه في بعض كتبه،(2) فراجع الرقم (111).
407 ـ قوله «وقد تبيّن ممّا تقدّم...»
قد مرّ بيان أقسام الضرورة في الفصل الأوّل والفصل الثالث من المرحلة الرابعة. والضرورة الأزليّة مأخوذة من مادّة قضيّة لا يشترط ثبوت المحمول لموضوعها بشيء حتّى وجود الموضوع الذي يشترط في الضروريّة الذاتيّة. فإنّ هذا الشرط إنّما يتصوّر في ما كان الموضوع ذا مهيّة لكن فرضها معدوم، كما أنّ بقاء الوصف إنّما يشترط في ما يمكن زوال الوصف عنه.
1. نفس المصدر: ج4، ص6.
2. راجع: حكمة الإشراق: ص61 و 71.
الفصل الرابع
408 ـ قوله «في أنّ الواجب تعالى بسيط...»
بعد الفراغ عن البحث عن وجود الواجب تبارك وتعالى تجيء النوبة إلى البحث عن بساطته ووحدته ونفي أيّ كثرة عنه سبحانه. فإنّ الكثرة قد تفرض مع الوحدة، وهي الكثرة في ذات الشيء ولازمها التركّب، وقد تفرض دون الوحدة ولازمها تعدّد الذات، وسيأتي البحث عنها في الفصل التالي.
ثمّ الكثرة الداخليّة والتركّب في الذات قد تتصوّر من أجزاء موجودة بالقوّة، وهي الأجزاء المقداريّة ولازمها الجسميّة، أو من أجزاء موجودة بالفعل، وتلك الأجزاء قد تعتبر في الوجود الخارجيّ وهي عندهم عبارة عن المادّة والصورة الخارجيّتين، وتختصّ أيضاً بالأجسام. وقد تعتبر في المهيّة الذهنيّة وهي الأجناس والفصول إذا اُخذت لا بشرط، والموادّ والصور العقليّة إذا اُخذت بشرط لا. وقد مرّ في المرحلة الخامسة أنّ الأجناس والفصول عندهم مأخوذة من الموادّ والصور الخارجيّة إذا كان هناك تركيب خارجيّ، وكان صدر المتألّهين ممّن يصرّ على أخذ الجنس من الهيولى الاُولى، وإن كان ذلك قابلاً للمناقشة. وإذا لم يكن الموجود الخارجيّ مركّباً من المادّة والصورة اعتبر العقل له جنساً وفصلاً إذا كان له مشارك في معنىً ماهويّ، وهو التركيب العقليّ كما في الأعراض والمجرّدات. وأمّا إذا فرضنا موجوداً له مهيّة بسيطة غير مشاركة لمهيّة اُخرى في معنىً ذاتيّ لم يتصوّر له تركيب ماهويّ في الذهن أيضاً، لكن للعقل أن يحلّل ذلك الموجود إلى مهيّة ووجود إذا كان ممكن الوجود، ولهذا قالوا: «كلّ ممكن زوج تركيبي» فالبساطة الحقيقيّة التامّة إنّما تختصّ بموجود لا مهيّة له مطلقاً، ويعبّر عنها بالصرافة، ولازمها اللاتناهي المطلق.
409 ـ قوله «فليس له حدّ»
هذا البرهان يهدف إلى نفي الأجزاء بالفعل عن الواجب تعالى،(1) سواء فُرضت الأجزاء خارجيّة أو ذهنيّة. ويبتني على ما مرّ في الفصل السابق من نفي المهيّة عنه سبحانه. وتقريره أنّ الأجزاء الذهنيّة وهي الأجناس والفصول هي التي تشكّل الحدّ، والحدّ يختصّ بالمهيّة ـ وإن لم يكن العكس ثابتاً لصحّة فرض مهيّة بسيطة غير مركّبة من جنس وفصل ـ فإذا لم تكن لموجود مّا مهيّةٌ لم تكن له حدّ، فلم تكن له أجزاء ذهنيّة من الأجناس والفصول. ثمّ بالنظر إلى أنّ الموجود الخارجيّ إذا كان مركّباً من مادّة وصورة كان له جنس وفصل لا محالة ـ وإن لم يكن عكسه صادقاً لثبوت الجنس والفصل لبعض البسائط الخارجيّة أيضاً كالأعراض والمجرّدات ـ وقد ثبت أنّ ما لا مهيّة له فلا جنس له ولا فصل، فينتج أنّ ما لا مهيّة له لا جزء خارجيّاً له، فليس مركّباً من المادّة والصورة الخارجيّتين، كما أنّه لا يكون مركّباً من مادّة وصورة عقليّتين أيضاً لأنّهما الجنس والفصل مأخوذين بشرط لا.
410 ـ قوله «لو كان له جزء...»
هذا البرهان(2) أيضاً ينفي الأجزاء الفعليّة من طريق أنّ للأجزاء تقدُّماً بالطبع على الكلّ، فيحتاج الكلّ إليها ويتوقّف عليها ويتأخّر عنها، وكلّ هذه أمارات الإمكان.
411 ـ قوله «لو تركّبت ذات الواجب...»
هذا البرهان(3) كسابقيه يرمي إلى نفي الأجزاء بالفعل، وتقريره أنّ الأجزاء المفروضة
1. راجع: الأسفار: ج6، ص103؛ وراجع: النجاة: ص227ـ228.
2. راجع: المباحث المشرقية: ج2، ص456؛ و لأسفار: ج6، ص100؛ والمبدء والمعاد: ص41.
3. راجع: الأسفار: ج6، ص102ـ103؛ والمبدء والمعاد: ص4142.
إمّا أن تكون كلّها واجبة الوجود وإمّا أن يكون بعضها أو كلّها ممكن الوجود، والفرض الأوّل يَبطل بعدم حصول التلاحم بين الواجبين المفروضين، لكون النسبة بينهما إمكاناً بالقياس، ممّا يكشف عن عدم تلازم بينهما مطلقاً، مع أنّ الأجزاء يجب أن تتلاحم وتتلازم في الكلّ، وإلاّ كانت اُموراً كثيرة مستقلّة لا واحداً مركّبا من الأجزاء. فيرجع الفرض إلى تعدّد الواجب لا تركّبه، وسيأتي الكلام فيه، والفرض الثاني يستلزم توقّف الواجب على الممكن وهو محال، ويستلزم أيضاً دخول المهيّة في حقيقة الواجب، وقد مرّ بطلانه في الفصل السابق. مضافاً إلى أنّه يُنقل الكلام حينئذ إلى الممكن الذي يشكّل جزءاً للواجب ويتساءل: هل هو معلول للواجب المتشكّل منه ومن غيره، أو معلول لغير هذا الواجب، ولا ثالث لهما، لاحتياج الممكن أيّاً ما كان إلى علّة. فلو فرض معلولاً لهذا الواجب استلزم تقدُّم الشيء على نفسه بمرتبتين، ولو فرض معلولاً لواجب آخر بالمباشرة أو بالتوسيط استلزم كون الواجب معلولاً لغيره، وهو مناقض لوجوب وجوده.
412 ـ قوله «لو كان للواجب جزء مقداريّ...»
هذا البرهان هو الذي اُقيم على نفي الأجزاء بالقوّة ـ وهي الأجزاء المقداريّة ـ عن الواجب تعالى.(1) وحاصله أن معنى كون موجود ذا أجزاء مقداريّة هو إمكان انقسامه إلى أجزاء بالفعل ولو في نظر العقل، فتلك الأجزاء إمّا أن تكون على فرض تحقّقها بالفعل ممكنةً وإمّا أن تكون واجبة، وعلى الأوّل يلزم كون الأجزاء المقداريّة مغايرة الحقيقة للكلّ، وهو محال، وعلى الثانييلزم كون الأجزاء الواجبةموجودة بالقوّة، والوجود بالقوّة ينافيوجوبوجودها. ويرد على الفرضينجميعاً أنّهما يستلزمان إمكان زوال الواجب بانقسامه إلى الأجزاء، وهو يناقض وجوب وجوده. فليُجعل هذا برهاناً آخر.
1. راجع: الأسفار: ج6، ص101.
413 ـ قوله «ثمّ إنّ من التركّب...»
وههنا يعالج مسألة البساطة بمعناها الأدقّ، وهو كون الوجود بحيث لا ينتزع عنه مفهوم عدميّ يحكي عن أي قصور ونقص ومحدوديّة فيه. ويمكن إثبات ذلك بالنظر إلى أنّ المهيةّ إنّما تحكي عن حدود الوجود، فكلّ ذي مهيّة فهو ناقص محدود الوجود من جهة من الجهات، فنفي المهيّة عن الواجب يُنتج نفي أيّ حدّ ونقص عنه، فيثبت صرافة وجوده ولا تناهيه المطلق. وقوله «من السلوب» بيان للموصول في قوله «ما يتّصف والمراد أنّ من المركّب ما يحصل من تشافع الجهات الوجوديّة والعدميّة، لا من خصوص الأعدام والسلوب. فاتّصاف موجود بوصف سلبيّ ـ إذا كان راجعاً إلى سلب الكمال ـ هو نوع من التركّب، ويحصل بتحليل العقل ذلك الموجودَ الناقص إلى حيثيّة وجوديّة واُخرى عدميّة.
414 ـ قوله «بيان ذلك...»
هذا البيان يهدف إلى إثبات أنّ كلّ هوّية يُسلب عنها كمال وجوديّ فهو مركّب نوعاً من التركيب الدقيق العقليّ، ثمّ يستنتج منه أنّ كلّ ما هو بسيط الحقيقة فلا يسلب عنه شيء من الكمالات الوجوديّة. فإذا ثبتت بساطة وجود الواجب تعالى على الإطلاق عن طريق نفي المهيّة عنه كما أشرنا إليه آنفاً يجعل ذلك صغرى لتلك الكبرى الكلّية، ويستنتج أنّ الواجب لا يكون فاقداً لأيّ كمال وجوديّ.
لكنّ الاُستاذ(قدسسره) عمد إلى إثبات كلّ الكمالات له من طريق أنّ كلّ كمال وجوديّ للممكنات فهو فائض عن عللها، وتنتهي سلسلة العلل إلى الواجب بالذات، فهو واجد لجميع كمالاتها على وجه أشرف وأعلى، لاستحالة كون معطي الشيء فاقداً له، ثمّ استنتج أنّه بسيط الحقيقة.
لكن غاية ما يثبت بهذا البيان أنّ له تعالى كلَّ الكمالات الحاصلة للممكنات على
وجه أتمّ وأعلى، لا أنّ له كلّ كمال مفروض. وبعبارة اُخرى لا ينافي هذا البرهان فقدَ الواجب لكمال لم تحصل ولن تحصل مرتبة منه للممكنات أيضاً، فتأمّل.
415 ـ قوله «فإن قيل: لازم ما تقدّم...»
هذا الإشكال إنّما نشأ من قولهم «بسيط الحقيقة كلّ الأشياء وتمام الأشياء»(1) فتُوُهّم أنّ لازمه جواز حمله على كلّ الأشياء وبالعكس، لكن قد ظهر من البيان السابق أنّ معنى ذلك الكلام هو أنّ له كمالاتِ الأشياء على وجه أتمَّ مما هو موجود في الأشياء، ولا يجوز حمل شيء من الأشياء ولا مجموعها على الله تعالى ولا بالعكس، أمّا مهيّات الأشياء فواضح، لعدم تطرّق المهيّة والمعاني الماهويّة إلى ذاته سبحانه، وأمّا وجوداتها الخاصّة فلو وقع حمل بينها وبين الواجب لاستلزم اتّحاد الواجب بجهاتها العدميّة أيضاً. فالحمل في ذلك العنوان ليس ممّا يتعارف في المحاورات، بل هو من قبيل حمل الحقيقة والرقيقة، وقد مرّ تحت الرقم (215) أنّ مرجعه إلى حمل «ذي هو» فيكون المعنى أنّ بسيط الحقيقة واجد لجميع الكمالات الوجوديّة على وجه أشرف وأعلى ممّا يوجد في الممكنات.
الفصل الخامس
416 ـ قوله «في توحيد الواجب لذاته...»
ربما يظهر من بعض كلمات الشيخ وغيره(2) أنّه إذا ثبت أنّ الواجب تعالى هو نفس
1. نفس المصدر: ص110ـ118.
2. راجع: التعليقات: ص61؛ وراجع: الفصل السابع من المقالة الأولى والفصل الخامس من المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء؛ وراجع: التحصيل: ص506، و 570؛ وراجع: التلويحات: ص36؛ والقبسات: ص76.
الوجود المتشخّص بذاته وأنّه لا مهيّة له ثبتت وحدته أيضاً، لأنّ الكثرة إنّما تتصوّر في أفراد مهيّة كلّية غير متشخّصة بذاتها، فيتشخّص كلّ فرد منها بعوارض مشخّصه تخصّه، وحيث إنّ الواجب تعالى ليس إلاّ وجوداً بحتاً بسيطاً متشخّصاً بذاته لا بعوارض مشخّصة، فلا يتصوّر تعدّده. ويمكن المناقشة فيه بمنع انحصار الكثرة في تعدّد أفراد المهيّة، فلأحد أن يفرض واجبين يكون كلّ واحد منهما نفس الوجود المتشخّص بالذات بلا جامع ماهوىّ بينهما، كما نبّه عليه صدر المتألّهين.(1)
417 ـ قوله «قد تبيّن في الفصول السابقة...»
هذا البرهان يتشكّل من مقدّمتين: إحداهما وهي الصغرى أنّ الواجب تعالى وجودٌ صِرف، وثانيتهما وهي الكبرى أنّ كلّ ما هو صرف فلا يقبل التكرّر والتكثّر، فينتج أنّ الواجب واحد لا يمكن تعدّده. ولابدّ من توضيح لتينك المقدّمتين، فنقول:
الصِرف ـ وهو الخالص المحض ـ قد يقع نعتاً للمهيّة، ويراد به المهيّة المطلقة، ومعناه أنّ كلّ مهيّة إذا جُرّدتْ عن جميع العوارض المشخّصة فهي أمر وحدانيّ. وهذه الوحدة هي الوحدة النوعيّة في الأنواع والوحدة الجنسيّة في الأجناس، ولا تتّصف بها إلاّ المهيّة المطلقة في وعاء الذهن بما أنّها مفهوم، لا بما أنّ لها وجوداً ذهنيّاً، فإنّ وجودها الذهنيّ يتكثّر بتكثُّر التصوّرات والأذهان، كما أنّ الكلّي الطبيعيّ، وهي المهيّة المطلقة من قيد الإطلاق أيضاً يتكثّر بتكثُّر الأفراد الخارجيّة لصدقها على المهيّة المخلوطة. وبالجملة فهذه الصرافة المفهوميّة لا تمتّ إلى صرافة وجود الواجب بصلة أصلاً، فلا تغفل.
وقد يقع الصِرف نعتاً للوجود، وهذا على ضربين: فقد يراد به قصر النظر على الوجود العينيّ لموجود مّا بلا التفات إلى خصوصيّاته وحدوده ونقائصه ممّا يصير
1. راجع: الأسفار: ج1، ص129.
منشأً لانتزاع المهيّات وسائر المفاهيم، كما في توجّه النفس إلىوجودها العينيّ المشهود لها حضوراً من غير أن تلاحظ خصوصيّاته من العليّة والمعلوليّة وغيرها ومن غير أن تلاحظ حدودها التي هي منشأ انتزاع مهيّة النفس. فهذا المعنى من الصرف يتّصف به كلّ وجود عينيّ، ويوصف بأنّه لا يتكرّر بالمعنى الذي مرّ في الفصل الخامس من المرحلة الاُولى، ويرجع إلى نفي تماثل الوجودين من جميع الجهات. وهذا المعنى أيضاً غير مراد ههنا، لأنّ غاية ما يستفاد منه أنّه إذا فرض واجبان كان لكلّ منهما جهة امتياز تخصّه، وهذا هو الذي يفيد للبرهان الآتي، دون هذا البرهان.
وقد يراد بصرافة الوجود كونه بحيث لا يمكن انتزاع مفهوم ماهويّ وعدميّ منه، ويساوق بساطة الحقيقة واللاتناهي المطلق على ما مرّ ذكره في آخر الفصل السابق، وهو الذي يفيد في هذا البرهان، وعليه يحمل كلام شيخ الإشراق حيث قال: «صِرف الوجود الذي لا أتمَّ منه كلّما فرضته فإذا نظرت فهو هو، إذ لا ميز في صِرف الشيء».(1)
وأمّا الكبرى فإن اُريد بكلّيتها ما يشمل صرافة المهيّة وصرافة الوجود بالمعنى الأوّل كان معناها جمعَ حقائقَ مختلفةٍ في لفظ مشترك، فإنّ إطلاق الصِّرف على المعاني المذكورة أشبهُ بإطلاق المشترك اللفظيّ على معانيه، كما أنّ نفي التكرّر والتكثّر في كلّ مورد يعطي معنىً خاصّاً بذلك المورد. وإن اُريد بها صرافة الوجود بالمعنى الثاني كانت منحصرة في مصداق واحد هو ذات الواجب تبارك وتعالى، فالكليّة إنّما هي باعتبار فرض مصاديق متعدّدة، كما يقال إنّ النسبة بين كلّ واجبين مفروضين هي الإمكان بالقياس. وكيف كان فالذي يفيد في هذا البرهان هو أنّ الوجود الصرف الذي لا أتمَّ منه والذي يلازم اللاتناهي المطلق واحد بالوحدة الحقّة الحقيقيّة، وليست قابلة للتكثّر والتكرّر بوجه.(2) وقد تبيّنت هذه المقدّمة في آخر الفصل السابق.
1. راجع: التلويحات: ص35.
2. راجع: الأسفار: ج1، ص135ـ138؛ وراجع: الرقم (66) من هذه التعليقة.
لا يقال: لازم هذا البرهان أن لا يتحقّق وجود لأيّ شيء آخَرَ ولو كان مخلوقاً له تعالى، لأنّ فرض أيّ وجود مبائن له يعني خلوَّ الأوّل عنه، ويستلزم ذلك تناهيه وشوبه بمعنى عدميّ لأجل فقدانه للوجود الثاني.
فإنّه يقال: الذي ينافي صرافته ولا تناهيه هو أن يفرض وجود مستقلّ في عرْضه، بأن يفرض واجب آخَرُ، وأمّا فرض وجود رابط في طوله فلا ينافي صرافته ووجدانه لكلّ كمال وجوديّ، فإنّ الوجود الإمكانيّ هو عين الفقر والربط والتعلّق، ولا استقلال له حتّى يعدّ ثانياً للواجب تعالى، وهو سبحانه واجد بوجوده البسيط الأحديّ كلَّ كمال مفروض على وجه أتمّ وأعلى.
418 ـ قوله «واُورد عليه الشبهة...»
قال شيخ الإشراق بعد ما استدلّ للتوحيد بما يبتني على نفي المهيّة عن الواجب تعالى: «وأمّا الذي يطول في الكتب من البرهان على وحدة واجب الوجود... فإنّما يتقرّر إذا بُيّن أنّ الوجود لا يصحّ أن يكون اعتباريّاً لواجب الوجود ولا زائداً على المهيّة، وإن لم يتبيّن هذا فيقول القائل: يشتركان في وجوب الوجود وهو اعتباريّ لا وجود له في الأعيان، فليس ممّا يحتاج إلى علّة».(1) وقال أيضاً بصدد المناقشة في برهان آخر: «يقول الخصم: وجوب الوجود لازم اعتباريّ، ولكلّ واحد منهما ذات وحدانيّة ـ إلى أن قال ـ بل إنّما يتأتّى إذا بُيّن أنّ الوجود في واجب الوجود خاصّةً ليس باعتباريّ وإن وُضع اعتباريّاً في غيره، وأنّ ماهيّته عين الوجود».(2)
وقد أكّد صدر المتألّهين على أنّ براهين التوحيد إنّما تتمّ على القول بأصالة الوجود ونفي المهيّة عن الواجب تعالى، وأنّ هذه الشبهة شديدة الورود على القول
1. راجع: المطارحات: ص393.
2. نفس المصدر: ص395.
بأصالة المهيّة مطلقاً.(1) وقال المحقّق السبزواريّ في تعليقته على الأسفار ما حاصله أنّ الشبهة المذكورة ترد على القول بكون الوجودات حقائقَ متباينةً أيضاً، لتجويزهم انتزاعَ مفهوم واحد عن حقائق متباينةٍ، فلا يمكنهم دفع هذه الشبهة.(2)
لكن يمكن أن يقال بأنّ القول بنفي المهيّة عن الواجب تعالى يكفي لدفع الشبهة وإن قيل باعتباريّة الوجود في الممكنات، ويبقى جواب السؤال عن هذا التفصيل على ذمّتهم. وكذا يمكن دفعها على القول بتباين ذوات المهيّات في الموجود مع القول بنفي المهيّة عن الواجب تعالى. وقد مرّ تحت الرقم (28 و 29)، أنّ التشكيك الخاصّي في الوجود يختصّ بما بين العلل ومعاليلها دون المعاليل الواقعة في مرتبة واحدة.
وكيف كان فقد قال صدر المتألّهين في دفع الشبهة ما هذا لفظه: «وجه الاندفاع أنّ مفهوم واجب الوجود لا يخلو إمّا أن يكون فهمه عن نفس ذات كلّ منهما من دون اعتبار حيثيّة خارجة عنها، أيَّةَ حيثيّةٍ كانت، أو مع اعتبار تلك الحيثيّة، وكلا الشقّين مستحيلان. أمّا الثاني فلما مرّ أنّ كلّ ما لم يكن ذاته مجرّدَ حيثيّة انتزاع الوجود والوجوب والفعليّة والتمام فهو ممكن في حدّ ذاته، ناقص في حريم نفسه. وأمّا الأوّل فلأنّ مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات ـ وبالجملة ما منه الحكاية بذلك المعنى وبحسبه التعبير عنه به مع قطع النظر عن أيّة حيثيّة وأيّةِ جهة اُخرى كانت ـ لا يمكن أن يكون حقائقَ مختلفة الذوات، متباينة المعاني، غيرَ مشتركةٍ في ذاتيّ أصلاً».(3) وقال في موضع آخر: «لو كان في الوجود واجبان لذاتيهما كان الوجود الانتزاعيّ مشتركاً بينهما كما هو مسلّم عند الخصم، وكان ما
1. راجع: الأسفار: ج1، ص131؛ وج6: ص5860؛ والمبدء والمعاد: ص53.
2. راجع: الأسفار: ج6، ذيل الصفحة 58 و 59.
3. نفس المصدر: ج1، ص133.
بإزائه من الوجود الحقيقيّ مشتركاً أيضاً بوجه ما، فلابدّ من امتياز أحدهما عن الآخر بحسب أصل الذات، إذ جهة الاتّفاق بين الشيئين إذا كانت ذاتيّة لابدّ وأن يكون جهة الامتياز والتعيّن أيضاً ذاتيّاً، فلم يكن ذات كلّ منهما بسيطة، والتركيب ينافي الوجوب كما علم».(1)
419 ـ قوله «لو تعدد الواجب بالذات...»
حاصله أنّه لو فرض واجبان كان لكلّ منهما ما ليس للآخر من الكمال الوجوديّ، لكنّ الواجب صِرفٌ بسيطٌ لا يفقد أيّ كمال، فليس إلاّ واحداً. فهذا البرهان يرجع إلى البرهان الأوّل، والفرق بينهما هو الفرق بين البيان المستقيم والخلفيّ.
420 ـ قوله «برهان آخر ذكره الفارابيّ...»
ونقله عنه في الأسفار ثمّ قال: «هذا مجملٌ تفصيلُه ما سبق من البيان». والظاهر أنّه إشارة إلى البرهان المذكور قبله: «لو تعدّد الواجب فإمّا أن تتّحد المهيّة في ذلك المتعدّد أو تختلف، وعلى الأوّل لا يكون حملها على كثيرين لذاتها، وإلاّ لما كانت مهيّتها بواحدة، فيلزم تحقّق الكثير بدون الواحد. وعلى الثاني يكون وجوب الوجود عارضاً لهما، وكلُّ عارض معلول إمّا لمعروضه فقط أو بمداخلة غيره، والقسمان باطلان: أمّا الأوّل فلاستيجاب كونه علّة نفسه وأمّا الثاني فأفحش».(2) ولا ريب أنّ المراد بالمهيّة ههنا هو «ما به الشيء هو هو» فلا ينافي نفي المهيّة بمعنى «ما يقال في جواب ما هو» عنه تعالى.
وللشيخ عبارات في التعليقات قريبة منها، كقوله «لا يصحّ في واجب الوجود
1. نفس المصدر: ج6، ص60.
2. راجع: نفس المصدر: ص6263؛ والمقاومات: ص188ـ189.
الاثنينيّة، فإنّه لا ينقسم، لأنّ المعنى الأحديّ الذات لا ينقسم بذاته، فإن انقسم هذا المعنى ـ وهو وجوب الوجود ـ فإمّا أن يكون واجباً فيه أو ممكناً أن ينقسم، وكلا الوجهين محال في واجب الوجود، فإنّه غير واجب فيه أن ينقسم لأنّه بذاته واجب ولا علّة له في وجوده، فهو أحديّ الذات، والإمكان منه أبعد».(1) ولعلّ التعبير بالانقسام بدلاً عن التعدّد والتكثّر ـ كما عبّر به الفارابيّ أيضاً ـ هو لأجل الإشارة إلى حقيقته العينيّة دون مفهوم الواجب.
وقال في موضع آخر: «فإن تكثَّر واجب الوجود وكان تكثُّره بذاته لم يكن واحد أصلاً ولم تكن كثرة أيضاً، فيبطل أن يوجَد الواحد من واجب الوجود، فإذن لا يتكثّر معنى واجب الوجود. وواجب الوجود شخصه في ذاته لا يتشخّص بغير ذاته».(2)
وقال أيضاً: «لا يصحّ في واجب الوجود أن يتكثّر لا في معناه ولا في تشخّصه، والشيء إذا تكثّر فإمّا أن يتكثّر في معناه، وكلّ معنى فإنّه في ذاته واحد لا يتكثّر في حقيقيته، وإمّا في تشخّصه، فإنّ شخص واجب الوجود أنّه هو، فتشخُّصه و«أنّه هو» واحد، وهو نفس ذاته وحقيقته».(3)
وأحسن كلماته في هذا الباب هو قوله: «إن كان واجب الوجود اثنين، فكلّ واحد منهما إمّا أن يكون وجوب الوجود وهويّته شيئاً واحداً فيكون كلُّ ماهو واجب الوجود هو بعينه، وإن كان وجوب الوجود غير هويّته لكنّه يختصّ به ويقارنه، فاختصاصه به إمّا لذاته أو لعلّة، فإن كان لذاته ولأنّه واجب الوجود كان كلّ ما هو واجب الوجود هو بعينه، وإن كان لسبب كان معلولاً».(4)
1. راجع: التعليقات: ص37.
2. نفس المصدر: ص184.
3. نفس المصدر: ص61.
4. راجع: نفس المصدر: ص184 و 182 و 183؛ وراجع: النمط الرابع من الإشارات؛ والقبسات: ص76ـ77؛ والنجاة: ص229ـ230؛ وراجع: الفصل السابع من المقالة الاُولى، والفصل الخامس من المقالة الثامنة من إلهيّات الشفاء.
الفصل السادس
421 ـ قوله «في توحيد الواجب لذاته في ربوبيّته...»
هذا الفصل يحاذي ما عقده في الأسفار بهذا العنوان «في أنّ واجب الوجود لا شريك له في الإلهيّة وأنّ إله العالم واحد»(1) وقال في وجه إفراده بالذكر: «إذ مجرّد وحدة الواجب بالذات لا يوجب في أوّل النظر كون الإله واحداً». ولعلّ النكتة في الإتيان بالربوبيّة والربّ ـ بدلاً عن الإلهيّة والإله ـ أنّ الأصل في معنى الإله هو المعبود، والمراد بهذا الفصل بيان التوحيد في الخلق والتدبير، فكان الأنسب به مفهوم الربوبيّة.
ثمّ إنّه ذكر بياناً مبنيّاً على وحدة الواجب في وجوب الوجود، حاصله أنّه لمّا ثبتت وحدة الواجب بالذات وكون ما سواه ممكناً بالذات ثبت استناد ما سواه إليه، لاحتياج الممكنات إلى الواجب بالذات بلا واسطة أو مع الواسطة، فالكلّ من عند اللّه.(2)
وذكر برهاناً آخر مبتنياً على وحدة العالم ونسبه إلى أرسطو، وحاصله أنّ العالم الجسمانيّ واحد وحدةً شخصيّة متلازمة الأجزاء، وكلّ ما كان كذلك كان له علّة واحدة. وأمّا العقول فهي علل متوسّطة لهذا العالم، وأمّا النفوس فهي صور مدبّرة للأبدان، فجميع ما سواه يستند إليه، وهو المطلوب.(3) وقد بسط القول في إثبات وحدة العالم على ما هو المأثور من المتقدّمين(4) وفيه مواقع للنظر.
ثمّ إنّه حاول تطبيق مفاد الآية الكريمة «لَوْ کَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا»(5) على هذا البرهان قائلاً «ولا يبعد أن يراد بالفساد الانتفاء رأساً. ووجه الدلالة أنّ المراد
1. راجع: الأسفار: ج6، ص92.
2. نفس المصدر: ص93ـ94؛ وراجع: المبدء والمعاد: ص55.
3. راجع: الأسفار: ج6، ص94ـ100؛ وراجع: المبدء والمعاد: ص5864.
4. راجع: النجاة: ص136ـ138.
5. سورة الأنبياء، الآية 22.
أنّه لو تعدّد الإله (تعالى عن ذلك) لزم أن يكون العالم الجسمانيّ وما ينوط به متعدّداً، واللازم باطل كما مرّ، فالملزوم مثله، كما وضح من قوله «إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ».(1)
وجدير بالذكر أنّ وحدة العالم قد تُراد بها الوحدة الاتّصالية، وهي التي تلوح من كلام المعلّم الأوّل، وقد يراد بها أنّ للعالم صورةً طبيعيّةً شخصيّة، وهو الذي يظهر من بعض ما نُقل عنه في غير هذا الموضع،(2) وقد يراد بها أنّ له نفساً مدبّرةً تسمّى بالنفس الكلّية، فيصير العالم مع تلك النفس أكبر موجود حيّ، ويعبّر العرفاء، عنه بالإنسان الكبير، كما أنّهم قد يعبّرون به عن كلّ ما سوى اللّه،(3) وقد تراد بها وحدة النظام بالنظر إلى ما لأجزائها من الفعل والتأثير في بعضها والانفعال والتأثّر عن بعضها، وهو الذي يظهر من كلام بهمنيار، وقد ركّز عليه الاُستاذ(قدسسره) في بيانه في هذا الفصل.
أمّا الوجه الأوّل فقد تصدّى المعلّم الأوّل لإثباته من طريق نفي الخلأ ـ على ما حكي عنه، وأمّا الوجهان المتوسّطان فلم يقم عليهما برهان في ما نعلم، وما ذُكر لهما من بيان فهو أشبه بالخطابة. وأمّا الوجه الأخير فمستند إلى التجارب الحسّية، لكنّه لا يكفي دليلاً على الوحدة الشخصيّة الحقيقيّة للعالم حتّى تصدق عليه الكبرى القائلة «المعلول الواحد الشخصيّ لا يصدر إلاّ عن علّة واحدة بالشخص»، ولعلّه لأجل ذلك عدل الاُستاذ(قدسسره) عن هذا البرهان إلى ما يأتي بيانه.
وأمّا الآيات الكريمة فالظاهر عدم انطباق مفادها على هذا البرهان، وتفسير الفساد بالانتفاء وعدم التحقّق رأساً مشكل جدّاً، خاصّةً بالنظر إلى قوله تعالى «فيهما» فتأمّل. ولعلّ ما سيأتي من البيان هو الأوفق بمفادها، فانتظر.
1. راجع: الأسفار: ج6، ص99؛ والآية هي 91 من سورة «المؤمنون».
2. راجع: الفصل العاشر من الفن الثاني من طبيعيّات الشفاء؛ والأسفار: ج7، ص113؛ والقبسات: ص415.
3. راجع: القبسات: ص340 و 413414 و 425 و 460462؛ وراجع: الأسفار: ج5، ص349.
422 ـ قوله «الفحص البالغ...»
هذا البيان يتشكّل من ثلاث مقدّمات: هي وحدة نظام العالم الجسمانيّ، ومعلوليّته لنظام عقليّ، ومعلوليّة ذلك لنظام ربّانيّ، فينتج أنّ هذا العالم مخلوق مدبَّر للواجب تعالى بوساطة العالم العقليّ، فهو ربّ العالمين. ولك أن تعتبر له مقدّمة رابعة هي أنّ علّة علّة الشيء علّة لذلك الشيء.
أمّا المقدّمة الاُولى فتتبيّن بارتباط أجزاء العالم بعضها ببعض، فإنّ الأجزاء الحاليّة ترتبط بالأجزاء التي سوف تحدث من حيث إنّها تشكّل موادّها وتهيّىء الأرضيّة لحدوثها، كما أنّها حدثتْ من الأجزاء السابقة. والأجزاء المتزامنة يرتبط بعضها ببعض بأنواع من التأثير والتأثّر والفعل والانفعال ممّا يؤدّي إلى نموّ بعضها وذبول بعضها الآخر إلى غير ذلك. فماء البحر مثلاً يتسخّن بضوء الشمس فيتبخّر ويصعد إلى الجوّ سحاباً، ثمّ يتبدّل بتأثير العوامل الجوّيّة إلى المطر فينزل على سطح الأرض فينمو به النبات، فيأكله الحيوان، كما أنّ الإنسان يتغذّى به وبلحم الحيوان. فلكلّ جزء من أجزاء العالم ارتباط عرْضيٌّ بالأجزاء المتزامنة وارتباط طوليٌّ زماناً بالأجزاء السابقة واللاحقة، ممّا يجعل الكلَّ منتظماً بنظام واحد شامل، فيحتاج بعضها إلى بعض في حدوثه وبقائه ونشوئه وتحوّله.
أمّا المقدّمة الثانية فتنحلّ إلى اُمور: أحدها وجود العالم العقليّ، وهو الذي اُشير إليه في ما مضى وسيأتي تفصيل القول فيه. وثانيها علّيته للعالم الجسمانيّ، ويعلم من وقوعه في مرتبة عليا من مراتب الوجود بالنسبة إلى العالم الجسمانيّ واشتماله على كمالات هذا العالم بنحو أتمّ. وثالثها وحدته، ويعلم من وحدة النظام الناشيء منه، فإنّ مثل هذا النظام الواحد الجاري في العالم الجسمانيّ لا يمكن أن يصدر عن فواعل متعدّدة، لأنّ فرض علل كثيرة لها يعني أنّ كلّ واحد منها يستقلّ بإيجاد
قسم من هذا العالم وتدبيره بلا حاجة إلى أمر آخر، ممّا يؤدّي إلى انعزال أجزاء العالم بعضها عن بعض، وقد تبيّن خلافه.
وأمّا المقدّمة الثالثة فتنحلّ أيضاً إلى ثلاثة اُمور: أحدها وجود الواجب تعالى، وثانيها وحدته، وقد تبيّنا في سالف الفصول. وثالثها علّيته للعالم العقليّ، ويتبيّن بمثل ما تبيّن به علّية العالم العقليّ للعالم الجسمانيّ. وأمّا اعتبار النظام في العالم العقليّ وفي علم الواجب تبارك وتعالى فبالنظر إلى اشتمال المرتبة العالية من الوجود على كمالات ما دونها بوجه أتمّ وأعلى، وأصل الاصطلاح للمشّائين حيث اعتبروا وجود الصور في العالم العقليّ وفي علم البارئ سبحانه، فافهم.
فبهذه المقدّمات يتبيّن أنّ الواجب بالذات الواحدَ في وجوب وجوده علّةٌ للعالم العقليّ الذي هو علّة للعالم الجسمانيّ، فتنضمّ إليه المقدّمة الأخيرة، فيستنتج أنّه علّة لما سواه بلا واسطة أو مع الواسطة، ويثبت وحدته في الربوبيّة.
ويمكن الاستغناء عن المقدّمة الثانية بأن يقال: للعالم الجسمانيّ نظام واحد، ومثل هذا النظام لا يمكن أن يستند إلاّ إلى علّة مفيضة واحدة، استناداً مباشراً أو غيرَ مباشر، وليست إلاّ الواجب بالذات. وهذا البيان يتّفق مع القول بالعقول العرْضيّة أيضاً.
بل يمكن أن يقال: إنّ هذا البيان لا يحتاج إلى سبق إثبات وحدة الواجب في وجوب وجوده أيضاً، لأنّ المطلوب هو وحدة الربّ لهذا العالم، وهو يتمّ بهذا البيان ولو فرض وجود واجب آخر غير فاعل لشيء أصلاً. ثمّ تنضمّ إليه مقدّمة اُخرى هي أنّ الواجب بالذات واجب من جميع الجهات. فيبطل فرض واجب يمكنه إيجاد العالم وقد عطّل فعله، فتثبت وحدة الواجب في وجوب وجوده أيضاً.
ولعلّ مفاد الآية السابقة الذكر أشدُّ انطباقاً على هذا البيان، وتقريره أنّ قوام هذا العالم هو بارتباط أجزائه بعضها ببعض، وفرض علل متعدّدة وأرباب متفرّقين له
يستلزم انعزال أجزائه بعضها عن بعض، لقيام كلّ جزء منه حينئذ بعلّته بلا واسطة أو بوساطة معلولاتها، فينعزل عن غيرها وعن معلولات غيرها، وهو يؤدّي إلى فساد هذا النظام.
423 ـ قوله «على أنّه لو فُرض...»
هذا بيان آخر لإثبات التوحيد في الربوبيّة، ويبتني على ثلاث مقدّمات: هي أنّ تعدُّد الآلهة يقتضي تميّز كلّ واحد منها بكمال وجوديّ خاصّ به، وأنّ اختصاص كلّ منها بخاصّة وجوديّة يؤدّي إلى اختلاف في أفعالها لضرورة المسانخة بين العلّة والمعلول، وأنّ ذلك يوجب عدم تلاؤم أجزاء العالم بل تدافعَها وفسادَها.
ويلاحظ عليه أنّه إن اُريد بتميّز كلّ واحد من الآلهة المفروضين بكمال وجوديّ خاصّ ما يوجب اختلاف سنخ الكمال فيها فالمقدّمة الاُولى ممنوعة، لأنّه يكفي في حصول التميّز اختلافُها في التشخّص من غير اختلاف في السنخ والنوع، وإن اُريد به ما يشمل اختلاف الأشخاص مع وحدة نوع الكمال فالمقدّمة الثانية ممنوعة، لجواز أن يكونوا جميعاً من سنخ واحد، فلا تتدافع أفعالها.
ويمكن الدفاع عنه بأنّ الكلام في تعدّد موجودَين مجرّدَين، وقد مرّ في آخر المرحلة الخامسة أنّ كلَّ مجرّد ينحصر في فرد واحد، ففرض تعدّد الآلهة إنّما يتمشَّى مع فرض الاختلاف النوعي بينها لكن قد عرفت المناقشة فيه تحت الرقم (108) ولو كان ذلك أصلاً محقّقاً لكان الأولى الاستنادَ إليه رأساً في إثبات التوحيد، فتأمّل.
وتمكن المناقشة في المقدّمة الثالثة أيضاً بأنّ التدافع إنّما يتصوّر في ما إذا قام الجميع بتدبير شيء واحد، وأمّا إذا استقلّ كلُّ منها بتدبير جزء خاصّ من العالم فلا يحصل تدافع. نعم، هذا الفرض لا يلائم ارتباط أجزاء العالم وتلازمها، فلتُؤخذ المقدّمة الاُولى من مقدّمات البرهان السابق كمقدّمة رابعة في هذه الحجّة.
424 ـ قوله «فإن قيل...»
حاصل هذا الإشكال أنّ التدافع في التدبير إنّما يلزم إذا لم يتوافقوا على مخطّط واحد، لكنّ الحكمة تقتضي التوافق على ما يصلح لبقاء العالم، فما المانع من أن تكون هناك آلهة متوافقون على النظام الجاري في العالم بقيام كلّ واحد منهم بتدبير جزء منه؟
وقد يجاب عنه بأنّ هذا لا يلائم وجوبهم بالذات، لأنّ الواجب بالذات واجب من جميع الجهات، فلا يصحّ فرض تعطيل بعض أفعاله لأجل الآخرين.
وللمستشكل أن يقول: لا نفرض وجوب الأرباب بالذات، بل نفرض أنّهم مخلوقون للواجب بالذات، لكن يخلق كلُّ واحد منهم جزءاً من العالم ويقوم بتدبيره، إلاّ أنّه تتلاءم تلك الأفعال بحيث يحصل منها هذا النظام. وخلقهم على هذا النمط هو مقتضى حكمة الواجب بالذات.
لكن مآل ذلك إلى أنّهم لا يكونون أرباباً مستقلّين في أفعالهم، وإنّما هم وسائط في الإيجاد ومدبّرون للعالم من قِبل الواجب بالذات وعلى ما أعطاهم من العلم والقدرة لذلك، وتسميتهم بالربّ ليس يعني ما يوجب إشراكهم في ربوبيّة الواجب، لعدم استقلالهم في أفعالهم، بل هم المدبّرون بإذنه. ولا سبيل إلى نفي مثل هؤلاء المدبّرين، بل هناك ما يدلّ على وجودهم من النصوص الدينيّة، مثل ما يدلّ على وجود ملائكة موكّلين بالتصوير والتدبير وتقسيم الأرزاق وتوفّي النفوس إلى غير ذلك. والذي يوجب الشرك هو القول باستقلالهم في هذه الأفعال وعدمِ استنادهم إلى إذن الله تكويناً كما يقول المشركون، سبحانه وتعالى عمّا يصفون.
وأمّا ما أجاب به الاُستاذ(قدسسره) فحاصله أنّ وجود هؤلاء الأرباب المفروضين إمّا أن يكون مجرّداً تامّاً فيلزم أن يكون علمهم حضوريّاً وفاعليّتهم بالرضا ونحوه لا بالقصد والتروّي، فلا يصحّ فرض تشاورهم وتوافقهم على عمل، ولا الكفّ عمّا
يقتضيه كمالُهم وعلمُهم لأجل التوافق مع الآخرين؛ وإمّا أن يكون وجودهم متعلّقاً بالمادّة ويكون علمهم حصوليّاً فمثل هذا العلم لابدّ وأن ينتهي إلى الموجودات الخارجيّة مباشرةً أو مع الواسطة، ويكون حصوله تابعاً لوجود المعلوم متأخّراً عنه، لا سابقاً عليه مؤثّراً فيه.
الفصل السابع
425 ـ قوله «في أنّ الواجب بالذات لا مشارك له...»
هذا الفصل أيضاً يحاذي ما ذكره صدر المتألّهين، وقد أضاف الاُستاذ(قدسسره) قيد «من حيث المصداق» في عنوان الفصل، لأنّ بعض المفاهيم وإن كان مشتركاً بين الواجب والممكنات كالحياة والعلم والقدرة وغيرها إلاّ أنّ الممكنات تختلف عنه من حيث المصداق، فهذه الصفات مثلاً زائدة على ذوات الممكنات بخلافها في الواجب كما سيأتي البحث عنه، مضافاً إلى أنّ ما للواجب من حقيقة هذه المفاهيم وأشباهها من المفاهيم الوجوديّة هو المرتبة الغير المتناهية في الشدّة والتي لا يخالطها نقص ولا عدم بخلاف الممكنات. فهذا الفصل كأنّه تفصيل لما اُجمل في قوله تعالى «لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ»(1) وإن كان العنوان لا يخلو عن إبهام.
وجدير بالذكر أنّ صدر المتألّهين أكّد في هذا الفصل على نفي أيّ مناسبة بين الواجب والممكنات كالحلول والاتّحاد ونسبة النفس إلى البدن ونحوها ممّا وقع في بعض كلمات الصوفيّة.(2)
1. سورة الشورى، الآية 11.
2. راجع: الأسفار: ج6، ص107ـ109؛ والمبدء والمعاد: ص6466.
الفصل الثامن
426 ـ قوله «في صفات الواجب...»
تنقسم المفاهيم إلي ثبوتيّة وسلبيّة، والمفاهيم الثبوتيّة قد تكون حاكيةً عن الوجودات المكتنفة بالأعدام من حيث إنّها مكتنفة بها بحيث اذا جُرّدتْ عن جهات النقص تبدّلتْ إلى مفاهيم اُخرى كمفهوم الجسم وما يشابهه من المفاهيم الماهويّة، وكمفهوم القوّة والاستعداد وما يضاهيه من المعقولات الثانية. ومثل هذه الصفات والمفاهيم لا تتّصف به ذاته المتعالية، لاستلزامها النقص والمحدوديّة فيه سبحانه. وقد تكون حاكية عن الجهات الوجوديّة مطلقاً سواءً كانت مكتنفة بالأعدام أو لم تكن، فإنّها وإن انتزعتْ لأوّل مرّة عن الوجودات الفاقرة إلاّ أنّه يصحّ تجريدها من الجهات الماهويّة والعدميّة من غير أن تتبدّل إلى مفاهيم اُخرى. وهذه المفاهيم هي التي تشكّل الصفات الثبوتيّة للواجب تعالى كالعلم والقدرة والحياة، بل الجمال والحبّ والبهجة وغيرها،(1) وقد مرّ في الفصل السابق أنّ مصداق هذه المفاهيم في الواجب يختلف عن المصاديق الممكنة.
وأمّا المفهوم السلبيّ فقد يكون سلباً محضاً كمفهوم العدم المطلق، ولا سبيل له إلى ساحة قدسه، وقد يكون سلباً إضافيّاً فالمضاف إليه السلبُ قد يكون أمراً وجوديّاً مشترطاً بحدود عدميّة كالجسم والمكان والزمان فيتّصف الواجب تعالى بسلوبها، لرجوع ذلك إلى سلب الحدود العدميّة، فيؤول إلى الإثبات. وقد يكون المضاف إليه السلبُ أمراً وجوديّاً غير مشترط بحدود عدميّة كسلب العلم (=
1. راجع: المبدأ والمعاد: ص148ـ160؛ وراجع: المباحث المشرقية: ج2، ص494.
الجهل) وسلب القدرة (= العجز) فلا يتّصف الواجب تعالى بمثل هذه السلوب، لاستلزامه سلب كمال وجوديّ عنه وقد تحقّق بطلانه، ولإدّائه إلى التناقض، لاتّصافه بمقابلاتها.
427 ـ قوله «والصفات الثبوتيّة تنقسم...»
ذكر صدر المتألّهين أنّ الصفات الثبوتيّة تنقسم إلى حقيقيّة كالعلم والحياة، وإضافيّة كالخالقيّة والرازقيّة والتقدّم والعلّية.(1) وظاهر كلامه خاصّةً بالنظر إلى ما مثّل به للصفات الإضافيّة أنّ المراد بها هي المفاهيم المنتزعة عن مقايسة الذات إلى شيء آخر ـ وينحصر ذلك الشيء في أفعاله ومخلوقاته ـ فتنطبق على الصفات الفعليّة. وأمّا جعل العالميّة والقادريّة إضافيّة وجعل الخالق والرازق حقيقيّة ذات إضافة فيمكن توجيهه بأنّ المراد بالعالميّة والقادريّة نفس الإضافة، وبالخالق والرازق هو المضاف. لكن لا أرى فائدة في هذا التقسيم، فليتأمّل.
الفصل التاسع
428 ـ قوله «فالذات نائبةٌ منابَ الصفات»
المراد أنّ خصوصيّات أفعالنا الكماليّةَ مستندةٌ إلى صفاتنا التي هي غير ذواتنا، وهذه الخصوصيّات الكماليّة موجودة في أفعال الواجب تعالى بنحو أتمَّ، من غير وجود صفات له، بل يكون ذاته بحيث تصدر عنها الأفعال الحكيمة من غير حاجة إلى صفات توجبها، فالذات نائبة عن الصفات.
1. راجع: الأسفار: ج6، ص118ـ119.
وهذا القول أقرب الأقوال إلى قول الحكماء وربما يتمسّك لتأييده بكلام مولانا أميرالمؤمنين(علیهالسلام) «وكمال توحيده نفي الصفات عنه» وقد تصدّى صدر المتألّهين لتفسير هذا الكلام بما ينطبق على القول الحقّ.(1)
429 ـ قوله «وبهذا يبطل...»
ويرد عليه أيضاً أنّ نفي أحد المتقابلين هو في قوّة إثبات الآخر إذا لم يكن واسطة بينهما، فلا معنى لنفي الجهل والعجز مع عدم إثبات العلم والقدرة، ويؤدّي ذلك إلى التناقض. مضافاً إلى أنّ هذه المفاهيم العدميّة إنّما تحصل من إضافة العدم إلى ملكاتها، فما لم تتصوّر تلك الملكات لم تنتزع هذه المفاهيم، وما لم تثبت تلك الملكات للموضوع لم يصحّ سلب أعدامها عنه.
الفصل العاشر
430 ـ قوله «في الصفات الفعليّة...»
الصفات الفعليّة هي المفاهيم التي تنتزع من إضافة الذات إلى أفعالها. وتلك المفاهيم تكون ذات طرفين: يقع أحدهما على الواجب، والآخر على مخلوقاته، كالخالق والرازق وغيرهما، فلا تحكي عن حقائقَ عينيّةٍ زائدةٍ على الوجود الوجوبيّ وما هو طرف له من الوجودات الإمكانيّة، ولا تعني إلاّ انتساب وجود المعلول إلى وجود العلّة باعتبار خاصّ. فإذا لاحظْنا وجوداً إمكانيّاً غير مسبوق بمادّة ولا مثالٍ سابقٍ انتزعنا مفهوم الإبداع، وإذا لاحظْنا وجوداً إمكانيّاً يحتاج إليه موجود آخرُ في بقائه واستكماله انتزعنا مفهوم الرزق، وهكذا. وليس في حاق
1. نفس المصدر: ص136ـ145.
الأعيان إلاّ وجود الواجب ووجود مخلوقاته، وقد مرّ مراراً أنّ الإضافة ليست من الحقائق العينيّة، فتذكّر.
وليست هذه الصفات الإضافيّة عين ذات الواجب، ولا عين ذوات المخلوقات، ولا منتزعةً عن أحد الطرفين بعينه، لتوقّف انتزاعها على لحاظ الطرفين.
وإذا كان المخلوق حادثاً زمانيّاً ومحدوداً بقيود وضعيّة وغيرها كان لهذه المفاهيم اعتباران: اعتبارُ انتسابها إلى الواجب، فلا تتّصف من هذه الحيثيّة بالحدوث وغيره من الصفات الإمكانيّة، واعتبارُ انتسابها إلى الحوادث المحدودة، فتتّصف من هذه الحيثيّة بالحدوث والحدود. لكنّ الإضافة بما أنّها أمر قائم بالطرفين كانت تابعة لأخسّهما.
فإذا قيل: خلق الله هذا الحادث في هذا الزمان، فليس معناه أنّ الخلق من حيث تعلّقه بالواجب تعالى واقع في وعاء الزمان بحيث يحتاج إلى تصوّر زمان في الصقع الربوبيّ، بل إنّما زمانيّته تكون باعتبار تعلّقه بالمخلوق الحادث. وبعبارة اُخرى: لا يكون الفعل والإيجاد بالمعنى المصدريّ المنسوب إلى الفاعل واقعاً في ظرف الزمان والمكان مثلاً، بل الذي يقع في مثل هذه الظروف هو حاصل الفعل وبمعنى اسم المصدر ومن حيث الانتساب إليه، وهو نفس الوجود الإمكانيّ. وبهذا يفسّر ما يدلّ على قيودٍ لفعل الواجب تعالى، فتبصّر.
الفصل الحادي عشر
431 ـ قوله «في علمه تعالى»
هذه المسألة هي من أغمض المسائل الحكميّة. وقد بذل كبار الفلاسفة والمتكلّمين جهوداً وافرةً لتبيينها، وعقدوا مسائلَ كثيرةً في باب العلم تمهيداً لحلّها، كالعقل
الإجماليّ، والعلم الكلّي الحاصل من الأسباب قبل تحقّق مسبّباتها، وغيرهما ممّا ركّز عليه الشيخ في كتبه، ويكفيك نموذجاً جليّاً لهذه الجهود ما ترى في كتاب التعليقات، حيث عالج هذه المسألة مرّةً بعد اُخرى، ممّا يشكّل قسماً كبيراً من هذا الكتاب.(1) ولهم أقوال عديدة، ومباحثات طويلة، ومناقشات عنيفة، تعرّض لبعضها صدر المتألّهين،(2) وتصدّى للمحاكمة بينها، وقد مهّد نفسه مقدّمات(3) لتوضيح ما اختاره من العلم الإجماليّ في عين الكشف التفصيليّ، ممّا يُعدّ أروعَ منتوجٍ للتفكير الفلسفيّ، وأبدعَ منسوجٍ للعقل البشريّ، وإن كانت حقيقة المقصود أرفعَ ممّا يحلّق إليه طائر الذهن الإنسانيّ، «وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ».
432 ـ قوله «وأمّا المادّية فبصورها المجرّدة»
قال صدر المتألّهين: «أكثر الأقوام ذاهلون عمّا حقّقناه من أن لا حضور لهذه المادّيات والظلمات عند أحد، ولا انكشاف لها عند مبادئها إلاّ بوسيلة أنوار علميّة متّصلة بها هي بالحقيقة تمام ماهيّاتها الموجودة بها».(4)
وقال المحقّق السبزواريّ في تعليقته على الأسفار: «وإن سألت عن الحقّ فأقول: عدم كون هذه المادّيات والظلمات أنواراً علميّة إنّما هي بالنسبة إلينا، وأمّا بالنسبة إلى المبادئ العالية ـ وخصوصاً بالنسبة إلى مبدء المبادئ ـ فهي علوم حضوريّة فعليّة ومعلومات بالذات، وإن لم تكن هذه المرتبة من العلم في مرتبة العلم العنائيّ الذاتيّ. فحصولها للمادّة ينافي العلم فينا، إذ لسنا محيطين فلسنا مدركين نالين لها،
1. راجع: التعليقات: ص13ـ15 و 24ـ29 و 48 و 60 و 6566 و 78 و 81 و 97 و 102 و 103 و 116 و 118 و 119ـ126 و 149 و 152ـ156 و 158ـ159 و 191ـ193.
2. راجع: الأسفار: ج6، ص169ـ289.
3. راجع: نفس المصدر: ص149ـ168؛ والمبدء والمعاد: ص76ـ123.
4. راجع: الأسفار: ج6، ص164.
وأمّا بالنسبة إلى المحيط بالمادّة وما فيها فحضورها للمادّة حضور له، إذ لم يشذّ المادّة عن حيطته، بل حضورها له بنحو أشدَّ، لأنّ لها حضوراً للفاعل بالوجوب، لأنّ نسبة المعلول إلى فاعله بالوجوب ـ إلخ ـ ».(1)
وقد مرّ ما يتعلّق بهذا الموضوع تحت الرقم (353 و 385).
433 ـ قوله «ويتفرّع على ذلك...»
وهذه العلوم على مراتبها متوسّطةٌ بين العلم الذاتيّ الذي هو عين ذاته المقدّسة والعلم الذي هو عين ذوات المادّيات، كما ذهب إليه المحقّق السبزواريّ وسبقه إليه شيخ الإشراق وقد مرّ تأييده. وتُسمَّى علوماً فعليّة باصطلاحين: أحدهما بمعنى كونها عللاً لوجود ما دونها، وثانيهما بمعنى كونها في مقام الفعل دون مقام الذات، كما أنّ العلم في مرتبة الحوادث يُسمَّى علماً فعليّاً بالمعنى الثاني فقط.
ولْيُعلْم أنّ كون المجرّدات علوماً للواجب كما ربما يظهر من بعض النصوص كقوله تعالى «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ... وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي کِتَابٍ مُبِينٍ»،(2) وقوله تعالى: «قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي کِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى»(3) وكذا كون الحوادث علوماً للواجب كما ربما يؤيّده ما يدلّ على العلوم الحادثة له سبحانه، كقوله: «لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ»،(4) وقوله «وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْکُمْ وَ الصَّابِرِينَ»،(5) وقوله: «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيکُمْ ضَعْفاً»(6) إلى غير
1. راجع: نفس المصدر: ذيل الصفحة 165.
2. سورة الأنعام، الآية 59.
3. سورة طه، الآية 52.
4. سورة الجنّ، الآية 28.
5. سورة محمّد (ص)، الآية 31.
6. سورة الأنفال، الآية 66.
ذلك، أقول: كون هذه كلّها علوماً للواجب لا يعني أنّها تزيد في علمه شيئاً، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً، بل إنّما هي أظلال لعلمه الذاتيّ، واتّصافه بها إنّما هو من قبيل اتّصافه بالصفات الفعليّة التي مرّ شرحها تحت الرقم: (430).
434 ـ قوله «ويتفرّع أيضاً...»
الظاهر أنّ السميع والبصير بمفهوميهما ليسا من الصفات الذاتيّة، فإنّ مفهوم السمع غير مفهوم العلم بالمسموع ممّا يصدق قبل وجود المسموع، وكذا الإبصار، فهما من الصفات الفعليّة التي تنتزع عند وجود صوت يُسمع ولون يُبصَر، كقوله تعالى: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُکَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَکِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ»(1) وقوله تعالى: «إِنَّنِي مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى»(2) إلى غير ذلك. وليس في النصوص ما يدلّ على كونهما من الصفات الذاتيّة، ولو وجد ما ظاهره ذلك أمكن إرجاعه إلى العلم، بل كان الأولى إرجاعه إلى القدرة، كما أنّ ما يدلّ على كونه تعالى خالقاً قبل أن يَخلق يفسَّر بقدرته على الخلق. على أنّ إرجاعهما إلى العلم أو القدرة لا يعني إثبات صفتين اُخريين في مقام الذات، بل معناه أنّ العلم يسمّى سمعاً باعتبار تعلّقه بنوع خاصّ من المعلومات، وإبصاراً باعتبار تعلّقه بنوع آخر، أو يعتبر من حيث قدرته على خلق المسموعات والمبصرات حاضرةً عنده معلومةً له سميعاً بصيراً بمعنى القادر على السمع والإبصار.
435 ـ قوله «وفيه أوّلاً أنّ قوله بحضور المادّيات...»
بل ينبغي أن يعتبر هذا نقطةَ قوّةٍ في قوله، فراجع الرقم (353 و 385 و 432).
1. الآية الأولى من سورة المجادلة.
2. سورة طه، الآية 46.
436 ـ قوله «العاشر ما نسب إلى الصوفيّة...»
قال صدر المتألّهين: «وأمّا ما نقل عن هؤلاء الأعلام من الصوفيّة فيرد على ظاهره ما يرد على مذهب المعتزلة، فإنّ ثبوت المعدوم مجرّداً عن الوجود أمر واضح الفساد، سواء نُسب إلى الأعيان أو إلى الأذهان ـ إلى أن قال ـ مع أنّ ظواهر أقوالهم بحسب النظر الجليل ليست في السخافة والبطلان ونُبوّ العقل عنها بأقلَّ من كلام المعتزلة فيهما».(1) لكنّه قام بتأويل كلامهم إلى ما ينطبق على مذهبه.(2)
الفصل الثاني عشر
437 ـ قوله «أمّا العناية...»
أصل هذا الاصطلاح هو لأتباع المشّائين، حيث اعتبروا فاعليّة الواجب تعالى بالعناية، يَعنونَ أنّ نفس علمه كافٍ في صدور أفعاله عنه بلا حاجة إلى قصد وداع زائدين على ذاته. لكنّهم لمّا كانوا يعتبرون علمه بما سواه حصوليّاً، وكان هذا المذهب في علمه غيرَ مرضيّ عند الإشراقيّين أنكر صاحب الإشراق العناية بهذا المعنى، وقال: «وأمّا العناية فلا حاصل لها، وأمّا النظام فلزم من عجيب الترتيب والنسب اللازمة عن المفارقات وأضوائها المنعكسة كما مضى. وهذه العناية ممّا كانوا يُبطلون بها قواعد أصحاب الحقائق النوريّة ذوات الطلسمات، وهي في نفسها غير صحيحة».(3)
وقال صدر المتألّهين: «وأمّا العناية فقد أنكرها أتباع الإشراقيّين، وأثبتها أتباع
1. راجع: الأسفار: ج6، ص182ـ183.
2. نفس المصدر: ص280ـ289.
3. راجع: حكمة الإشراق: ص153.
المشّائين كالشيخ الرئيس ومن يحذوحذوه، لكنّها عندهم صور زائدة على ذاته على وجه العروض، وقد علمت ما فيه».
ثمّ قام بتفسير لها بحيث ينطبق على مذهبه في علم الواجب تعالى، فقال: «والحقّ أنّها عِلمُه بالأشياء في مرتبة ذاته علماً مقدّساً عن شوب الإمكان والتركيب، فهي عبارة عن وجوده بحيث تنكشف له الموجودات الواقعة في عالم الإمكان على نظام أتمَّ، مؤدّياً إلى وجودها في الخارج مطابقاً له، أتمَّ تأديةٍ لا على وجه القصد والرويّة. وهي علم بسيط واجب لذاته، قائم بذاته، خلاّق للعلوم التفصيليّة العقليّة والنفسيّة، على أنّها عنه لا على أنّها فيه».(1) وستأتي تتمة الكلام في الفصل السادس عشر.
438 ـ قوله «وأمّا القضاء...»
كأنّ الأصل في معنى القضاء هو الإتمام، قال تعالى حكاية عن قول موسى لشعيب(علیهماالسلام) «أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ»،(2) ثمّ اعتبُر إتمامُ القاضي للمشاجرة وفيصلتُه للمخاصمة قضاءاً. والقضاء الالهيّ هو إتمام مراحل تحقّق الفعل. قال سبحانه: «إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ».(3) وهذا الإتمام قد يكون باعتبار الوجود العينّي، فيسمّى قضاءاً عينياً،(4) وينطبق على مرحلة الإيجاب التي يعتبرها العقل قبل تحقّق الوجود الإمكانيّ، حيث يَعتبر الممكنَ محتاجاً إلى العّلة، فتوجبه، فتجب، فتوجده، فتوجَد. وينطبق الإيجادُ على قوله «كن» ووجودُه على قوله: «فيكون». وقد يكون باعتبار الوجود العلميّ، فينطبق
1. راجع: الأسفار: ج6، ص291؛ والمبدء والمعاد: ص124.
2. سورة القصص، الآية 28.
3. سورة آل عمران، الآية 47.
4. راجع: القبسات: ص420421؛ والأسفار: ج2، ص50.
على علم الواجب تعالى بوقوع الشيء على ما هو عليه في ظرف وجوده، وقوعاً واجباً بإيجاب علّته التامّة. وقد مرّ أنّ لعلمه سبحانه مراتبَ منها ما ينطبق على الوسائط النوريّة التي يُسمَّى بعضها بالكتاب المبين والكتاب المكنون وأمّ الكتاب واللوح المحفوظ. فثبوت الحوادث في ذلك الوعاء الرفيع ثبوتاً علميّاً مطابقاً لما يوجد في الخارج يصحّ اعتباره قضاءاً علميّاً إلهيّاً سابقاً على الأشياء.(1)
فالقضاء بهذا المعنى ينتزع عن مقام الفعل، أي مقام وجود المفارقات، كما أنّ القضاء بالمعنى العينيّ أيضاً ينتزع عن مقام الفعل، أي مقام وجود الكائنات. وأمّا إرجاع القضاء إلى العلم الذاتيّ فإنّه وإن كان في حدّ نفسه معنى صحيحاً إلاّ أنّه لا ينطبق على ما ورد في الكتاب والسنّة، فلا موجب له فضلاً عن القول بحصر القضاء فيه،(2) فتدبّر.
وجدير بالذكر أنّه نسب القضاء إليه سبحانه في كتابه العزيز بوجوه اُخرى لا صلةَ لها بهذا المبحث كالقضاء بين العباد يوم القيامة، كما في قوله تعالى: «إِنَّ رَبَّکَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا کَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»(3) وكالقضاء التشريعىّ والحكم الإلزاميّ المؤكّد، كما في قوله تعالى: «وَقَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً».(4) وقد يُضمَّن معنى الوحي ونحوه، كما في قوله تعالى: «وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْکِتَابِ»،(5) إلى غير ذلك.
1. راجع: الفصل الأوّل من المقالة العاشرة من إلهيّات الشفاء؛ وراجع: الفصل الخامس عشر من الفنّ الثالث من طبيعيّات الشفاء؛ وراجع: النمط السابع من الإشارات؛ وراجع: المبدء والمعاد: لصدر المتألّهين، ص125.
2. راجع: الأسفار: ج6، ص292.
3. سورة يونس، الآية 93.
4. سورة الإسراء، الآية 23.
5. سورة الإسراء، الآية 4.
439 ـ قوله «ومن هنا يظهر ضعف...»
يعني ضعف كلّ من القولين لأجل حصره القضاء في أحد قسميه. وقد عرفت أنّ القول المشهور هو الأوفق بظواهر الكتاب والسنّة.
440 ـ قوله «وأمّا القدر...»
القدر ـ بإسكان الدال وفتحها ـ هو مبلغ الشيء وحدُّه، ويستعملان كمصدرين بمعنى قياس الحدّ وتعيينه، كالتقدير. فالقدر أيضاً على نوعين: قدر عينيّ هو تحدُّد الشيء بحدود خاصّة لأجل ما يوجبها من العلل والأسباب، وقدر علميّ هو تحدّده في ظرف العلم، ولهذا يعتبر سابقاً على وجوده.
وأمّا الفرق بين القضاء والقدر فقد قال السيّد الداماد بشأنه: «القضاء نسبة فاعليّة البارئ الحقّ سبحانه على حسب علمه وعنايته إلى الإنسان الكبير في مرتبة شخصيّته الوحدانيّة الجُمليّة، والقدر نسبة فاعليّته سبحانه إلى هذا الإنسان الكبير في مرتبة تشريح أعضائه وأجزائه، وتفصيل أخلاطه وأركانه وأرواحه وقواه، بحسب تأدية الأسباب المترتّبة المتأدّية إلى خصوصيّات تفاصيلها».(1)
وقال صدر المتألّهين بعد تفسير القضاء بصورة علم الله تعالى القديمة بالذات: «وأمّا القدر فهو عبارة عن وجود صور الموجودات في العالم النفسيّ السماويّ على الوجه الجزئيّ، مطابقةً لما في موادّها الخارجيّة الشخصيّة، مستندةً إلى أسبابها وعللها، واجبةً بها، لازمةً لأوقاتها المعيّنة وأمكنتها المخصوصة، ويشملها القضاء شمولَ العناية للقضاء».(2)
ويظهر من كلام سيّدنا الاُستاذ(قدسسره) أنّ القضاء هو العلم بالنسبة الوجوبية للشيء
1. راجع: القبسات: ص418 و 416 و 421423.
2. راجع: الأسفار: ج6، ص292ـ293.
إلى فاعله التامّ، والقدر هو العلم بنسبته الإمكانيّة إلى السبب الناقص، وقد صرّح به في موارد اُخرى. ويتفرّع عليه أنّ القضاء لا يتغيّر بخلاف القدر، كما هو مقتضى نسبة القضاء إلى اللوح المحفوظ، ونسبة القدر إلى لوح المحو والإثبات. ولا ريب أنّ التغيّر إنّما يتصوّر في المادّيات، وهذا يوجب اختصاص القدر بها، بخلاف القضاء حيث عمّموه إلى المجرّدات أيضاً. وجدير بالذكر أنّ القضاء والقدر قد يستعملان كمترادفين، ويعتبران نوعين: حتميّ، وغير حتميّ. فما ورد من إمكان التغيّر في القضاء الإلهيّ يحمل على هذا المعنى.
441 ـ قوله «وغرضهم من عقد هذا البحث...»
كثيراً ما ينقدح سؤال بشأن القضاء والقدر، هو أنّه ما هو السرّ في طرح هذه المسألة والتأكيد على ثبوتهما ولزوم الاعتقاد بهما مع ما تثور حولها من شبهات؟ ومن جهة اُخرىفقد ورد النهي عن الخوض فيهامن أئمّةالدين(علیهمالسلام) ووصفوهاببحرعميق لا يأمن من ولجه، وطريق وَعِرٍ لا يسلم من سلكه، وسرّ الله الذي لا ينبغي تكلّف كشفه!
والجواب أنّ معرفة التوحيد الأفعاليّ هي من أشرف المعارف وأنفعها وأعزّها، ولفهمه الصحيح والاعتقاد به تأثير بالغ في كمال الإيمان وقيمة العمل ممّا يؤدّي إلى رقيّ الروح والوصول إلى السعادة المنشودة. والمعارف التي اُشير إليها في الكتاب والسنّة من إناطة جميع الحوادث وحتّى الأفعال الاختياريّة بإذن الله تعالى ومشيّته وإرادته وقدره وقضائه هي في الواقع تعاليم متدرّجة للهداية إلى التوحيد الأفعاليّ، وفوقه التوحيد الصفاتيّ والذاتيّ بالمعنى الدقيق الذي لا يتيسّر نيله لكلّ أحد. وأمّا النهي عن خوض هذه اللجج فإنّما هو لرعاية الضعفاء لئلاّ يقعوا في ورطات الجبر والاستخذاء والكسل واللامبالاة، بل الكفر والإلحاد ممّا هو قرّة عيون شياطين الإنس والجنّ، أعاذنا الله تعالى.
الفصل الثالث عشر
442 ـ قوله «في قدرته تعالى»
قد مرّ في خاتمة المرحلة التاسعة أنّ القوّة أعمَّ مورداً من القدرة، فالقوّة تُستعمل في مورد الفعل وفي مورد الانفعال معاً بخلاف القدرة فإنّها تختصّ بالفعل. ثمّ القوّة الفعليّة أعمُّ مورداً من القدرة أيضاً لشمولها للقوى الطبيعيّة وغيرها بخلاف القدرة حيث تختصّ بمبدئيّة الفاعل الحيّ، ويشترط فيها كون الفاعل عالماً بفعله علماً مؤثّراً في صدور فعله عنه. ولمّا كان فعل كلّ نوع من الفواعل إنّما يمتاز بأنّه كمال مسانخ لذلك النوع فالفاعل العلميّ إنّما يفعل فعله إذا علم بما هو كمال وخير له بما أنّه فاعل لذلك الفعل فيختاره. ومثل هذه المبدئيّة للفعل يسمّى قدرة.
ثمّ إنّ للقدرة مصاديقَ مختلفةً حسب اختلاف مراتب الفواعل في الوجود، فإذا كانت لبعض مصاديقها لوازمُ وتوابعُ تلحق الفاعلَ لأجل ما تقتضيه نوعيّتُه فليس يعني ذلك وجوبَ مثل هذه اللواحق في جميع المصاديق. فإنّ لذوي النفوس المتعلّقة بالمادّة خصائصَ لا توجد في غيرها من الفواعل ذوي القدرة، لأنّ تلك الخصائص إنّما تلزم لضعف مرتبة وجودها، وليست من شأن ما هو أقوى وجوداً منها. وذلك كما في الإنسان مثلاً، حيث يتوقّف فعله الاختياريّ على التصوّر والتصديق والشوق والإرادة. فهذه المبادئ إنّما تتحقّق فيه لأجل كونه ذا نفس متعلّقة بالمادّة، وأمّا المجرّد التامّ فعلمه حضوريّ وليس من قبيل التصوّر والتصديق، كما أنّه منزّه عن الكيف النفسانيّ والشوق إلى ما يفقده.
والحاصل أنّ حقيقة القدرة هي المبدئيّة للفعل الملازمة للعلم والاختيار، وهي متحقّقة في الواجب تعالى على ما يليق بساحة قدسه، فعلمه ليس أمراً زائداً على ذاته كما سبق تحقيقه، كما أنّ اختياره ليس بحدوث إرادة في ذاته سبحانه.
وههنا تلتقي مسألة القدرة ومسألة الإرادة، وتُثار تساؤلات حول إرادة الواجب واختياره، مثل أنّه إذا لم يكن اختياره بحدوث الإرادة في ذاته فما هي حقيقة اختياره؟ وهل له إرادة غير الكيفيّة العارضة للذات؟ وعلى فرض الثبوت فهل هي عين ذاته أو أمر خارج عن الذات؟
وقد اختلفت كلمات المتكلّمين والفلاسفة في الإجابة على هذه الأسئلة،(1) كقول الأشاعرة بالإرادة القديمة الملازمة للذات، وقول المعتزلة بحدوث الإرادة له وتجدّدها، وقول الفلاسفة برجوع إرادته الذاتيّة إلى العلم بالنظام الأصلح، إلي غير ذلك ممّا أدّى إلى مشاجرات عنيفة، واتّهامات قاسية. فالمتكلّمون اتّهموا الفلاسفة بإنكار اختيار الواجب وإيجابه في أفعاله سبحانه،(2) والفلاسفة اتّهموهم بالتجسيم والتشبيه ونسبة صفات الممكنات والمادّيات إليه تعالى. فلْنلبث في هذا الموقف يسيراً، لعلّنا نجد في ما آنسْنا من الحقّ تيسيراً، ونحصل في المسألة على ما هو أحسن تفسيراً، ولْنُشِرْ كمقدمّة للكلام إلى نُقاوة ما ذكرنا تحت الرقم (181) في تفسير الإرادة والاختيار:
أمّا الإرادة فقد تستعمل بمعنى الحبّ، وقد تستعمل بمعنى إجماع العزم المسبوق بالعلم والشوق، وهي التي يعبَّر عنها بالقصد، ويختصّ بالفاعل بالقصد الذي مرّ توضيحه في الفصل السابع من المرحلة الثامنة. وقد تستعمل بمعنى طلب الفعل من الغير، وتسمّى بالإرادة التشريعيّة. ولعلّ نكتة الاشتراك بين هذه المعاني هي وجود الحبّ في جميع الموارد، وإن لم يكن الاشتراك معنويّاً.
ثمّ الإرادة بالمعنى الأوّل هي حقيقة وجوديّة تشترك بين الواجب والممكنات
1. راجع: نفس المصدر: ص307ـ368 و 379413؛ وراجع: المباحث المشرقية: ج2، ص485-493؛ والقبسات: ص311ـ313.
2. راجع: القبسات: ص444-447؛ وراجع: التعليقات: ص5054 و 6162 و 71ـ72.
على اختلاف مراتبها كالعلم والقدرة وغيرهما، ويكون ما يوجد منها في ذوي النفوس ذا مهيّة من قبيل الكيف النفسانيّ، بل يصحّ اعتبار بعض مصاديقه جوهراً، فإنّ حبّ النفس كالعلم بالنفس هو عين ذاتها، كما أنّ حبّ المفارقات هو عين جواهرها، وحبّ الواجب تعالى لذاته المستتبع لحبّ آثاره من حيث خيريّتها هو عين ذاته المقدّسة. وأمّا بالمعنى الثاني فالمشهور أنّها من أنواع الكيف النفسانىّ، لكن لا يبعد كونها فعلاً نفسانيّاً، فيكون قيامها بالنفس قياماً صدوريّاً، وفاعليّة النفس لها بالتجلّي. وأمّا بالمعنى الثالث فهو خارج عن محلّ البحث.
وأمّا الاختيار فقد يستعمل مرادفاً للإرادة بالمعنى الثاني، وقد يستعمل بمعنى أخصَّ وهو انتخاب أحد أمرين مطلوبين في حدّ أنفسهما على الآخر، ويختصّ بما إذا كان للفاعل مطلوبان أو مطلوبات متزاحمة، كما في الإنسان الذي يتردّد أمره بين إشباع نفسه وإشباع ولده، وبين إرضاء نفسه بمعصية ربّه وإرضاء ربّه بمخالفة هواه. وقد يستعمل في مقابل الإكراه، فيختصّ بما إذا كان انتخاب الفاعل للفعل من قِبل نفسه من دون إكراه وتهديد من الغير. وقد يستعمل في مقابل الاضطرار الذي ربما يتّفق للإنسان مثلاً حينما ينحصر حفظ نفسه في طريق غير مرضيّ كأكل الميتة لإبقاء الحياة. وقد يستعمل في مقابل الإجبار الذي يحصل من ضغط العامل الخارجيّ بحيث لا يُبقي له مجالاً للانتخاب مطلقاً. وهذا المعنى يتحقّق في الفاعل بالقصد وبالعناية وبالرضا وبالتجلّي، لأنّ أفعال هذه الفواعل إنّما تتعيّن من قِبل أنفسهم وتنتشيء من حبّهم ورضاهم أو قصدهم وعنايتهم، لا من تحميل وإجبار من الغير. وبعد اتّضاح هذه المقدّمة نقول:
لا ريب في ثبوت الاختيار للواجب تعالى بالمعنى الأخير، سواء قلنا بأنّ فاعليّته هي بالتجلّي أو بالرضا أو بالعناية. وحتّى لو صحّ القول بكون فاعليّته بالقصد كان معناه ثبوت الاختيار له. لكنّ الحقّ أنّه فاعل بالتجلّي، وهو الذي يكون فعله عن
حبّه لذاته وعلمه التفصيليّ في مقام ذاته ويكون فعله قائماً به كربط محض لا استقلال له مطلقاً. والحاصل أنّه لا يفرض هناك ما يورد ضغطاً على الواجب ليقوم بالفعل، حتّى أنّه ليس في ذاته تعدّد جهات وحيثيّات وقوى متزاحمة في التأثير. فهذا أتمُّ مراتب الاختيار وأكملها وأشرفها، ويليه اختيار المفارقات المحضة، ثمّ اختيار النفوس، وهو أضعف مراتب الاختيار.
ثمّ ما كان من أفعال ذوي النفوس من قبيل التجلّي أو شبيهاً به كالإرادة كان أتمَّها في الاختياريّة ـ بالعكس ممّا ربما يتوهّم أنّ الإرادة إذا لم تكن مسبوقة بإرادة اُخرى كانت جبريّة ـ ويليه ما كان من قبيل الفعل بالرضا كالتصوّرات الذهنيّة، ويليه ما كان بالقصد كأفعال الجوارح، وهي أضعفها في الاختياريّة، لتوقّفها على اُمور غير اختياريّة كثيرة.
وأمّا الاختيار في مقابل الإكراه والاضطرار ونحوهما فهو أيضاً صادق في الواجب تعالى لاستحالة انفعاله من غيره إطلاقاً. وأمّا الاختيار بالمعنى الأوّل فيتّضح بتوضيح معنى إرادته سبحانه.
أمّا إرادة الواجب سبحانه فإن اُريد بها المعنى الأوّل المرادف للحبّ فهي ثابتة في ذاته تعالى كسائر الصفات الذاتيّة بلا تعدّد جهة وحيثيّة، وقد صرّح بذلك أساطين الحكمة. قال الشيخ: «فالواجب الوجود الذي هو في غاية الكمال والجمال والبهاء الذي يعقل ذاته بتلك الغاية والبهاء والجمال وبتمام التعقّل وبتعقّل العاقل والمعقول على أنّهما واحد بالحقيقة يكون ذاته لذاته أعظمَ عاشق ومعشوق، وأعظمَ لاذّ وملتذّ».(1) وقال أيضاً: «بل هو عالم بكيفيّة نظام الخير في الوجود وأنّه عنه، وعالم بأنّ هذه العالميّة يَفيض عنها الوجود على الترتيب الذي يعقله خيراً ونظاماً، وعاشق ذاته التي هي مبدء كلّ نظام خير من حيث هو كذلك، فيصير نظام
1. راجع: أواخر المقالة الثامنة من إلهيّات الشفاء؛ والنجاة: ص245.
الخير معشوقاً له بالعرض، لكنّه لا يتحرّك إلى ذلك عن شوق، فإنّه لا ينفعل منه البتّة، ولا يشتاق شيئاً ولا يطلبه. فهذه إرادته الخالية عن نقص يجلبه شوق وإزعاج، قصداً إلى غرض».(1)
وقال صدر المتألّهين: «الإرادة والمحبّة معنى واحد كالعلم، وهي في الواجب تعالى عين ذاته، وهي بعينها عين الداعي، وفي غيره ربما تكون صفة زائدة عليه وتكون غيرَ القدرة وغيرَ الداعي كما في الإنسان ـ إلى أن قال ـ فهذه الثلاثة ـ أعني القدرة والإرادة والداعي ـ متعدّدة في الإنسان بالقياس إلى بعض أفعاله، متّحدة في حقّ البارئ سبحانه، وكلّها فيه عين الذات الأحديّة، وفي الإنسان صفات زائدة عليه».(2)
وأمّا الإرادة بمعنى إجماع العزم فإن قيل بأنّها كيفيّة فلا يمكن فرضها في ذات الواجب تبارك وتعالى، لما يترتّب عليه من توالي فاسدة جدّاً، كتركّب الذات وكونه ذا مهيّة، والتغيّر في ذاته المستلزم لكونها مادّيّة ذات قوى واستعدادات، إلى غير ذلك. وإن قيل بأنها فعل صادر من النفس فهي في الحقيقة خارجة عن ذات الفاعل، فاتصافه سبحانه بها يكون من قبيل اتّصافه بالصفات الفعليّة. وعلى هذا المعنى يحمل ما ورد من استناد الإرادة إليه كأمر حادث، كقوله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ».(3)
والحاصل أنّ إسناد الإرادة إلى الواجب يكون على وجهين: أحدهما كصفة ذاتيّة أزليّة، وهي حبّه الذاتيّ لذاته ولآثاره من حيث خيريّتها. ثانيهما كصفة فعليّة حادثة، وهي معنى منتزع عن مقام الفعل، بالنظر إلى أنّ صدوره ليس جبريّاً عن كره، بل له منشأ في ذاته تعالى هو حبّه للخير وعلمه بوجه خيريّته.
1. راجع: الفصل السابع من المقالة الثامنة من إلهيّات الشفاء.
2. راجع: الأسفار: ج6، ص341؛ وراجع: القبسات: ص322ـ323.
3. سورة يس، الآية 82.
وقد تبيّن بذلك أوّلا أنّ الإرادة التي ينفيها الحكماء عن الواجب تعالى هي الكيفيّة الحادثة الحالّة في ذاته. والمشهور عندهم إرجاع الإرادة الذاتيّة إلى العلم بالأصلح، وقد صرّح الشيخ بوحدتهما مفهوماً في مورد الواجب تعالى، حيث قال: «ليست الإرادة مغايرة الذات لعلمه، ولا مغايرة المفهوم لعلمه».(1) ولهذا ناقش فيه سيّدنا الاُستاذ(قدسسره) بأنّه أشبه بالتسمية، والأولى إرجاعها إلى الحبّ، فإنّه أوفق باللغة والعرف، وهو مقتضى كلامه في مواضع اُخرى.(2) وأمّا إسناد المتكلّمين القولَ بكون الواجب فاعلاً موجَباً إلى الفلاسفة فهو لأجل زعمهم إنحصارَ الاختيار في الفاعل بالقصد الذي يكون قصده وإرادته زائداً على ذاته، وقد عرفت أنّ أعلى مراتب الاختيار هو للفاعل بالتجليّ ثم بالرضا ثمّ بالعناية.
وثانيا أنّ استعمال الإرادة في مورد الواجب تبارك وتعالى كصفة فعليّة منتزعةٍ عن مقام الفعل استعمالٌ حقيقيٌّ على حدّ ما للخالق والرازق وغيرهما من الحقيقة. وأمّا إسناد الغضب والأسف ونحوهما إليه سبحانه فله شأن آخر، وفرض مجازيّة هذه الاستعمالات لا يوجب كون جميع الصفات الفعليّة مجازيّة. اللّهمّ إلاّ أن يقال: نفس استعمال هذه اللفظة الموضوعة لكيف نفسانيّ في معنى انتزاعيّ يكون مجازيّاً، لكن لأحدٍ منعُ هذا الوضع الانحصاريّ، فليتأمّل.
وثالثا أنّ استعمال الإرادة كصفة فعليّة لا تنفي صحّة استعمالها كصفة ذاتيّة، ووزان ذلك وزان استعمال الخالق كصفة فعليّة واستعماله بمعنى مبدء الخلق الراجع إلى القدرة الذاتيّة، بل وزان العلم المستعمل على وجهين، كما مرّ تحت الرقم (433).
1. راجع: الفصل السابع من المقالة الثامنة من إلهيّات الشفاء.
2. راجع: التعليقـات: ص157ـ160؛ وراجع: الأسفـار: ج6، ص341 و 351 و 415؛ وراجع: المبـدء والمعـاد، ص135.
الفصل الرابع عشر
443 ـ قوله «وهو المعنْوَنُ عنه بشمول إرادته للأفعال»
الغرض الأصليّ من هذا الفصل هو تبيين نسبة أفعال الإنسان الاختياريّة إلى الواجب تبارك وتعالى، وكيفيّة تعلّق إرادته بها، وحلّ مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين.
ولهذه المسألة أبعاد متعدّدة كالجبر الطبيعيّ والجبر الاجتماعيّ والجبر الفلسفي(1) والجبر الإلهيّ. ثمّ الجبر الإلهيّ يتصوّر على وجهين: أحدهما من جهة علمه تعالى، حيث يُتوهَّم أنّ اختيار الإنسان في فعله ينافي سبق علمه تعالى بما يصدر عنه، لأنّ مقتضى الاختيار كون تعيّن الفعل أو الترك مستنداً إلى إرادة الفاعل، فيلزم أن يكون الفعل بصرف النظر عن إرادته متساوي الطرفين، مع أنّ علمه تعالى قد عيّنه سابقاً، ويمتنع وقوع الفعل على خلافه، لاستلزام ذلك كون علمه تعالى جهلاً!(2) وقد مرّ الكلام فيه تحت الرقم (239) وستأتي الإشارة إليه في آخِر هذا الفصل.
وثانيهما من جهة إرادته تعالى، حيث يُتوهَّم أنّه إذا صحّ شمول إرادته لأفعالنا لزم كونها جبريّة، وإلاّ جاز تخلّف المراد عن إرادته تعالى، وهو محال، لاستلزامه سلب قدرته على إنفاذ إرادته. ولهذا التزم الأشاعرة بالجبر ـ على ما حكي عنهم ـ وذهب المعتزلة إلى خروج أفعالنا الاختياريّة عن نطاق إرادته سبحانه والتزموا بالتفويض، وهو ينافي التوحيد الأفعاليّ. وذهب أصحابنا الإماميّة تبعاً لأئمّتهم(علیهمالسلام) إلى الأمر بين الأمرين، لكن اختلفت كلماتهم في تبيين ذلك.
وكان الفلاسفة قبل صدر المتألّهين يبيّنون ذلك على أساس أنّ الفعل معلول
1. راجع: في ما يتعلّق بالجبر الفلسفيّ الفصل الخامس من المرحلة الرابعة، والفصل الثالث من المرحلة الثامنة.
2. راجع: الأسفار: ج2، ص135ـ136؛ وج6: ص384ـ385.
للإنسان، والإنسان معلول لله تبارك وتعالى، ومعلول المعلول معلول لعلّته، ففعل الإنسان معلول وفعل لله تعالى أيضاً. وبعبارة اُخرى: إرادته تعالى تعلّقت بوجود الإنسان بشؤونه كلّها، ومن تلك الشؤون إرادته واختياره. وإرادة الإنسان تتعلّق بفعله، ففعله متعلّق لإرادة الله سبحانه بوساطة إرادته التي هي من شؤون وجوده. وحيث كانت إحدى الإرادتين في طول الاُخرى لم يمتنع استناد الفعل إليهما، بخلاف ما لو كانتا مجتمعتين في عرض واحد، حيث كان يلزم اجتماع علّتين على معلول واحد شخصيّ.
لكن كان لهذا البيان قصور من جهة أنّ اُصولهم ما كانت تفي بإيضاح علاقة العلّية بحيث يتبيّن عدم استقلال الإنسان في وجوده وفي إرادته، ولهذا كان له ميل إلى مذهب المعتزلة. إلى أن قام صدر المتألّهين بإيضاح تلك العلاقة، وأنّ المعلول ربط محض بعلّته المفيضة لا استقلال له دونها بوجه من الوجوه. فعلى ضوء ذلك وجدت المسألة تبييناً فلسفيّاً متقناً ناضجاً وافياً، وهو من أروع ثمرات الفلسفة الإسلاميّة التي يَنَعَتْ بفضل مساعي هذا الحكيم المتألّه العظيم. وقد أوصى بالتأمّل في أفعال النفس للاستعانة بها على فهم هذا المطلب الشريف.(1)
وجدير بالذكر أنّ نطاق القدرة أوسع من نطاق الإرادة، لأنّ مفهوم القدرة يشمل كلَّ ما أمكن وجوده، لكنّ الإرادة تختصّ بما يوجد فقط بما أنّه خير حقيقيّ أو مظنون. وأفعال الإنسان الاختياريّة وإن لم يكن جميعها خيراتٍ حقيقيّة، إلاّ أنّها من حيث استنادها إلى إرادة الله تعالى توصف بالخيريّة، لأنّها تابعة لوجود الفاعل المختار الذي هو خير في مجموع النظام الأحسن، وسيتضّح ذلك في الفصل الثامن عشر.
1. راجع: نفس المصدر: ج6، ص369ـ379 .
444 ـ قوله «قيام العرض بموضوعه»
نفس كون الإنسان موضوعاً لأعراضه لا يصحّح فاعليّته لها فضلاً عن استنادها إلى إرادته واختياره. والمراد أنّ أفعال الإنسان المباشرة قائمةٌ به كقيام العرض بموضوعة، فلا محالة تستند إليه استنادَ أفعالِ كلّ نوع إلى صورته النوعيّة بالنظر إلى ما مرّ من أنّ الأعراض معلولة لصور موضوعاتها النوعيّة، فافهم.
445 ـ قوله «وأمّا قولهم إنّ كون الأفعال...»
هذا الإشكال يضاهي الإشكال على تعلّق القضاء الإلهيّ بالشرور، بل هو هو نفسه، فيدفع بمثل ما يوجّه به دخول الشرور في القضاء الإلهيّ على ما سيأتي بيانه في الفصل الثامن عشر، وذلك بوجهين: أحدهما أنّ الشرور مقصودة بالتبع لملازمتها للخيرات المقصودة بالأصالة. وأنّما تقصد بالتبع لغلبة جهات الخير عليها، ولو لم تقصد كذلك لزم ترك تلك الخيرات الغالبة. وثانيهما أنّ الشرّ أمر عدميّ، وحيث لا سبيل للعدم إلى دار الوجود فالشرور ترجع إلى جهات النقص في الموجودات. والذي يصدر من الواجب تعالى وتتعلّق به إرادته بالذات هو نظام الوجود الإمكانيّ بما يشتمل على الموجودات الناقصة، وذلك النظام هو أحسن نظام ممكن على ما يأتي بيانه في الفصل السابع عشر فجهات النقص هي مقصودة بالعرض.
446 ـ قوله «وأيضاً قد ظهر ممّا تقدّم...»
حاصلهأنّه على القول بكون الإرادة مرجّحةً للفعلبجعله أولويَّ الحصول دون ضروريّة مع بقاء إمكان عدمه يبقى السؤال عن علّة وقوعه مع جواز العدم، فوجود مثل هذا المرجّح لا يغنيه عن العلّة المعيّنة الموجبة بحيث ينقطع السؤال عن علّة الوقوع.(1)
1. راجع: القبسات: ص314.
وحيث كانت الحاجة إلى المرجّح لأجل تعيين أحد الطرفين المتساويين في حدّ أنفسهما تعييناً حتميّاً ضروريّاً يمتنع معه الطرف الآخر فلو فُرضت الإرادةُ غيرَ معيّنةٍ للفعل ذاك التعيينَ لكان وقوع الفعل صدفةً من غير حاجة إلى المرجّح. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: «وأيضاً الترجيح بالإرادة...» فالوجه الثاني مترتّب على الأوّل، فافهم.
الفصل الخامس عشر
447 ـ قوله «في حياته تعالى»
الحياة على ما يتحصّل من التأمّل في مواردها معنىً يلازم العلم والقدرة،(1) ولهذا ربما يُظْنّ أنّ الحياة هي مجموع العلم والقدرة أو معنى ينتزع منهما، وليس كذلك لجواز الانفكاك بينها وبين كلّ واحد من العلم والقدرة في الذهن بل في الخارج أيضاً في الجملة. قال صدر المتألّهين: «واعلم أنّ حياة كلّ حيّ إنّما هي نحو وجوده، إذ الحياة هي كون الشيء بحيث يصدر عنه الأفعال الصادرة عن الأحياء من آثار العلم والقدرة. لكن من الأشياء الحيّة ما يجب فيه أن يسبق هذا الكونَ كونٌ آخرُ، ومنها ما ليس يجب فيه أن يسبقه كون آخرُ. فالقسم الأوّل كالأجسام الحيّة، فإنّ كونها ذاتَ حياةٍ إنّما يطرأ عليها بعد كونٍ آخرَ له يسبق هذا الكونَ الحيوانيَّ... وأمّا القسم الثاني فهو في ما يخرج عن الأجسام، فإنّ ما ليس بجسم لا يمتنع فيه أن يكون وجوده بعينه هو كونه بالصفة المذكورة... وواجب الوجود أولى بأن يكون حياته عينَ وجوده، لكونه بسيط الحقيقة».(2)
1. راجع: الأسفار: ج6، ص413؛ وراجع: حكمة الإشراق: ص117؛ والتعليقات: ص117.
2. راجع: الأسفار: ج6، ص418.
الفصل السادس عشر
448 ـ قوله «وأمّا الكلام...»
التكلّم عبارة عن إلقاء لفظ دالّ على معنىً بالدلالة الوضعيّة الاعتباريّة لإعلام المخاطب بما في ضمير المتكلّم، وذلك اللفظ يسمّى كلاماً. فقوام هذا المعنى هو بالوضع والاعتبار. وربما يتوسّع فيه فيستعمل في مطلق الإعلام ولو كان بغير اللفظ وبغير الدلالة الوضعيّة والاعتباريّة. وقد اُطلقت «الكلمة» في القرآن الكريم(1) على المسيح بن مريم(علیهالسلام) ولعلّ النكتة فيه أنّ خلقه الخارق للعادة من أحسن وجوه إعلام الخلائق بصفات الخالق. والظاهر أنّ المراد بالكلمات في قوله تعالى: «قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّي»(2) أيضاً الكلمات التكوينيّة المعربةُ عن صفات مكوّنها. وأمّا توسعة مفهوم الكلام بحيث يشمل صفات الله الذاتيّة، واعتبارهُ متكلّماً في مقام ذاته واعتبار الكلام صفة ذاتيّة له، فهو خروج عن عرف المحاورة، وليس له شاهد من الكتاب والسنّة كما نبّه عليه الاُستاذ(قدسسره).
449 ـ قوله «وإرجاع حقيقة معناه إلى نحو من معنى القدرة»
بل يرجع ذلك التحليل إلى اعتبار الصفات كلّها كلاماً والذات متكلّماً.
450 ـ قوله «هذا جارٍ في السمع والبصر»
قد مرّ تحت الرقم (434) أنّ الظاهر أنّهما من الصفات الفعليّة، وأن لا دليل على
1. سورة آل عمران، الآية 39 و 45؛ وراجع: سورة النساء، الآية 131.
2. سورة الكهف، الآية 109؛ وراجع: سورة لقمان، الآية 27.
اعتبارهما من الصفات الذاتيّة إلاّ ما اشتهر في ألسنة المتكلّمين وتبعهم على ذلك بعض الفلاسفة. نعم، حكي عن صاحب الإشراق أنّ علمه راجع إلى بصره، لا أنّ بصره يرجع إلى علمه.(1) وهو مبتنٍ على ما ذهب إليه من كون علمه التفصيليّ عين وجود الأشياء، وتفسير الإبصار بالشهود، فتبصّر.
الفصل السابع عشر
451 ـ قوله «في العناية الإلهيّة...»
حاصل ما ذكر في تحليل معنى العناية أنّها اهتمام الفاعل بفعله حتّى يتحقّق على وجه الخير أو على أحسن وجوهه إذا كانت هناك وجوه من الخير. لكن عناية الإنسان وذوي النفوس بأفعالهم إنّما تكون لأجل ما يتوخَّون من منافعَ تعود إليهم، وذلك لفقدانهم تلك المنافع والكمالات، وأمّا المجرّد التامّ فحيث إنّه واجد في ذاته لكلّ كمال ممكن الحصول له فلا يتوخَّى منفعة من فعله. ولهذا ذهب بعض المتكلّمين كالأشاعرة إلى إنكار الغاية في فعله تعالى، وذهب بعض آخر كالمعتزلة إلى أنّ غايته وصول الخلق إلى منافعهم ومصالحهم. وقد مرّ في الفصل الحادي عشر من المرحلة الثامنة أنّ غاية المجرّدات هي في الحقيقة نفس ذواتها، وأنّ منافع ما دونها مقصودة لها بالتبع.
فقوام العناية يكون بالفاعليّة، وعلم الفاعل، وحبّه للفعل التابع لحبّ ذاته.(2) وهذه الاُمور ثابتة في الواجب تعالى فتثبت عنايته سبحانه بخلقه. فإذا أخذنا هذه الإضافة إلى وجود الممكنات بعين الاعتبار كانت العناية من الصفات الإضافيّة الفعليّة. لكن
1. راجع: الأسفار: ج6، ص423.
2. راجع: نفس المصدر: ج7، ص57؛ وراجع: الرقم (437) من هذه التعليقة.
يمكن إرجاعها إلى العلم بالأصلح أو إلى الحبّ الذاتيّ، فتعود صفةً ذاتيّة، نظير ما مرّ في الإرادة،(1) ومثله يجري في الحكمة.
قال الشيخ في التعليقات: «العناية هي أنّ الأوّل خير، عاقل لذاته، عاشق لذاته، مبدء لغيره. فهو مطلوب ذاته، وكلُّ ما يصدر عنه يكون المطلوب فيه الخيرَ الذي هو ذاته. وكلُّ هذه الصفات ما لم تعتبرْ فيها هذه الاعتبارات واحدة. وكلّ من يعتني بشيء فهو يطلب الخير له. فالأوّل إذا كان عاشقاً لذاته لأنّه خير، وذاته المعشوق مبدء الموجودات فإنّها تصدر عنه منتظمةً على أحسن نظام».
وقال أيضاً: «العناية صدور الخير عنه لذاته، لا لغرض خارج عنه فتكونَ له إرادةٌ متجدّدة. فذاته عناية. وإذا كان ذاته عنايتَه، وذاته مبدء الموجودات، فعنايته بها تابعة لعنايته بذاته. وأيضاً إذا كان مطلوبه الخيرَ، والخير ذاته وهو عنايته، وهو مبدء لما سواه، فعلمه بذاته أنّه خير، مبدء لهذه الأشياء وعناية له بها. ولو لم يكن عاقلاً لذاته، وعاقلاً لأنّ ذاته مبدء لما سواه لَما كان يصدر عن ذاته التدبير والنظام. وكذلك لو لم يكن عاشقاً لذاته لكان ما يصدر عنه غيرَ منتظم، لأنّه يكون كارهاً له غير مريد له. وليست الإرادة إلاّ أنّ الموجودات غير منافية لذاته. ولمّا كان عاشقاً لذاته، وكانت الأشياء صادرة عن ذاتٍ هذه صفتها ـ أي معشوقة ـ فإنّه يلزم أن يكون ما يصدر عنه معنيّاً به، لأنّه عاشق ذاته، ومريد الخير له».(2)
ولك أن تقول: عدم عناية الفاعل بفعله حتّى يتحقّق على أحسن الوجوه إمّا أن يكون لأجل جهله بوجه الخير، أو لأجل عجزه عن تحقيقه، أو لأجل عدم حبّه لكماله وعدم إرادته له، أو لأجل بخله وإمساكه واستئثار ذلك الكمال لنفسه. فكل
1. راجع: الرقم (442).
2. راجع: التعليقات: ص157؛ والتحصيل: ص578579؛ والقبسات: ص333ـ342؛ والمباحث المشرقية: ج2، ص492؛ وراجع: النمط السادس والنمط السابع من شرح الإشارات.
هذه النقائص مسلوبة عنه سبحانه، ومقابلاتها ثابتة له تعالى، فيثبت من طريق اللمّ كون العالَم على أحسن ما يمكن. قال تعالى: «الَّذِي أَحْسَنَ کُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ»،(1) وقال: «صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ کُلَّ شَيْءٍ».(2)
وقد بيّن صدر المتألّهين إتقان نظام العالم ببيان إجماليّ، ثمّ تصدّى لتفصيل ذلك من طريق اللمّ والإنّ معاً، ثمّ أخذ في بيان آثار حكمته وعنايته تعالى في خلق العالم في عدّة فصول.(3)
452 ـ قوله «والمشهود من النظام...»
إشارة إلى البيان الانّي لحسن نظام العالم وإتقانه وإحكامه، ولا تزال معرفة الإنسان تزداد بجودة الخلق، وحسن النظام، وإتقان الصنع، وكمال التدبير، ودقائق الحكمة على ضوء تقدّم العلوم التجريبيّة، ممّا لا يُبقي ريباً للناظر السليم، في أنّ هذا النظام القويم، صادر من خالق قادر حكيم، وربّ جواد كريم، ومدبّرٍ ناظم عليم: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ».(4)
الفصل الثامن عشر
453 ـ قوله «في الخير والشرّ...»
عندما تُطْرَحُ مسألة النظام الأحسن وعناية البارئ وحكمته تعالى يثار سؤال، هو أنّه
1. سورة السجدة، الآية 7.
2. سورة النمل، الآية 88.
3. راجع: الأسفار: ج7، ص91ـ93 و 106ـ148؛ وراجع: المبدء والمعاد: ص193ـ222؛ والقبسات: ص425-428؛ والتلويحات: ص76ـ78.
4. سورة الزخرف، الآية 9.
إذا كان له سبحانه عناية بخلقه وكان لازمها أن يتحقّق العالم على أحسن ما يمكن وأحكمه، فلِمَ يوجد في العالم ما يشاهَد من الشرور الكثيرة، أعمَّ ممّا يحصل من ناحية العوامل الطبيعيّة كالزلازل والأمراض وسائر البلايا، أو من ناحية الأناسيّ من أنواع الظلم والمعاصي وإهلاك الحرث والنسل؟ ألم يكن من الأحسن أن يكون العالم نزيهاً عن تلك الشرور والمصائب؟
وقد ذهبت الثنويّة إلى أنّ هناك مبدأين: أحدهما للخيرات، وثانيهما للشرور، ولا يزالان يتنازعان إلى أن ينتهي الأمر بغلبة مبدء الخير. وذهب بعض الناس إلى القول بالإرادة الجزافيّة وإنكار العناية الإلهيّة، وذهب الملحدون إلى إنكار الخالق الحكيم وجعلوا الشرور أماراتٍ على نفي الحكمة. سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون.
وقد نهض الفلاسفة الموحّدون بالإجابة على ذلك السؤال ودفع ما يتعلّق به من الشبهات ممّا أدّى إلى جوابين: أحدهما أنّ الشرور من لوازم عالم الطبيعة، فهي مقصودة بالتبع لا بالأصالة. وثانيهما أنّ الشرّ بالذات هو العدم، وشرور هذا العالم ترجع إلى جهاتٍ عدميّةٍ، فتكون مقصودةً بالعرض لا بالذات.
فالغرض من عقد هذا الفصل هو توضيح هذين الجوابين، وذلك بتحليل مفهومَي الخير والشرّ، وإثبات أنّ الشرور اُمور عدميّة، وأنّها تختصّ بعالم المادّيات، حتّى تتمهّد الأرضيّة لبيان ذينك الجوابين. وله فوائد اُخرى تتعلّق بمبحث الغايات وغيره. وبهذا يظهر سرُّ ما أولت الفلاسفة من عناية بهذا المبحث، فإنّ به يتبيّن بطلان مذهب الثنويّة، وتتحَّقق حكمة البارئ تعالى وعنايته بخلقه، وكون العالم على أحسن ما يمكن من النظام، وبه يجاب عن شبهات الملحدين في أسمائه وصفاته، والمنكرين لعدله وحسن قضائه وتمام تدبيره وكمال ربوبيّته.
454 ـ قوله «الخير ما يطلبه...»
لا ريب أنّ الخير والشرّ متقابلان، فلا يكون شيء واحد من جهة واحدة خيراً وشرّاً معاً. فإن اعتُبرا وجوديَّينِ كانا من قبيل المتضادَّينِ ـ لوضوح عدم كونهما متضايفين ـ وإلاّ كان أحدهما عدميّاً لا محالة. فهل هناك ما يدلّ على تعيين أحد الفرضين؟
يمكن أن يُتوهّم أنّهما أمران وجوديّان متضادّان، لاتّصاف بعض الأعيان الخارجيّة بالخير وبعضها الآخر بالشرّ كاتّصاف الأفعال الاختياريّة والملكات النفسانيّة بهما أيضاً. لكن بالنظر إلى أنّ الأوصاف أعمُّ ممّا بالذات وما بالعرض، وما بالأصالة وما بالتبع، ينبغي أن يُجتهد في تحليل معناهما والتعرّف على حقيقتهما.
وممّن لم يألُ جهداً في هذا المضمار الشيخ الرئيس، حيث قام بفحص بالغ لمواردهما، وتحليل عميق لمفهومهما، وبيان جامع لحقيقتهما، ولولا مخافة التطويل لنقلنا عباراته بألفاظها، فسوف نكتفي بذكر محصَّل بياناته:
الف) الشرّ قد يستعمل في النقص كالجهل والضعف والعمى وغيرها من الاُمور العدميّة. وواضح أنّه ليس لهذه الاُمور جهة وجوديّة يصحّ أن تنسب الشرّيّة إليها حتّى يُتوهَّم أنّ الجهة العدميّة تابعة غير متّصفة بالشرّ بالأصالة. فلا ريب أنّ الشرّ في هذه الموارد هو نفس الجهة العدميّة. وقد يستعمل الشر في الاُمور الوجوديّة المتعلّقة بالأعدام كالآلام والغموم، فإنّها وإن كانت إدراكاتٍ وجوديّةً إلاّ أنّها تتعلّق باُمور عدميّة كفقد السلامة والمطلوبات. والإدراك بما أنّه إدراك ليس شرّاً، فالشرّ ناشيء عن متعلّقه وهو الفقد والعدم. وقد يستعمل في مجمع الأمرين، كمن يتألّم بفقدان اتّصال عضو بحرارة ممزّقة، فيكون قد اجتمع هناك إدراكان: الألم، وإدراك الحرارة. أمّا الألم فقد اتّضح أمره، وأمّا إدراك الحرارة فليس شرّاً بما أنّه إدراك، ولا الحرارة تكون شرّاً بما أنّها حرارة، بل بالقياس إلى العضو المتأذّي بها. فههنا توجد جهات متعدّدة، لكنّ الشرّ يعود إلى الجهة العدميّة فقط. ففي هذين القسمين أيضاً يكون الشرّ من النقص والعدم؛
ب) قد يتّصف الشيء بالشرّ من أوّل وجوده كتشوّه الخلق، وقد يطرأ عليه بعد ما وُجد خيراً. والأوّل حاصل من أسباب خارجة أوجبتْ فَقْدَ استعداد المادّة لما هو أكمل. فهذا الشرّ هو ناشيء عن نقص استعداد المادّة. وأمّا القسم الثاني فقد يكون لأجل مانع عن وصول الشيء إلى كماله، كمنع السُحُب المتراكمة وأظلال الجبال الشاهقة عن يَنْع الثمار، وقد يكون لأجل عامل مضادّ مفسد، كالديدان التي تفسد الثمار. وكلاهما يرجعان إلى النقص والعدم؛
ج) الكمالات تنقسم إلى كمالات أوّليّة بها تتحصّل نوعيّة النوع، وكمالات ثانويّة تقتضيها نوعيّة النوع وتوجد في أكثر الأفراد، وهي قريبة من الاُولى، وكمالات اُخرى توجد في أفراد قليلين بعد حصول استعدادت خاصّة لها. أمّا فقد الكمالات الاُولى والثانية فلا ريب في شرّيّته. وأمّا ما يحصل في بعض الأفراد فلا يعتبر فقده شرّاً بالنسبة إلى النوع كالجهل بالفلسفة والهندسة بالنسبة إلى نوع الإنسان، وإن كان شرّاً باعتبار آخر؛
د)قد يطلق الشرّ (بمعناه القيميّ) على الأفعال المذمومة كالظلم والزنا، وهذه الشرّيّة تكون بالقياس إلى من يفقد كماله بوصول ذلك الفعل إليه كما في الظلم، أو بالقياس إلى المجتمع الذي يفقد كمالاً يجب له في السياسة المدنيّة كما في الزنا، وكلاهما شرّ للنفس الناطقة التي كمالها في كسر الشهوة والغضب. وقد يطلق الشرّ (بهذا المعنى القيميّ) على الملكات الرذيلة باعتبار ما يلزمها من فَقْد النفس كمالاتٍ تجب لها؛
ه) لا يوجد فعل يتّصف بالشرّ من حيث وجوده وصدوره عن الفاعل بما أنّه فعله، بل بالقياس إلى السبب القابل، أو إلى فاعل آخر يُمنع من فعله الأولى. فالشرور كلّها ترجع إلى فقد الكمال لقصور المادّة، أو لتأثير فاعل يزيل استعدادها، أو يُفسد الكمال الحادث فيها، أو يَمنع من تأثير فاعل آخر. وموطن هذه كلّها هو عالم المادّة الذي هو محلّ الحوادث والتزاحمات؛
و) الاُمور العدميّة ليست من فعل فاعل، فلا تستند إلى المبادئ العالية أيضاً إلاّ بالعرض، وأمّا الاُمور الوجوديّة التي قد تتّصف بالشرور فلها جهتان أو جهات، وإنّما تكون شرّيتها بالقياس إلى قابل يفقد استعداداً لكمال جديد، أو لبقاء كماله الموجود، أو تكون بالقياس إلى فاعل آخَر يُمنع من فعله الخير. فهذه الاُمور الوجوديّة وإن كانت مستندةً إلى فواعلها وتنتهي إلى المبادئ العالية حقيقةً لكن جهات خيرها أكثر وأغلب، فهي بما لها من الخيرات مقصودةٌ بالقصد الأوّليّ، وبما يلزمها من النقائص والشرور مقصودةٌ بالقصد الثاني. وذلك لأنّ التضادّ في التأثير والتزاحم في الحصول على الكمالات من لوازم عالم المادّة التي لا تنفكّ عنها، ولولا ذلك لم تحصل فيها كمالات جديدة كثيرة. فالأمر يدور بين وجود هذا العالم بما فيه الخير الكثير والشرّ القليل، وعدمه المستلزم لعدم الخير الكثير. لكن ليس من الحكمة الإلهيّة أن يترك الخيرات الفائقة الدائمة والأكثريّة لأجل شرور غير دائمة ونادرة؛(1)
ز) إذا كان الشرّ هو عدم وجود أو عدم كمال وجود (ولا محالة يرجع إلى عدم الوجود، لأنّ الكمال أيضاً وجود) فالخير يقابله، فهو إمّا وجود وإمّا كمال وجود. وكلّما كان الوجود أكملَ كان خيريته أفضلَ، فالوجود المجرّد أشدُّ خيريّةً من الموجود المادّيّ، والواجب الوجود هو الخير المحض. أمّا اتّصاف العدم بالخيريّة أحياناً فإنّما هو لأجل استتباعه وجوداً، فهو خير بالعرض، كما أنّ اتّصاف الوجود بالشرّ كان لأجل استتباعه عدماً، وكان شرّاً بالعرض. وقد يقع الخير وصفاً لموجود بما أنّه مفيد الكمال لشيء آخر، فالواجب الوجود يكون خيراً من هذه الجهة أيضاً، لأنّه يفيد كلَّ وجود وكلَّ كمال وجوديّ.(2)
1. راجع: الفصل السادس من المقالة التاسعة من إلهيّات الشفاء؛ والنجاة: ص284ـ291؛ والمباحث المشرقية: ج2، ص519532؛ والأسفار: ج7، ص5862.
2. راجـع: الفصل السادس من المقالة الثامنة من إلهيّات الشفاء؛ والنجـاة: ص229؛ والقبسـات: ص428 436؛ والتعليقات: ص103.
ثمّ إنّ الشيخ عرّف الخير بأنّه ما يتشوّقه كلُّ شيء.(1) والتشوّق إنّما يكون إلى الوجود وكمال الوجود، ولا يحصل شوق إلى عدم إلاّ باعتبار ما يلازمه أو يستتبعه من الوجود وكماله. وتبعه على ذلك صدر المتألّهين وغيره.(2) لكن حيث كان معنى التشوّق مستلزماً لفقد المتشوَّق إليه ممّا لا يوجد إلاّ في ذوي النفوس المتعلّقة بالموادّ، بدّله الاُستاذ(قدسسره) بالطلب والإرادة والحبّ. ومع ذلك فإنّه يثور ههنا سؤالان:
أحدهما أنّه هل يجب في كلّ خير أن يكون مطلوباً لكلّ طالب ومريد؟
وثانيهما أنّه هل يراد بالطلب والحبّ حقيقةُ معناهما ممّا لا يوجد إلاّ في ذوي الشعور، أو يراد بهما أعمُّ من ذلك؟
أمّا السؤال الأوّل فيمكن الإجابة عليه بأنّ خير كلّ شيء هو ما يحبّه ويكون مطلوباً له، لوضوح أنّ كمال كلّ نوع إنّما يكون مطلوباً لذلك النوع، فالكمال الخاصّ بالفرس مثلاً ليس مطلوباً لنوع آخر من الحيوان. فالمراد بتلك العبارة أنّ الوجود على اختلاف أنحائه يكون مطلوباً لكلّ طالب، لكن كلّ موجود إنّما يحبّ وجوده وكمال وجوده نفسه. ويمكن أن يكون المراد أنّ الخير المطلق وهو الله تعالى يتشوّقه كلُّ شيء، فافهم.
وأمّا السؤال الثاني فالظاهر لزوم تأويل الحبّ والطلب إلى معنى أعمَّ كالاقتضاء مثلاً، لوضوح عدم اختصاص الخير بذوي الشعور. ولعلّ النكتة في التركيز على مطلوبيّة الخير هي الإشارة إلى أصل معناه اللغويّ والعرفيّ.
توضيح ذلك أنّ الخير والشرّ ليسا من المفاهيم الماهويّة، وإنّما هما مفهومان منتزعان عن قياس الأشياء بعضها ببعض. وأوّل ما يحصل فيه المقايسة للإنسان هو خير نفسه، فما يجد في نفسه ميلاً وشوقاً حبّاً له يسمّيه خيراً، وما يجد في نفسه
1. راجع: نفس المصدرين السابقين؛ وراجع: التعليقات: ص72 و 77.
2. راجع: الأسفار: ج7، ص58؛ والقبسات: ص428.
كراهة ونفرة وبغضاً له يسمّيه شرّاً. فإذا أخذنا في تحليل هذين المعنيين نجد أنّ حقيقتهما ترجعان إلى الملاءمة والمنافرة للنفس، وإذا أمعنّا في التحليل وصلْنا إلى الكمال والنقص، فإنّ الملائم هو الكمال، والمنافر هو النقص. وبتدقيق أكثر نستنبط أنّ الخير هو الوجود والشرّ هو العدم، لأنّ الكمال لا يكون إلاّ وجوديّاً، والنقص لا يكـون إلاّ عدميّاً. فهـذان المعنيان المستنبطـان ـ وإن لم يسـاعِد عليهما العرف كلَّ المساعدة ـ قابلان للصدق على غير ذوي الشعور أيضاً. نعم، لـو ثبت سريان العلم والحبّ والإرادة والطلب في جميع الموجودات لأمكن التركيز على الحبّ بمعناه الحقيقيّ في تفسير الخير، فتفطّن.
455 ـ قوله «فهو عدم ذات أو عدم كمال ذات»
قد تحصّل من التحليل الذي قام به الشيخ أنّ الشرّ قسمان: أحدهما عدميٌّ كالجهل والعمى، وثانيهما وجوديّ يلازم أو يستتبع عدماً. وهذا القسم الأخير إنّما يكون شرّاً بالقياس إلى شيء آخر من جهة ما يوجب فقداً ونقصاً له. فيمكن أن يتوهّم أنّ تقابل الشرّ والخير ليس في جميع الموارد على نهج واحد، فالقسم الأوّل من الشرّ يتقابل مع الخير تقابُلَ العدم والملكة، أمّا القسم الثاني منه فيتقابل معه تقابُلَ الضدّين، لأنّهما وجوديّان، وعلى هذا فلا يصحّ أن يقال مطلقاً إنّ الشرّ عدم ذات أو عدم كمال ذات، وأن لا ذات للشرّ، بل يجب أن يعتبر لقسم من الشرور ذات.
وربما يقال في دفع هذا التوهّم أنّ هذا القسم من الشرّ أمر إضافيٌّ ومعنى نسبيٍّ والإضافة هي من الاُمور الاعتباريّة، ولا ذات لها كما لا يتعلّق بها جعل وإيجاد.
ويلاحظ عليه أنّ هذه الإضافة لا تختصّ بالشرور، فمن الخيرات أيضاً ما هو إضافيّ، بل يمكن أن يقال إنّ الخير والشرّ مطلقاً من المفاهيم ذات الإضافة، فإنّ الكمال إنّما يكون خيراً لما يجده، والنقص إنّما يكون شرّاً للموضوع الذي يتّصف
به، ولا يتعلّق بشيء من هذه المعاني الإضافيّة والرابطيّة جعلٌ، وإنّما يتعلّق الجعل بمنشأ الانتزاع وطرفَيْ الإضافة.
والجواب الحاسم هو بالفرق بين المعنى العرفيّ والمعنى الفلسفيّ، فإذا اعتبرنا الشرّ بمعناه العرفيّ كان له قسمان، وكان تَقابلُ أحد قسميه مع الخير من قبيل تقابل الضدّين، كما مرّ في التقابل بين الألم واللذّة تحت الرقم (189). لكن بالنظر الدقيق الفلسفيّ يعتبر اتّصاف الوجود بالشرّ إتّصافاً بالعرض، وذلك بتحليل الموجود إلى حيثيّتين أو أكثر، وإرجاع الشرّ إلى الحيثيّة العدميّة، كما مرّ في كلام الشيخ.
وبعبارة اُخرى: إذا ركّزنا في معنى الخير والشرّ على مفهومَيْ المطلوب والمنفور كان بعض الموجودات متّصفاً بالشرّ اتّصافاً حقيقيّاً، كالآلام والغموم، وهذا ما يتوافق مع عرف المحاورة. أمّا إذا أمعنّا في التحليل وتعقّبنا منشأ هذا الاتّصاف وجدنا أنّه في كلّ هذه الموارد هو النقص وعدم الكمال. وبهذا الاعتبار يقال: إنّ الشرّ بالذات هو العدم، وأن لا ذات للشرّ. وهذا نظير ما مرّ تحت الرقم: (10) أنّ اتّصاف المهيّة والكلّي الطبيعيّ بالوجود يكون بالعرض والمجاز من وجهة النظر الفلسفيّة، وإن لم يساعد عليه العرف، بل اعتبر بهذا النظر سفسطة.
456 ـ قوله «والدليل...»
هذا الدليل هو الذي أقامه قطب الدين الشيرازيّ في شرح حكمة الإشراق،(1) وتبعه صدر المتألّهين.(2) وهو في الحقيقة يهدف إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ الشرّ بالذات من وجهة النظر الفلسفيّة هو العدم بعد قبول أنّ الشرّ مطلقاً لا ينفكّ عن العدم، فليس مصادرةً بالمطلوب.
1. راجع: شرح حكمة الإشراق: المقالة الخامسة، ص520 (من الطبعة القديمة).
2. راجع: الأسفار: ج7، ص59.
وحاصله أنّ الشرّ لو كان أمراً وجوديّاً لكان الشرُّ غيرَ شرّ، والتالي باطل فالمقدّم مثله. وبيان الملازمة أنّ الشرَّ لو كان أمراً وجوديّاً لكان إمّا شرّاً لنفسه أو شرّاً لغيره. والأوّل محال، لأنّ معنى كون الشيء شرّاً لنفسه هو اقتضاؤه لعدم ذاته أو لعدم كمالاته، لما مرّ أنّ الموجود الشرّ إنّما يكون شرّاً لاقتضائه عدماً مّا، ولو اقتضى شيء عدمَ ذاته لما وجد، ولو اقتضى عدم شيء من كمالاته لكان الشرّ ذلك العدم لا هو. مضافاً إلى أنّ مثل هذا الاقتضاء غير معقول، لوضوح أنّ الأشياء إنّما تقتضي كمالاتها لا عدم تلك الكمالات، والعناية الإلهيّة تقتضي إيصال كلّ شيء إلى كماله. وأمّا الثاني وهو كون الأمر الوجوديّ شرّاً لغيره فإنّما يتصوّر بإفساده أو إفضاء نقص إليه، فيعود الشرّ بالذات إلى ذلك الفساد والنقص العدميّين، وقد فرض أنّ الشرّ بالذات هو الوجود.
457 ـ قوله «فإن قلت...»
هذا الإشكال هو الذي ذكره المحقّق الدوانيّ في حاشية التجريد، وحاصله أنّ الألم الذي يحصل عند قطع العضو مثلاً أمر وجوديّ، وهو شرٌّ حقيقةً وبلا تجوّز، وإذا اعتبر الانفصال الذي يرجع إلى العدم شرّاً فهو شرٌّ آخر. ثمّ قال: والتحقيق أنّهم إن أرادوا أنّ منشأ الشرّيّة هو العدم، فلا يرد النقض عليهم. وإن أرادوا أنّ الشرّ بالذات هو العدم، وما عداه إنّما يوصف به بالعرض، حتّى لا يكون بالحقيقة إلاّ شرّيّةٌ واحدةٌ هي صفة العدم بالذات، وتنسب إلى غيره بالتوسّط كما هو شأن الاتّصاف بالعرض، فهو وارد. فافهم.
وقد تعرّض صدر المتألّهين لهذا الإشكال في موضعين من الأسفار(1) ـ كما أنّه قد تقدّمت الإشارة إليه في هذا الكتاب أيضاً في الفصل الخامس عشر من المرحلة
1. راجع: الأسفار: ج4، ص126؛ وج7: ص6267.
السادسة ـ ودفَعه بعد اختيار ثاني الشقّين بما حاصله أنّ الألم هو إدراك الانفصال أو زوال السلامة أو غيرهما من الاُمور العدميّة إدراكاً حضوريّاً، والإدراك عين المدرَك بالذات. فهو عين ذلك الأمر العدميّ.
ويلاحظ عليه أوّلاً أنّ العدم بما أنّه عدم ليس له حضور عند النفس، ولا يتعلّق به إدراك حضوريّ، وثانياً أنّ الألم غير إدراك الانفصال أو أيّ أمر عدميّ آخر. وقد مرّ أنّ اللذّة والألم ليسا عين العلم والإدراك وإن كانا من الكيفيّات الإدراكيّة، فراجع الرقم (188 ـ 189).
ثمّ إنّ المحقّق السبزواريّ بعد المناقشة في كلام صدر المتألّهين ذكر وجهاً آخر لدفع الإشكال، وهو أنّ الألم أمر وجوديّ، لكنّه من هذه الجهة ليس شرّاً، وإنّما شرّيته ناشيءة عن عدم ملاءمته للنفس، وهو أمر عدميٌ.(1)
والأشبه ما نبّهنا عليه تحت الرقم (455) أنّ الشرّ بمعناه العرفيّ يعمّ بعضَ الاُمور الوجوديّة كالآلام والغموم والجهل المركّب والملكات الرذيلة، وعليه فلا مناص عن قبول الشقّ الأوّل من الشقّين اللذين ذكرهما المحقّق الدوانيّ، ويكون أحد مصاديقه الألَمَ الذي هو أمر وجوديٌّ بلا ريب، سواء كان من قبيل الإدراك أو نوعاً آخر من الكيف النفسانيّ. وأمّا معناه التحليليّ الفلسفيّ فينحصر في الأمر العدميّ، ويكون اتّصاف بعض الوجودات به اتّصافاً بالعرض، نظير اتّصاف المهيّة بالوجود.
والحاصل أنّ الألم أمر وجوديٌّ بلا شبهة، وشرٌّ حقيقيٌ بالنظر الجليل العرفيّ، وإنّما يكون منشأه زوالَ الراحة الذي هو نقص لكمال النفس في مرتبتها النازلة. لكن بالنظر الدقيق الفلسفيّ يكون الألم شرّاً بالعرض، وأمّا الشرّ بالذات فهو تلك الجهة العدميّة. فالمراد بلفظة «بالذات» في قولهم «العدم شرّ بالذات» هو أنّ الجهة العدميّة هي التي تتّصف أوّلاً وفي الرتبة المتقدّمة بالشرّ في النظر التحليلىّ العقلىّ الدقيق،
1. راجع: نفس المصدر: ج7، ذيل الصفحة 6267.
حيث تتميّز جهته الوجوديّة عن جهته العدميّة. وأمّا ما يقال «الألم شرٌّ بالذات» فهو في مقابل اتّصاف بعض اللّذات بالشرّ من حيث استتباعها لألم أشدَّ، فتفطّن.
458 ـ قوله «ثمّ إن الشرّ لمّا كان...»
قد تحقّق أنّ الشرّ أيّاً ما كان لا ينفكّ عن جهة عدميّة، سواء كان الأمر المتّصف بالشرّ ذا جهة واحدة هي بعينها العدميّة كالجهل، أو كان ذا جهات وكان شرّيته راجعة إلى جهته العدميّة، وسواء اعتبرنا نفس الجهة العدميّة شرّاً بالذات (كما في النظر التحليليّ الدقيق) أو اعتبرنا الجهة العدميّة حيثيّةً تعليليّةً خارجةً عن ذات الشرّ (كما في النظر الجليل) وسواء كان العدم عدماً لكمال أوّل به قوام شيئيّة الشيء ويعبّر عنه بعدم الذات، أو كان عدماً لكمال ثانٍ يعبرّ عنه بعدم كمال الذات. فكلّما فرض شرٌّ كان لا محالة هناك أمر عدمّي. وهذا الأمر العدميّ يكون عدماً لملكة هي خير بالذات، ولابدّ من فرض موضوع يصحّ اتّصافه بهذه الملكة وبعدمها. والموضوع الخارجيّ الذي يعتبر له كمال أوّل أو كمال ثانٍ جائز الزوال لا يكون إلاّ من المادّيات، لأنّ المجرّدات ثابتة بذواتها وكمالاتها، ولا يصحّ فرض كمال جائز الزوال لها. فينتج أنّ الشرّ خاصّ بعالم المادّيات، حيث يوجد فيه تزاحم الفواعل في التأثير ممّا يتأدَّى إلى منع بعضها عن التأثير في إعداد شيء آخر لصورة جديدة أو لكمال جديد، أو إلى فساد صورة وزوال كمال ثانٍ بعد تحقُّقهما.
وأمّا الأعدام والنقائص اللازمة للمهيّات حتّى المجرّدات فليست ممّا يمكن تبدّلها إلى وجود حتّى تُعتبر أعداماً لملكات، ويُعتبر للموضوع شأنيّة الاتّصاف بها وبأعدامها. فلا تكون إلاّ أعداماً نسبيّة تنتزع من بعض مراتب الوجود بمقايستها إلى ما هو أتمُّ منها. ومثل هذه الأعدام لا تُعدّ شروراً، لأنّه ليس لموضوعاتها اقتضاء لمقابلاتها. فليس للصادر الثاني مثلاً اقتضاء للوصول إلى مرتبة الصادر الأوّل حتّى
يعتبر نقص وجوده شرّاً له، كما أنّه لا يكون شرّاً لغيره أيضاً. نعم، للخير مراتب، والخير المحض الذي لا يتصوّر له جهة عدميّة إطلاقاً هو الله تبارك وتعالى.(1)
بل يمكن أن يقال: إنّ الشرّ هو عدم لملكة يقتضيها شخص الموضوع لا نوعه فضلاً عن جنسه. فحرمان أنواع الحيوان من النفس الناطقة وكمالاتها لا يعدّ شرّاً لها، بل حرمان بعض أفراد الإنسان عن الكمال الذي يناله الأولياء المقرّبون لا يعدّ شرّاً لهم إذا لم يكن لهم استعداد للوصول إليه. وإنّما الشرّ هو حرمان كلّ فرد عمّا لشخصه استعداد خاصّ للوصول إليه، واقتضاء لنيله، وشوق إلى تحصيله.
459 ـ قوله «غير أنّها كيفما كانت...»
إلى هنا انتهى البحث عن حقيقة الخير والشرّ والفحص عن مواردهما، وبذلك تهيّأت الأرضيّة للإجابة على السؤال عن سبب دخول الشرور في القضاء الإلهيّ. والجواب المشهور هو المأثور عن المعلّم الأوّل، وهو أنّ الشرور الموجودة في العالم المادّي لازمة للطبائع المادّية بما لها من التضادّ والتزاحم، فلا سبيل إلى دفعها إلاّ بترك إيجاد هذا العالم، وفي ذلك منع لخيراته الغالبة على شروره، وهو خلاف حكمته وجوده سبحانه. مضافاً إلى أنّ كثيراً من هذه الشرور مقدّمة لحصول خيرات وكمالات جديدة، فبموت بعض الأفراد تستعدّ المادّة لحياة آخرين، وبإحساس الألم يندفع المتألّم إلى معالجة الأمراض والآفات وإبقاء حياته، إلى غير ذلك من المصالح التي تترتّب على الشرور.(2)
وهذا الجواب يتّفق مع القول بوجوديّة الشرور أيضاً، ويبتني على أنّ شرور هذا
1. راجع: القبسات: ص428433.
2. راجع: السادس من تاسعة من إلهيّات الشفاء؛ والتلويحات: ص78ـ95؛ والمطارحات: ص466473؛ والقبسات: ص433435 و 448449؛ والأسفار: ج7، ص68ـ77.
العالم أقلُّ من خيراته. وقد عمد إلى إثبات هذه المقدّمة من طريق اللمّ بالاستناد إلى ما ثبت من عنايته تعالى. فيكون حاصل الجواب على القول بوجوديّة بعض الشرور أنّها مقصودة بالتبع وبالقصد الثاني. وأمّا على القول بعدميّة جميع الشرور فيكون الجواب أنّها مقصودة بالعَرض، لعدم ذات لها حتّى يتعلّق بها قصد حقيقي، سواء كان بالأصالة أو بالتبع.
وربما يستشكل على الجواب الأوّل بمنع غلبة الخيرات في العالم الإنسانيّ، فإنّ أكثر أفراد هذا النوع لا ينالون جميع الكمالات الإنسانيّة، خاصّةً بالنظر إلى قلّة المؤمنين بالنسبة إلى الكفّار والمشركين في جميع الأعصار، وبالأخصّ بالنظر إلى ما يلزم الكفر والعصيان من العذاب الخالد والشقاء الدائم.
وقد اُجيب عنه بأنّ قلّة الكاملين في ما مضى ليس دليلاً على قلّتهم في ما سيأتي، فعنايته سبحانه تقتضي بقاء العالم بحيث يغلب فيه الخير على الشرّ، والكامل على الناقص. وأمّا خلود الكفّار في العذاب فقد أوّله بعضهم إلى طول المدّة، وذهب إلى أنّ الأمر ينتهي بأخرةٍ إلى نجاة الجميع.(1)
لكن يمكن أن يجاب عنه بما يرفع الاستبعاد ولا يستلزم مخالفة نصوص الكتاب والسّنة. وهو أنّ غلبة الخيرات لا ينحصر فرضها في أكثريّة الكاملين من حيث العدد، بل يتحقّق غلبة الخيرات بأخذ الكيفيّة وشدّة الخيريّة ومراتبها أيضاً بعين الاعتبار، فيمكن أن يكون الكاملون أقلَّ عدداً من الناقصين، لكن تكون مراتب كمالهم راجحة على شرور الهالكين.(2) بل لا يبعد أن تكون كمالات المعصومين(علیهمالسلام) راجحة على نقائص جميع الأوّلين والآخرين، وهم المقصودون بالخلق بالأصالة.
1. نفس المصدر: ص79ـ81 و 88ـ90.
2. راجع: القبسات: ص437.
الفصل التاسع عشر
460 ـ قوله «انّ عوالم الوجود الكلّية ثلاثة»
المشهور بين الحكماء أنّ ما سوى الله تعالى ينقسم انقساماً أوّليّاً إلى عالمين اثنين: أحدهما عالم المادّيات، وهو عالم الأجسام بموادّها وصورها وأعراضها والنفوس المتعلّقة بها، وثانيهما عالم المفارقات، وهو عالم العقول المجرّدة عن المادّة، والمنزّهة عن آثارها وخواصّها كالزمان والمكان وغيرهما. وأنّ نظام العالم المادّيّ تابع لنظام العالم العقليّ، كما أنّه بدوره ظلٌّ للنظام الربّانيّ في علمه سبحانه. أمّا العالم المادّيّ فهو مشهود بالحسّ، ويثبت وجوده العينيّ بمعونة من العقل كما مرّت الإشارة إليه تحت الرقم (390) وأمّا العالم العقليّ فيثبت بالبرهان، وقد أقاموا براهين(1) لإثباته مما سبقت الإشارة إلي بعضها تحت الرقم (364).
وقد أثبت شيخ الإشراق عالَماً متوسّطاً بينهما سمّاه «عالم الأشباح المجرّدة» و«الصور المعلّقة» واستدلّ لإثباته بضرب من البرهان، وذهب إلى أنّ الإدراكات الجزئيّة تحصل بمشاهدة تلك الصور، وأنّها هي التي تظهر في المرايا. وكان يرى أنّ حشر المتوسّطين إلى ذلك العالم. لكن كانت عمدة مستنده هي المكاشفات. وقد جعل عالم النفوس عالَماً برأسه، فتصير العوالم عنده أربعة: أحدها عالم المفارقات المحضة التي يسمّيها بالأنوار القاهرة، وثانيها عالم النفوس التي يسمّيها بالأنوار المدبّرة والأنوار الإسفهبديّة، وثالثها عالم الأشباح المجرّدة أو الصور أو المُثل المعلّقة (وهي غير المُثل الأفلاطونيّة والعقول العرْضيّة) ورابعها عالم الأجسام التي يسمّيها بالبرازخ، ويصفها بالظلمات والغواسق والصياصي. أمّا عالم الأشباح
1. راجع: الأسفار: ج7، ص262ـ276؛ وراجع: القبسات: ص380ـ387.
فيتشكّل من صور نوريّة للسعداء، وصور ظلمانيّة للأشقياء، وينسب الجنّ والشياطين إلى هذا العالم، كما أنّه ينسب الملائكة إلى عالم الأنوار القاهرة.(1)
وفي كلامه مواقع للنظر والمنع، كالقول بأنّ الإدراكات الجزئيّة تتعلّق بعالم الأشباح، وأنّ الصور المعلّقة هي التي تظهر في المرايا، وأن الجنّ من عالم الأشباح، إلى غير ذلك. ومن جانب آخر: فربما يتأيّد وجود عالم الأشباح بالأدلّة النقليّة، خاصَّةً بالنظر إلى ورود تعابير الأشباح والأظلال في الروايات الشريفة. ويمكن تطبيق ما ورد في عالم البرزخ عليه.
وقد ناقش صدر المتألّهين في قسم من كلماته في مواضع من كتبه، لكّنه سلّم عالم الأشباح المجرّدة، وجعل للنفس مراتب بإزاء العوالم الكلّية، وهي مرتبتها العقليّة بإزاء العالم العقليّ، ومرتبتها المثاليّة التي ينسب إليها الإدراكات الجزئيّة ويسمّيها «المثالَ الأصغر» بإزاء المثال الأعظم (عالم الأشباح المجرّدة)، ومرتبتها النازلة المتعلّقة بالبدن. وبهذا الشكل لا يعتبر عالم النفوس عالَماً برأسه، فتكون العوالم عنده ثلاثة، وهو الذي ارتضاه سيّدنا الاُستاذ(قدسسره) وركّز عليه في مواضع من هذا الكتاب، واستدلّ عليه بما مرّ في الفصل السابع عشر، وحاصله أنّ الموجود الإمكانيّ إمّا أن يوجد فيه القوّة والاستعداد والتغيّر والتحوّل، وهو الموجود المادّى، أو لا توجد فيه هذه الاُمور، وهو الموجود المجرّد. ثمّ المجرّد إمّا أن توجد فيه آثار المادّة وهو الموجود المثاليّ أو البرزخيّ، وإمّا أن لا يوجد فيه شيء من آثار المادّة، وهو المجرّد العقليّ.
لكن مقتضى هذا التقسيم أن تُعدّ النفس في بدء وجودها من عالم نازل، ثمّ بعد استكمالها ترتقي إلى أعلى، أو تُعتبر لها نشآت مختلفة. وهو خلاف ظاهر التقسيم. فالأولى جعلها نوعاً برأسه، ممّا لا يستلزم صيرورتها عقلاً من العقول بعدما كانت
1. راجع: حكمة الإشراق: ص138ـ148 و 229ـ236.
صورةً من الأشباح، بل لها جوهرها الخاص بها، القابل للاشتداد والتضعّف وللصعود والسقوط، وللعروج والنزول، من غير أن ينقلب جوهرها ويتبدّلَ عالَمها. مضافاً إلى أنّ التقسيم الثاني هو تقسيم ثانويّ في طول التقسيم الأوّل، فلْتجزْ تقسيمات اُخرى وإن لم نعلم بتفصيلها، وليجزْ وجود عوالم اُخرى وإن لم يكن لعقولنا سبيل إلى معرفتها. وكيف كان فلا نرى موجباً لحصر العوالم في الثلاث، فليتأمّل.
461 ـ قوله «وإذ كان الوجود...»
بعد الفراغ عن إثبات العوالم تجيء النوبة إلى تبيين ارتباطها ببعض. فذكر الاُستاذ(قدسسره) أوّلاً أنّ بينها تقدُّماً وتأخّراً، وثانياً أنّ بينها علاقةَ العلّية، وثالثاً أنّها متطابقة باشتمال كلّ عالم أعلى على كمالات ما دونه، ورابعاً أنّها جميعاً آيات للواجب تعالى.
أمّا الأوّل فيمكن أن يراد بتقدّم بعضها على بعض تقدُّمه بالشرف، لكن مراده هو التقدّم في المرتبة الوجوديّة، خاصّة بالنظر إلى ما ركّز عليه كمقدّمة لهذه المطالب من كون الوجود حقيقةً واحدةً ذات مراتبَ مشكّكة. وأمّا الثاني فقد حاول تبيينَه بتوقُّف بعضها على بعض، وسبق المتوقَّف عليه. لكنّ التوقُّف غير بيّن ولا مبيّن، والسبق أعمُّ من السبق بالعلّيّة. ولعلّه عوّل على النتيجة الاُولى بضميمة تلك المقدّمة في كون اللاحق متوقّفاً على السابق. ويلاحظ عليه أنّ التشكيك في الوجود على نحوين: التشكيك العامّيّ كما في لونين مختلفين بالشدّة والضعف مثلاً، والتشكيك الخاصّي الذي يوجد بين المعلول وعلّته المفيضة، والأوّل لا يثبت ما هو بصدده من العلّيّة الإيجاديّة، وثبوت الثاني ههنا رهن للبرهان. فمن المحتمل أن يكون العالم المثاليّ والعالم المادّىُّ صادرين معاً عن العالم العقليّ وليس هناك ما يثبت أنّ كلَّ مجرّد فهو واقع في سلسلة العلل للمادّيات، كما أنّ الصور الذهنيّة والكيفيّات النفسانيّة لا توجد شيئاً من الجواهر المادّية وأعراضها في عالم الأعيان.
مضافاً إلى صعوبة تبيين صدور النفس بناءاً على وساطة عالم المثال، بالنظر إلى مراتبها المختلفة في عين وحدتها، فليتأمّل. وأمّا الثالث فهو فرع ثبوت العلّية بين الجميع، وأمّا الرابع فواضح لضرورة كون الجميع معلولاً له سبحانه.
الفصل العشرون
462 ـ قوله «في العالم العقليّ...»
لم نجد خلافاً من الحكماء في أنّ للعالم العقليّ وساطةً في إيجاد ما دونه. وأمّا نفس العالم العقليّ ففي كثرته طولاً وعرضاً خلاف،(1) وأشهر الأقوال هو قول أتباع المشّائين بالعقول العشرة المترتّبة بعضها على بعض، ووساطة كلّ منها في إيجاد مادونه. كما أنّ الأوّل منها واسطة في إيجاد الفلك الأقصى والنفس المتعلّقة بها ـ على زعمهم ـ أيضاً، وأنّ الثاني منها واسطة في إيجاد فلك البروج ونفسه، وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر الذي هو الفاعل المباشر لعالم العناصر. فعلى هذا القول لا يصدر في المرتبة الأولى إلاّ العقل الأوّل، لكن في كلّ واحدة من المراتب التالية تصدر ثلاثة اُمور: عقل ونفس وجرم فلك، وأمّا العقل العاشر فيصدر عنه هيولى العناصر والصورة الجسميّة المنطبعة فيها اللازمة لها، ثمّ جميع الصور الجوهريّة وأعراضها حسب الاستعدادات الحاصلة من تأثير الأوضاع الفلكيّة وحركاتها.
وأمّا الإشراقيّون فقد ذهبوا إلى أنّ في المرتبة الأخيرة من مراتب العالم العقليّ صدرت عقول كثيرة بعدد الأنواع الموجودة في هذا العالم، وهي المُثُل الأفلاطونيّة، وسيأتي الكلام في كلّ من القولين.
1. راجع: القبسات: ص387ـ389.
ومن المتّفَق عليه بين الكلّ أنّ الصادر الأوّل هو أشرف العقول وأكمل جميع المخلوقات والواسطة لصدور ما دونه، وربما يتأيّد ببعض الروايات الواردة بشأن أوّل ما خلق الله تعالى. وقد استدلّوا على ذلك بقاعدة «الواحد» التي مرّ الكلام فيها تحت الرقم (243) وقد أشرنا هناك إلى أنّه يمكن إثبات هذا المطلب من طريق آخر غير تلك القاعدة، وهو يبتني على أصالة الوجود، وكونه ذا مراتب طوليّة، وأنّ الوجود كلّما كان أقوى كان أبسط وأقرب إلى التأحّد، فلابدّ أن يكون أعلى المراتب الإمكانيّة وأقربها إلى الذات الأحديّة أبسطَها وأشملَها للكمالات الإمكانيّة، ولا يمكن فرض ثان له في تلك المرتبة.
463 ـ قوله «ثمّ إنّ الماهيّة لا تتكثّر...»
الذي يثبت بقاعدة «الواحد» هو الوحدة النوعيّة للصادر الأوّل ـ بناءاً على اختصاص القاعدة بالواحد النوعيّ ـ فيبقى السؤال عن الدليل على وحدته الشخصيّة. ولأجل الإجابة عليه استندوا إلى قاعدة اُخرى هي «انحصار كلّ مجرّد تامّ في شخص واحد» وقد مرّ الكلام عليها تحت الرقم (108). وأمّا الوجه الذي أشرنا إليه آنفاً فهو يثبت الوحدة الشخصيّة أيضاً، فتدبّر.
464 ـ قوله «وانّ فيه أكثر من جهة واحدة...»
بناءاً على تعميم قاعدة «الواحد» لغير الواجب ـ خلافاً لصدر المتألّهين في بعض كلماته ـ يلزم أن تكون هناك سلسلة واحدة من العلل ولا يصدر عن شيء منها إلاّ معلول واحد يكون بدوره علّة لما دونه، فيثور السؤال عن كيفيّة حصول الكثرة العرْضيّة، وعن إمكان صدور جرم الفلك ونفسه عن كلّ من العقول التسعة مع صدور عقل منه، وكيفيّة حصول الكثرات في عالم العناصر وصدورها عن العقل
العـاشر ـ حسب ما زعموا ـ وكذا عن كيفيّة صدور العقول العرْضيّة الكثيرة على رأي الإشراقيّين.
وقد احتالوا للإجابة عليه(1) بأنّ العقل الأوّل وإن كان واحداً شخصيّاً إلاّ أنّه تلزمه جهات متعدّدة هي علمه بمهيّته الممكنة، وبوجوده الواجب بالغير، وبعلّته الموجبة له، وهو الواجب تبارك وتعالى. فعلمه بالواجب الذي هو أشرف جهاته صار علّةً لصدور العقل الثاني، وعلمه بوجوده الواجب بالغير صار علّة لصدور نفس الفلك الأقصى، وعلمه بإمكان وجوده هو علّة لصدور جرم ذلك الفلك، وهكذا إلى العقل التاسع. وأمّا العقل العاشر فالذي يصدر عنه بلا مشاركة من غيره هو جرم عالم العناصر، وأمّا ما يحدث فيه من الصور والأعراض فبمشاركة من التأثيرات الفلكيّة ممّا يؤدّي إلى استعدادات للمادّة لصور وأعراض حادثة. فلا تكون هذه الكثرة صادرة عن فاعل واحد بما أنّه واحد، فلا تنتقض قاعدة «الواحد» بها.
والذي دعاهم إلى هذه التكلّفات هو ما تسلّموه كأصل موضوع من الأفلاك التسعة ذوي النفوس، فالتزموا بوجود عقول تسعة لصدورها، وبوجود عقل عاشر لصدور عالم العناصر الذي هو في جوف تلك الأفلاك. وقد اتّضح بفضل تقدُّم العلوم الطبيعيّة بطلان ذلك الأصل وفساده من أصله، فانهار البناء بعد انهدام الأساس على عروشه فضلاً عن نقوشه. مضافاً إلي ما كان يتوجّه إليهم من أسئلة لم تكن تجدُ أجوبةً صحيحةً عندهم كما يلي:
الف) هل تلك الجهات الثلاثة المفروضة في العقول كثرة حقيقيّة أو اعتباريّة؟ فإن اختير الشقّ الأوّل لزم صدور الكثير عن الواحد في المرتبة الأولى، وإن اختير الشقّ الثاني لزم ذلك في المرتبة الثانية؛
1. راجع: الفصل الرابع والفصل الخامس من المقالة التاسعة من إلهيّات الشفاء؛ وراجع: النجاة: ص273ـ278؛ والمباحث المشرقية: ج2، ص501515؛ والأسفار: ج7، ص192ـ281.
ب) ما هي العلاقة الذاتيّة بين كلّ واحد من تلك العلوم وبين ما يصدر عنها بحيث يتعيّن بها صدور كلّ واحد من المعاليل الثلاثة عن جهة خاصّة بالضرورة؟ مع أنّ الذي يعتبر في الفاعل العلميّ هو علمه بمعلوله لا غير؛
ج) لِمَ لم يصدر عن العقل الثاني أكثر من ثلاثة أشياءَ بالرغم من زيادة جهة فيه، وهي علمه بالعقل الأوّل أيضاً؟ وهكذا في سائر العقول حيث يزداد جهاتها كثرةً؛
د) ما هو المانع عن صدور عقل آخر وفلك آخر مع نفسِه عن العقل العاشر؟ إلى غير ذلك وكيف كان فقد طوى سيّدنا الاُستاذ(قدسسره) عن هذه الفرضيّة كشحاً، ومرّ بها كريماً. وركّز على أنّ الوجود كلّما تنزّل ازدادت جهة الكثرة فيه، فيجب أن تتنزّل مراتبه إلى حيث تتكافأ تلك الجهات مع ما في العالم الذي يلي عالم العقول من الكثرة، وهو عالم المثال حسب رأيه.
465 ـ قوله «وتُسمَّى هذه العقول أربابَ الأنواع والمُثُلَ الأفلاطونيّة»
لفظة «المُثل» في كتب الفلسفة مقرونة ب «أفلاطون» بحيث صارت الكلمتان تتداعيان في الذهن كالحاتم والسخاء... ولا شكَّ أنّ القول بالمُثل يشكّل رُكناً من أركان فلسفة أفلاطون، بل ليس من الجزاف أن يقال: إنّه رُكنها الركين وعمادها القويم، لأنّه عليه يبتني كثير من نظريّاته في باب المعرفة، ونظام الوجود، والأخلاق وغيرها. وبالرغم من اشتهار هذا القول ليس لدينا ما يوضح كلَّ جوانبه، ويُحدّد صِلاتِه بسائر المسائل. وقد اختلفت كلمات الناقلين والشارحين بحيث يصعب الجمع بينها والاستيقان بمراد أفلاطون بالضبط.
والمتيقَّن أنّه كان قائلاً بوجود اُمور مجرّدة تامّة لها علّية لما في هذا العالم المادّي. لكن حول ذلك نقاط مبهمة كثيرة لم تتوضّح للمحقّقين الجُدُد من
الغربيين أيضاً، فلا تزال موضعَ نقاش وجدال بينهم، لا في قبولها أوردَها فحسب، بل في تعيين ما كان يعتقد أفلاطون بشأنها. وإليك نماذج من الأسئلة التي تتعلّق بهذه النقاط:
1. هل لجميع ما ينتسب إلى هذا العالم مثال عقليّ، سواء كان من الطبيعيّات أو الرياضيّات أو غيرها، أو هي مختصّة بالطبيعيّات؟ ثمّ هل هي لجميع الطبيعيّات أو لكلّ الأنواع الجوهريّة منها، أو للأنواع الشريفة خاصّةً، فلا يوجد للأشياء الخسيسة والخبيثة مثال عقلىٌّ ـ كما عن بعض محاوراته ـ ؟
2. هل للأخلاق والجمال أيضاً مُثل عقليّةٌ أو لا؟ وعلى الإثبات فهل للأخلاق الرذيلة أيضاً مثال أو مُثُل أو لا؟
3. هل المُثل جواهرُ عينيّةٌ قائمة بذواتها أو هي صور عقليّة قائمة بذات البارئ سبحانه ـ كما ربما يظهر من الفارابيّ حيث حاول الجمع بين رأي أفلاطون ورأي تلميذه أرسطو في هذا الباب ـ ؟
4. هل تحصل المعرفة العقليّة والعلم بالمفاهيم الكليّة دائماً بمشاهدة المُثل أو تذكّرها أو يختصّ ذلك ببعض العلوم؟ وعلى الأخير فكيف يحصل العلم بسائر المفاهيم الماهويّة والمعقولات الثانيّة والمفاهيم الاعتباريّة؟
5. هل كان أفلاطون نفسه يبرهن على وجود المُثل أو كان يكتفي بالشهود والتجربة الذاتيّة أو بالاعتماد على شهود الآخرين أو آرائهم؟
6. ما هي النسبة بين المُثل أنفسها؟ هل هي جميعاً في عرْض واحد بلا تفاضل بينها أو هي على طبقات متفاوتة ودرجات متفاضلة؟ وإذا كان بينها تفاضل فهل يعني ذلك نوعاً من العليّة بينها أو لا؟
7. ما هي النسبة بين المُثل والطبائع الكليّة وأفرادها الماديّة؟ هل المُثل هي الطبائع أو أفراد مجرّدة منها أو لا هذا ولا ذاك وإنّما هي علل فاعليّة للأفراد؟
ولعلّك تحصل على أجوبة لهذه الأسئلة في ما نقل عنه في مطاوي كتب القوم(1) وخاصّةً في كتب شيخ الإشراق، لكنّها غير مفيدة لليقين، مضافاً إلى ما يتراءى بينها من تعارضات.
وكيف كان، فكلام الاُستاذ(قدسسره) ههنا مبنيٌّ على اعتبار المُثل كأفراد مجرّدة من المهيّات النوعيّة الجوهريّة التي توجد لها أفراد مادّية في هذا العالم، وإن لم نجد تصريحاً بفرديّتها لتلك المهيّات في مصدر معتبر، وإنّما حمل صدر المتألّهين كلامهم عليه لئلاّ يرد عليه بعض الإشكالات.(2)
466 ـ قوله «أحدها أنّ القوى النباتيّة...»
هذا الدليل هو الذي أقامه شيخ الإشراق في المطارحات،(3) ونقله عنه في الأسفار،(4) وحاصله أنّ القوى النباتيّة أعراض ثابتة في النباتات، فلابدّ من حامل ثابت لها، وهو إمّا الروح البخاريّ أو نفس الأعضاء أو النفس المدبّرة المتعلّقة بها أو العقل المفارق. أمّا الروح البخاريّ والأعضاء فهي دائمة التحلّل والتبدّل فلا تصلح لحفظ تلك القوى، وأمّا النفس فليست موجودة للنبات، وإلاّ لكانت ضائعة متعطّلة ممنوعة من الكمال أبداً، وهو محال. فلابدّ أن تكون أفعالها العجيبة التي تؤدّي إلى حصول الهيئات الحسنة والتخاطيط الرائعة صادرةً عن عقل مفارق حافظ لقواها ومدبّر لأفاعيلها.
1. راجع: الفصل الثاني والفصل الثالث من المقالة السابعة من إلهيّات الشفاء؛ والمطارحات: ص453-464؛ وحكمة الإشراق: ص138ـ147 و 155ـ167؛ والمباحث المشرقية: ج1، ص110ـ113؛ والأسفار: ج2، ص46ـ81؛ وج5: ص504506؛ وج7: ص169ـ171.
2. نفس المصدر: ج2، ص62.
3. راجع: المطارحات: ص455459.
4. راجع: الأسفار: ج2، ص5355.
ويلاحظ عليه أوّلاً أنّه لو تمّ لدلّ على ثبوت المُثُل للنباتات فقط، أمّا الجماد فليست له تلك القوى المختلفة الثابتة، وأمّا الحيوان فله نفس مدبّرة تغنيه عن تدبير المفارق مباشرةً، وثانياً أنّ هذا البيان مبتنٍ على إنكار الصور الجوهريّة المنطبعة في المادّة، فليس بمقنع لأتباع المشّائين، ولهم أن يقولوا بأنّ حامل القوى هو تلك الصورة النوعيّة، وأمّا تدبيرها الحكيم فمستند إلى العقل الفعّال، كما جاء في المتن.
467 ـ قوله «الثاني أنّ الأنواع الطبيعيّة...»
هذا الدليل هو الذي أقامه في حكمة الإشراق(1) وضمّ إليه صدر المتألّهين(2) بعض ما ذكره في المطارحات، وحاصله أنّ الأنواع الطبيعيّة باقية منحفظة بأفرادها، وليس وجود الأفراد واحداً بعد واحد بمجرّد الاتّفاق، فهناك تدبيرٌ واعٍ لحفظها وإبقائها، ولايكون ذلك إلاّ من قِبل عقل مفارق حافظ للنوع بتعاقب الأفراد وتكاثرها، خاصّةً بالنظر إلى ما في صُنع كلّ فرد منها من الحِكم والأسرار العجيبة التي لا يمكن إسنادها إلى مزاج أو قوّة عمياء.
ويلاحظ عليه أنّ بقاء النوع معلول لأفاعيل الأفراد كأنواع التناسل والتوليد، وتلك الأفاعيل هي من خواصّ صُورَها النوعيّة. وأمّا هذا النظام الحكيم الجاري فيها فهو مستند إلى العقل الفعّال، وهذا البيان لا يُثبت وجود مدبّر خاصّ بكلّ نوع.
468 ـ قوله «الثالث....»
هذا الدليل هو الذي أشار إليه في حكمة الإشراق بقوله «إمکان الأشرف يقتضي
1. راجع: حكمة الإشراق: ص143ـ144.
2. راجع: الأسفار: ج2، ص5657.
وجود هذه الأنواع النوريّة المجرّدة»(1) وقد ناقش فيه الاُستاذ(قدسسره) بما حاصله أنّه إمّا أن يشترط في مجرى القاعدة كون الأشرف والأخسّ من نوع واحد(2) وإمّا أن لا يشترط ذلك، فعلى الاشتراط لا نسلّم صحّة القاعدة لقصور برهانها عن إثبات هذا الشرط ـ على ما سيأتي ذكره ـ فإنّ مقتضى ذلك البرهان هو لزوم وجود الممكن الأشرف في مرتبة متقدّمة على وجود الأخسّ ممّا يرجع إلى علّيته له، لا لزوم صدق مهيّة الأخسّ على الأشرف أيضاً بحيث يصيران من نوع واحد. وأمّا بناءاً على عدم الاشتراط فلا تثبت بها المُثُل بمعنى الأفراد المجرّدة من الأنواع بحيث تندرج تلك الأفراد في مهيّاتها، وإنّما يثبت بها وجود موجود أشرفَ واجدٍ لكمالات الأخسّ بنحو أتمَّ، وإن لم يندرج في مهيّة الأخسّ، وهذا هو العقل الفعّال المشتمل على جميع كمالات مادونه.
وهذا المناقشة مبنيّة على تفسير المُثُل بالأفراد المجرّدة من المهيّات التي لها أفراد مادّية أيضاً، كما أشرنا إليه تحت الرقم (465) وهو الذي التزم به صدر المتألّهين ونسبه إلى صريح كلماتهم، خلافاً لشيخ الإشراق حيث حمل كلامهم على مجرّد المناسبة والعلّية لا المماثلة النوعيّة.(3) وهذا هو مقتضى كلامه ههنا أيضاً حيث عبّر ب «الأنواع المجرّدة» دون «الأفراد المجرّدة من الأنواع». وقد أشرنا إلى أنّا لم نظفر بدلالة صريحة بل ظاهرة ممّا نقل عن أفلاطون على التفسير الذي قدّمه صدر المتألّهين للمُثل، ولعلّ تفسير شيخ الإشراق هو الأقرب.
وكيف كان، فلقائل أن يقول: يمكن أن يثبت بقاعدة إمكان الأشرف والأخسّ وجود عقول عرْضيّة متوسّطة بين العقل الفعّال ـ حسب ما يراه المشّاؤون ـ والعالَم
1. راجع: حكمة الإشراق: ص143؛ والأسفار: ج2، ص58.
2. راجع: نفس المصدر: ج7، ص247.
3. نفس المصدر: ج2، ص60.
المادّيّ، من غير أن تُعتبر أفراداً مجرّدةً للأنواع المادّية، سواء كانت هي التي سمّاها أفلاطون بالمُثل أو غيرها.
تقرير ذلك أنّ العقل يجوّز أن تكون هناك موجوداتٌ مجرّدة بحيث يكون كلّ واحد منها واجداً لكمالات نوع واحد من المادّيات بنحو أتمَّ ـ لا لكمالات جميع الأنواع المادّية كالعقل الفعّال المفروض ـ بحيث يصلح أن يكون علّة لما بحذائه من النوع المادّي، فبمقتضى تلك القاعدة يجب أن يكون هذا الأشرف موجوداً في مرتبة متقدّمة على النوع المادّي وعلّةً مباشرةً له.
وعلى هذا يمكن أن يكون نظام العالم العقليّ بهذا الشكل: يكون في المرتبة الأولى موجود بسيط واجد لجميع الكمالات الإمكانيّة، وهو العقل الأوّل، ويليه عدد من العقول في مرتبة واحدة، لكلّ منها قسم من الكمالات الموجودة في العقل الأوّل، وهكذا تتنزّل مرتبة العقول إلى أن توجَد عقول يكون كلّ واحد منها واجداً لكمالات نوع واحد من المركّبات والمواليد في هذا العالم كالإنسان وسائر أنواع الحيوان والنبات، ثمّ يصدر عن كلّ واحد منها عقول اُخرى يكون كلّ واحدٍ منها واجداً لنوع خاصّ من كمالات هذه الأنواع، وعلّةً لنوع بسيط من الأنواع المادّية كالعناصر مثلاً. وفي هذا النظام يكون كلّ عقلٍ واقعٍ في مرتبة عليا مهيمناً على العقول الجزئيّة الصادرة عنه وتكون للعقول المتكافئة أيضاً مراتب شتّى. ولعلّه أوفق بما ورد في لسان الشرع من طبقات الملائكة(علیهمالسلام)، كما أنّ منهم من هو في مرتبةٍ أدونَ من مراتب العقول، وهم الموكَّلون بعالم البرزخ والحوادث المادّية، كما ورد في الروايات الشريفة، والله العالم.
469 ـ قوله «تنبيه»
قد لاحظْنا أنّ أحسن ما يتمسّك به لإثبات العقول العرْضيّة هو قاعدة إمكان الأشرف،
ولم يبحث عنها في هذا الكتاب حتّى الآن، ولهذا فقد تصدّى لبيانها والاستدلال عليها. وأوّل من استعملها هو المعلّم الأوّل في كتاب السماء والعالم حيث نقل عنه أنّه قال: «يجب أن يعتقد في العلويّات ما هو أكرم» وتبعه فلوطين الإسكندرانيّ في «اُثولوجيا» ثمّ الشيخ الرئيس في مواضع من الشفاء والتعليقات، وقد اعتنى بشأنها شيخ الإشراق في التلويحات والمطارحات وحكمة الإشراق(1) وتبعه الشهرزوريّ في «الشجرة الإلهيّة» ثمّ أمعن السيّد الداماد(2) وصدر المتألّهين(3) في تحقيقها ودفع ما استشكل عليها.
470 ـ قوله «وقد قرّر الاستدلال...»
هذه الحجّة هي التي أقامها شيخ الإشراق وقرّرها قطب الدين الشيرازيّ في شرح حكمة الإشراق والسيّد الداماد في القبسات وصدر المتألّهين في الأسفار، حاصلها أنّه لو لم يوجد الأشرف قبل الأخسّ ـ بأن لا يوجَد العقل الأوّل قبل الثاني مثلاً ـ فإمّا أن يصدر معه أو بعده أو لا يصدر أصلاً. والأوّل يستلزم صدور الكثير عن الواحد، والثاني يستلزم علّيّة الأخسّ للأشرف، والثالث يستلزم حاجة الأشرف إلى علّةٍ أشرفَ من الواجب تعالى وهو محال، أو امتناع وجوده والمفروض أنّه ممكن.
وهذه الحجّة مبتنية على قاعدة امتناع صدور الكثير عن الواحد وقد مرّ الكلام فيها. ثمّ إنّ المحقّق الدوانيّ أورد إشكالاً عليها في شرح الهياكل، وقد وصفه السيّد الداماد بالشك المعضل، وصدر المتألّهين بالشكّ العويص، وتصدّياً لدفعه،(4) ولا نطيل ببيانه والمناقشة فيه، كما أنّ السيّد أقام برهانين آخرين عليها.(5)
1. راجع: التلويحات: ص3142؛ والمطارحات: ص434435؛ وحكمة الإشراق، ص154.
2. راجع: القبسات: ص372ـ380.
3. راجع: الأسفار: ج7، ص244ـ257.
4. راجع: القبسات: ص374ـ377؛ والأسفار: ج7، ص249ـ253.
5. راجع: القبسات: ص377ـ378.
471 ـ قوله «ويمكن الاستدلال....»
حاصل هذا الدليل أنّ العلّية علاقة ذاتيّة بين الوجود الرابط والوجود الذي هو مستقلّ بالنسبة اليه، ويرجع ذلك إلى التشكيك الخاصّي في مراتب الوجود، فلو وُجد الأخسّ ولمّا يوجد الأشرف بعدُ كان وجوده بلا علّة مباشرة، ويعني ذلك استقلاله عنها.
ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الأخسّ في الفرض المذكور لا يصير مستقّلاً مطلقاً، فإنّه رابط بالنسبة إلى الواجب تعالى، ولزوم الواسطة بينهما ممنوع.
لكن يمكن الدفاع عنه بأنّ علاقة العلّية بين شيئين إمّا واجبة وإمّا ممتنعة ولا ثالث لهما، لأنّ فرض إمكانها الخاصّ ينافي ذاتيّتها، فإمكانها مساوق لوجوبها، فلو أمكن علّية شيء للأخسّ المفروض كان ذلك واجباً. وقد مرّ نظير الكلام في خامس الاُمور التي ذكرناها تحت الرقم (231). وبهذا البيان يثبت تسلسل مراتب الوجود وامتناع الطفرة بينها.
وبالنظر إلى ذلك يبدو إشكال، هو أنّ مراتب الوجود تُشكّل سلسلةً ممتدّةً تتمثّل في الذهن كخطّ مستقيم، فكلّما أخذنا مرتبتين منها أمكن فرض مرتبة متوسّطة بينهما وهكذا إلى غير النهاية، فيلزم أن تكون مراتب الوجود غير متناهيّة وهي محصورة بين حاصرين: مرتبة وجود الواجب وأيّ مرتبة أخذناها بعين الاعتبار إلى أدنى مراتب الوجود.
قال صدر المتألّهين: «وهذا الإشكال ممّا عرضته على كثير من فضلاء العصر، وما قدر أحد على حلّه»(1) ثمّ ذكر في دفعه ما استفاده من التأمّل في حقيقة النفس ومراتبها ودرجاتها، حاصله أنّ تلك المراتب غير منفصلة بعضها عن بعض، إلاّ في مقاطع محدّدة تتعيّن بظهور آثار خاصّة. وبعبارة اُخرى: هي كالأجزاء المفروضة لامتداد واحد، حيث لا تستلزم اجتماع اُمور غير متناهية بالفعل بين حدّين.
1. راجع: الأسفار: ج7، ص255.
وجدير بالذكر أنّه أسّس قاعدة اُخرى سمّاها «إمكان الأخسّ» وأثبت بها الحياة المثاليّة والإدراكات الخياليّة في عالم البرزخ والصور الجوهريّة في عالم المادّة.(1)
الفصل الحادي والعشرون
472 ـ قوله «ويسمَّى أيضاً البرزخ»
وهو نظير اصطلاح المتشرّعة حيث يسمّون العالم المتوسّط بين الدنيا والآخرة برزخاً، وكأنّه مأخوذ من قوله تعالى: «وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»(2) بل يمكن أن يقال إنّه هو بعينه، وإنّما الفرق بينهما من حيث قوس النزول والصعود. وهذا العالم هو الذي يسمّيه شيخ الإشراق «عالم الأشباح المجرّدة» و«المُثُل المعلّقة» وهو غير عالم البرازخ ـ حسب اصطلاحه ـ فإنّ المراد به هو عالم الأجسام المادّية، كما مرّ تحت الرقم (460).
والمعوّل في إثبات هذا العالم على المكاشفات التي يؤيّدها بعض الأدلّة النقليّة. ولو ثبت إمكان علّية الصور المثاليّة للاُمور المادّية ـ كما هو رأي سيّدنا الاُستاذ ـ لَجَرَت فيها قاعدة إمكان الأشرف أيضاً، لكن إثبات ذلك مشكل كما أشرنا إليه تحت الرقم (461) ولعلّه لهذا لم يستدلّ بها شيخ الإشراق وصدر المتألّهين لإثبات هذا العالم.
ولقائل أن يقول: يمكن إجراء القاعدة في الصور المعلّقة من جهة أنّها أشرف من صورنا الذهنيّة الخياليّة، حيث إنّها أعراض قائمة بالنفس وهي جواهر قائمة بذواتها، لكن غاية ما يثبت بها علّيتها للصور الإدراكيّة الجزئيّة لا لجميع ما في هذا العالم من الجواهر والأعراض، كما يمكن أن يستدلّ بقاعدة إمكان الاخسّ، فليتأمّل.
1. نفس المصدر: ص257ـ258.
2. سورة المؤمنون، الآية 100.
473 ـ قوله «وفيه أمثلة الصور...»
قد مضى في الفصل السابق أنّ مراتب العقول تتنزّل إلى عقل تُوجَد فيه جهات من الكثرة تتكافأ مع ما في العالم الذي يليه من الكثرة، وهو عالم المثال. فجهات الكثرة وإن لم تكن متمايزة في وجود العقل إلاّ أنّه يوجَد بحذاء كلّ منها جوهر مثاليّ هو ظلّ ومعلول لتلك الجهة. ثمّ إنّ هذه الجواهر المثاليّة تتمثّل بعضها لبعض على هيئات مختلفة تتحقّق بها جهات اُخرى من الكثرة بحيث تصلح لصدور كثرات متكاثرة عنها في العالم المادّي. وتلك الجهات المتعدّدة في الجواهر المثاليّة لا تنافي وحدة الجوهر في كلّ واحد منها. وقد مثّل لذلك مثالاً للتقريب إلى الأذهان، وهو أن يتصوّر عدّةٌ من الأفراد شخصاً واحداً في ذهنه بأن يتمثّل ذلك الشخص في كلّ ذهن على هيئة خاصّة غير ما في ذهن الآخر من الهيئة. فالهيئات مختلفة والشخص واحد، فتأمّل.
ثمّ انتقل إلى ما ذكره صدر المتألّهين من تقسيم المثال إلى مثالٍ أصغرَ هو مرتبة من مراتب النفس، ومثالٍ أعظمَ هو ذلك العالم المستقلّ عن الأذهان، وأشار إلى ما استدلّ به للمثال الأصغر من تحقّق صور قبيحة وجزافيّة لا يصحّ استنادها إلى ذلك العالم، وقد مرّت الإشارة إليه تحت الرقم (355).
الفصل الثاني والعشرون
474 ـ قوله «وقد تبيّن في الأبحاث السابقة...»
الذي تبيّن لنا من الأبحاث السابقة هو الوحدة الاتّصاليّة بين الجواهر المادّية ووحدة النظام الجاري في هذا العالم. وأمّا كون العالم المادّيّ برمّته شخصاً واحداً ذا حركة واحدة شخصيّة فقد مرّ الكلام فيه تحت الرقم (295 و 313 و 317).
475 ـ قوله «والغاية التي تنتهي إليها...»
كون المجرّد غاية للمادّي يتصوّر على وجوه: أحدها أن يكون المجرّد غايةً بالذات لحركة المادّي، وثانيها أن يكون غايةً لها بالعرض، وثالثها أن يكون علّةً غائيّةً لها. أمّا غاية الحركة بالذات فقد مرّ تحت الرقم (303) أنّها هي الطَرف العدميّ الذي تنتهي إليه الحركة المتناهية كالنقطة من الخطّ، وأمّا العلّة الغائيّة فقد مرّ تحت الرقم (258ـ262) أنّها تختصّ بذوي الشعور، فيبقى أن يكون المجرّد غايةً بالعرض للحركات الطبيعيّة، وعلّةً غائيّةً لبعض الحركات الإراديّة، فافهم.
476 ـ قوله «وإذ كان هذا العالم...»
وههنا يشير إلى مسألة ربط الحادث بالقديم والمتغيّر بالثابت، التي كانت تُبيَّن على أساس حركات الأفلاك مع ثبات ذواتها، والتي وَجدتْ حلّاً وافياً على ضوء الحركة الجوهريّة التي أثبتها صدر المتألّهين، حيث تبيّن أنّ وجود الجوهر الجسمانيّ هو عين التغيّر والحركة والسيلان، فإفاضة هذا الوجود يعني إيجاد الحركة لا إيجاد شيء وجَعْله متحرّكاً جعلاً تركيبيّاً، ولا يلزم أن يكون الموجِد متغيّراً ومتحرّكاً، لأنّ الموجِد هو الفاعل الإلهيّ لا الفاعل الطبيعيّ، وبعبارة اُخرى: تتنزّل مراتب الوجود إلى أضعف مراتبها التي ليس لها وجود جمعيٌّ، وإنّما تحصل شيئاً فشيئاً بحيث ينتزع عنه الزمان والحركة، ولا يقتضي ذلك سريان الزمان والحركة إلى الفاعل. فالنسبة الإيجاديّة لا تقع في ظرف الزمان، ولا تكون مسبوقة بعدم زمانيّ، بل المنتسب وطرف الإضافة هو عين التجدّد والتغيّر والسيلان، وينتزع مفهوم الحركة والزمان من نحو وجوده.(1)
1. راجع: الأسفار: ج3، ص133ـ141.
الفصل الثالث والعشرون
477 ـ قوله «في حدوث العالم»
قد تحصّل من الأبحاث الماضية في المرحلة العاشرة أنّ الحدوث على أربعة أقسام: الحدوث الذاتيّ لكلّ ذي مهيّة، والحدوث الفقريّ لكلّ وجود امكانيّ، والحدوث الدهريّ لكلّ ما ينسب إلى وعاء الدهر، والحدوث الزمانيّ الذي لا يتّصف به إلاّ الزمانيّات. ثمّ إنّه لا ريب في الحدوث الذاتيّ لجميع ما سوى الله تعالى، ومثله الحدوث الفقريّ أو الحدوث بالحقّ على القول بأصالة الوجود، وكذا الحدوث الدهريّ على ما قال به السيّد الداماد.
وأمّا الحدوث الزمانيّ فهو معركة الآراء بين الفلاسفة والمتكلّمين: فالمشهور بين المتكلّمين أنّ القِدم بجميع معانيه خاصّ بالواجب تعالى، وأنّ ما سواه حادث ذاتاً وزماناً. وقد أنكروا وجود المجرّد التامّ المتعالي عن وعاء الزمان والمكان في المخلوقات، وذهبوا إلى أنّ العالم (= العالم الجسمانيّ) حادث زماناً بمعنى أنّه مسبوق بعدم زمانيّ، وقد مرّ الكلام فيه في الفصل السادس من المرحلة الرابعة والفصل الثالث من المرحلة الثامنة، وأشار إليه أيضاً في خاتمة المرحلة التاسعة، وسيتعرّض له في آخر هذا الفصل.
وأمّا الفلاسفة فهم قائلون بوجود المجرّدات المتعالية عن الزمان والمكان، وواضح أنّه لا معنى لاتّصافها بالحدوث الزمانيّ. وأمّا اتّصافها بالقدم الزمانيّ فيصحّ بمعنى سلبيّ أي سلب الحدوث الزمانيّ والزمان عنها لا بمعنى وجود زمان أزليّ لها. وأمّا عالم الأجسام فالمشهور بينهم أنّ الأفلاك مع نفوسها قديمة زماناً بمعنى ثبوت زمان أزليّ لها حاصلٍ بحركتها الأزليّة، وكذا جرم عالم العناصر بمادّته وصورته الجسميّة، وإنّما يتّصف بالحدوث الزمانيّ أشخاص الجواهر النوعيّة وأعراضها.
وأمّا صدر المتألّهين فقد أثبت بفضل الحركة الجوهريّة أن لا شيء ثابتاً في عالم الأجسام، فالأجرام الفلكيّة أيضاً ليس لها وجود ثابت، بل وجودها نفس الحدوث والتّجدد.(1) لكن لا يعني ذلك انتهاء وجودها من جهة البدء إلى مبدء آنيّ، كما أنّ سلسلة الحوادث كذلك.
ثمّ إنّ السيّد الداماد بذل غاية مجهوده لإثبات الحدوث الدهريّ الانفكاكيّ لجملة ما سوى الله تعالى ثمّ نهض بإثبات تناهي الزمان ومقدار الحركة وعدد الحوادث، وأجرى فيها براهين التسلسل لاجتماعها جميعاً في وعاء الدهر.(2) وهذه المسألة تشكّل المحور الرئيسيّ لأبحاثه في كتاب القبسات، وقد صرّح في مقدّمته أنّ إثبات حدوث العالم هو الغرض من تدوينه.
وأمّا الاُستاذ(قدسسره) فقد حاول إثبات الحدوث الزمانيّ لعالم الأجسام من طريق آخر، وهو أنّ هذا العالم ـ كما مرّ في الفصل السابق وفي المرحلة التاسعة ـ حركةٌ جوهريّة ممتدّة، ولا ريب أنّ كلّ قطعة منها حادثةٌ حدوثاً زمانيّاً، فالمجموع أيضاً كذلك، لأنّه ليس شيئاً وراء الأجزاء والقطعات. وذلك كما أن مجموع المجرّدات ليس شيئاً وراء أشخاصها، وبثبوت الحدوث الذاتيّ أو الفقريّ أو الدهريّ لكلّ واحد منها يثبت ذلك للمجموع.
ويلاحظ عليه ـ مضافاً إلى ما مرّ من الإشكال في وحدة الحركة ـ أنّ حدوث كلّ جزء من الحركة لا يكفي دليلاً على حدوث الكلّ كواحد ممتدّ، لأنّ كل جزء منها إنّما يتّصف بالحدوث الزماني لسبق عدم زمانيّ عليه ينتزع منجزءآخر منها، لكن لا يجري ذلك في الكلّ لعدم شيء سابق عليه سبقاً زمانيّاً. ولا يقاس هذا بالحدوث الذاتّي أو الفقريّ أو الدهرىّ، لأنّ ملاك تلك الأنواع من الحدوث موجود في المجموع.
1. نفس المصدر: ج5، ص194ـ248؛ وج7: ص282ـ331.
2. راجع: القبسات: ص226ـ228.
والحاصل أنّ إسراء حكم الأجزاء أو الأفراد إلى المجموع إنّما يصحّ في ما إذا لم تتصوّر للمجموع خاصّةٌ لا توجد في الأجزاء والأفراد كما في حدوث الكلّ حدوثاً ذاتيّاً أو فقريّاً أو دهريّاً، بخلاف الحدوث الزمانيّ في الحوادث المتسلسلة، لصحّة اتّصاف كلّ واحدة منها بالمسبوقيّة بعدم زمانيّ، بخلاف المجموع. على أنّ اتّصاف الجزء الأوّل أو الحادثة الاُولى بذلك أيضاً ممنوع، فلا يصدق أنّ كلّ واحدة من قطعات الحركة مسبوقة بعدم زمانيّ. إلاّ أن يفسّر الحادث الزمانيّ بما له مبدء آنيٌ. ومع ذلك فتمكن المناقشة فيه أيضاً بمنع وجود المبدء الآنيّ لكلّ ما مضى، فلو فُرضت الحركة الجوهريّة غير متناهية زماناً من حيث البدء والختم لم يصحّ الاستدلال على إبطاله بوجود مبدء آنيّ لها من طريق وجود المبدء الآنيّ لكلّ قطعة من قطعاتها. على أنّه بناءاً على وحدة الحركة لا وجود للقطعات بالفعل حتّى يثبت لها حكم ويُسرى إلى الكلّ، فافهم.
فلو جرتْ براهين التسلسل في الحوادث المتسلسلة ـ كما هو رأي السيّد الداماد ـ ثبت المبدء الآنيّ للعالم الجسمانيّ من حيث البدء والختم، لكن في جريانها نظر كما نبّهنا عليه تحت الرقم (244) فتبقى المسألة مشكوكاً فيها من وجهة النظر الفلسفيّة، وإن شيءت فَسَمِّها «جدليّة الطرفين» كما حكي عن المعلّم الأوّل والشيخ الرئيس، وإن كان كلامهما ناظراً إلي جهة اُخرى، كما نبّه عليها في القبسات.(1) والله العالم.
الفصل الرابع والعشرون
478 ـ قوله «في دوام الفيض»
إنّ ممّا تُمُسّك به لإثبات قِدم العالم ونفي المبدء الزمانيّ عنه هو إطلاق فاعليّته
1. نفس المصدر: ص2 و 25ـ36.
تعالى وسرمديّة فيضه ودوام جوده. قال صدر المتألّهين حكاية عنهم: «إنّ الواجب الوجود واحد من جميع الوجوه، غير متغيّر ولا متبدّل، وإنّه متشابه الأحوال والأفعال، فإن لم يوجد عنه شيء أصلاً بل كانت الأحوال كلّها على ما كانت عليه وجب استمرار العدم كما كان، وإن تجدّد حال من الأحوال المذكورة موجبةٌ لوجود العالم فهو محال، لأنّه ليس في العدم الصريح حال يكون الأولى فيه أن يكون العالم موجوداً، أو بالبارئ أن يكون موجِداً، أو يكون فيه حال آخرُ تقتضي وجوبه، لتشابه الحال».
ثمّ قال: «وهذه المقدّمات كلّها صادقة حقّة اضطراريّة، لكن مع ذلك لا يلزم منها قِدم العالم، فإنّك قد علمت أنّ المهيّة المتجدّدة الوجود ثباتها عين التجدّد...».(1)
وقال في موضوع آخر: «فالفيض من عند الله باقٍ دائمٌ، والعالم متبدّل زائل في كلّ حين، وانّما بقاؤه بتوارد الأمثال، كبقاء الأنفاس في مدّة حياة كلّ واحد من الناس، والخلق في لبس وذهول عن تشابه الأمثال، وبقائها على وجه الاتّصال».(2)
والحاصل أنّه سلّم أنّ مقتضى وجوب الوجود من جميع الجهات ودوام فيضه سبحانه عدمُ تناهي سلسلة الحوادث من حيث البدء، لكنّ الاُستاذ(قدسسره) منعَ إمكان القابل، واستند إلى الحجّة التي أقامها على حدوث العالم زماناً في الفصل السابق. فكما أنّ أبعاد العالَم المكانيّةَ متناهيّةٌ عندهم، وتناهيها لا ينافي سعة جوده سبحانه، كذلك تناهي بُعده الزمانيّ هو مقتضى البرهان، ولا ينافي دوام فيضه سبحانه.(3) أمّا العوالم التي فوق عالم الطبيعة فلا سبيل لهذه المحدوديّات إليها، وإنّما محدوديّتها هي من حيث شدّة الوجود، وهي مقتضى إمكانها الذاتيّ وفقرها الوجوديّ، فمهما
1. راجع: الأسفار: ج7، ص299ـ300.
2. نفس المصدر: ص328.
3. راجع: القبسات: ص32.
بلغ كمال وجودها من الشرف والكرامة والقوّة والشدّة كانت رابطة محضة لا استقلال لها دون الواجب تعالى، ولا يمكن فرض واسطة بين المرتبة الوجوبيّة الغنيّة ومراتبها الإمكانيّة الفقيرة، فهو تعالى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. وأمّا محدودية عالم الأجسام من حيث الزمان أو من حيث المكان فإنّما هي من قِبل ذاته، لقيام الحجّة على استحالة لا تناهيه، وليست من إمساك الواجب تعالى عن توسعتها والإفاضة عليها.
لكن قد عرفت قصور البراهين عن إثبات تناهي الأبعاد وتناهي الزمان، فنذر المسألتين في بقعة الإمكان، حتّى يذودنا عنهما قائم البرهان، والله المستعان.
479 ـ قوله «ولا تكرُّر في وجود العالم»
حُكي عن بعض فلاسفة يونان وغيرهم القول بأنّ حوادث العالم تتكّرر بعد حقب من القرون، وذلك بحصول وضع للأفلاك مشابه لما كانت عليه في الدورة السابقة، وهكذا تتكّرر الأدوار. وردّ عليه بأنّه لا دليل عليه. لكن من المعلوم أنّ عدم الدليل لا يكفي دليلاً على العدم.
480 ـ قوله «وما قيل...»
هذا في الواقع إجابة لمطالبة الدليل، وحاصله أنّ العلّة الفاعليّة لوجود الحوادث هو العقل المفارق الدائم، ومقتضى دوام وجوده دوام أنواع معلولاته، وأمّا اشخاصها فهي منوطة بحصول شروط ومعدّات من الأوضاع الفلكيّة المتغيّرة، وبتكرّر تلك الأوضاع تتمّ العلّة لوجود أمثالها.
وحاصل الجواب هو منع انحصار الشروط والمعدّات في الأوضاع المفروضة، ومنع تكرّر الأوضاع بعينها. مضافاً إلى بطلان فرضيّة الأفلاك، التي اعتبرتْ كأصل موضوع.
* * *
هذا آخر ما قدّر الله تعالى كتابته بأناملي الخاطئة حول كتاب نهاية الحكمة. فإن اهتديتُ فبما هداني ربّي، وإن ضللتُ فإنّما هو من قصوري وجهلي.
والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين، لا سيّما الحجّة ابن الحسن العكسريّ،(عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، وجعلنا من أعوانه وأنصاره.
اللّهمّ إنّ هذا هديّتي إلى سيّدي واُستاذي السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ، صلواتك ورحمتك وبركاتك ورضوانك عليه. فتقبّل منّي بأحسن قبول، وزد فيها ما ينبغي لكرمك وجودك، إنّك جواد كريم وذو فضل عظيم.
إلهي منك ما يليق بكرمك، ومنّي ما يليق بلؤمي، فعاملْني بفضلك، وشفّعْ فيّ أولياءك الذين جعلتَهم ذخراً لعبادك العاصين.
«فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ».
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org